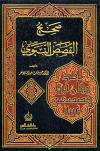والله لن تَنْعَم بحياة، ولن تذوق طعم السعادة، وأنت لا تُصَلّـي، وَ أنت بعيد عن خالق السعادة،
رتّب صلاتك، ليُرتّب الله حياتك.
مساعدة
الأحدث إضافة
الإبلاغ عن المادة
تعديل تدوينة
لو جلست تتذكر إساءة الناس لك ، فلن تصفو مودتك حتى لأقرب الناس إليك ! ولن ترتاح في أيامك ...
لو جلست تتذكر إساءة الناس لك ، فلن تصفو مودتك حتى لأقرب الناس إليك !
ولن ترتاح في أيامك ولياليك،،،،،
فغُضَّ الطرف ، وتغافل عن الزلّات ، واعتمد النسيان ، كي تسعد مع من هم حولك.
مهما بلغ تقصيرك في العبادة ...
فلا تفرّط في حُسن الخُلُق … فقد يكون مفتاحك لدخول أعالي الجنة
قال ﷺ : ( إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ).. ...المزيد
ولن ترتاح في أيامك ولياليك،،،،،
فغُضَّ الطرف ، وتغافل عن الزلّات ، واعتمد النسيان ، كي تسعد مع من هم حولك.
مهما بلغ تقصيرك في العبادة ...
فلا تفرّط في حُسن الخُلُق … فقد يكون مفتاحك لدخول أعالي الجنة
قال ﷺ : ( إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ).. ...المزيد
خطبة الجمعه بعنوان أبشروا يا أهل صلاة الفجر ...
خطبة الجمعه بعنوان
أبشروا يا أهل صلاة الفجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعداد وأداء
القائد، المجاهد
محمد المحرابي
الجمعه 24/ ذي الحجه/1446
الحمد لله رب العالمين.. لا يسأم من كثرة السؤال والطلب...
سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب.. وإذا لم يُسأَل غضب...
يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب.. ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب...
من رضي بالقليل أعطاه الكثير.. ومن سخط فالحرمان قد وجب...
رزق الأمان لمن لقضائه استكان.. ومن لم يستكن انزعج واضطرب...
من ركن إلى غيره ذلَّ وهان.. ومن اعتز به ظهر وغلب...
نحمَده تبارك وتعالى على كل ما منح أو سلب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العناء والنصَب...
ونسأله الخلود في دار السلام حيث لا لغو ولا صخب...
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وإليه المنقلب...
هو المالك.. وهو الملك.. يحكم ما يريد فلا تعقيب ولا عجب...
قبض قبضتين.. فقبضة الجنة لرحمته.. وقبضة النار للغضب...
احتجب عن الخلق بنوره.. وخفي عليهم بشدة ظهوره.. أفلح من التزم الأدب...
نخاف الله ونخشاه.. ونرجوه ونطلب رضاه.. والعفو منه مرتقب...
نحب الصلاح ونتمناه.. ونكره الفساد ونتحاشاه.. فهل ذاك يكفي لبلوغ الأرب...
تساؤل في نفوسنا تساءلناه.. وبأمل في قلوبنا رجوناه.. تبارك الذي إذا شاء وهب...
وأشهد أن خاتم المرسلين هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب...
نطق بأفصح الكلام.. وجاء بأعدل الأحكام.. وما قرأ ولا كتب...
آية الآيات.. ومعجزة المعجزات.. لمن سلم عقله من العطب...
تأمل في حياته وانظر.. وتمعن بقلبك وتدبر.. وهاك بعض النسب...
الأب يموت ولا يراه.. والأم تسلمه لغريبة ترعاه.. فلا حنان ولا لعب...
عم كفله ورباه.. وعم هو أسد الله.. وعم يَصلى نارًا ذات لهب...
تمنى الإسلام لمن رعاه.. وأراد الهدى لمن عاداه.. فما أجيب لما تمنى وطلب...
زوجة حنون تكبره بأعوام.. يعيش معها في وئام وسلام.. وفجأة تغير الحال وانقلب...
رسالة لم تتحملها الجبال، وعشيرة يرى منها الأهوال.. وتتركه الوليفة إلى بيت في الجنة من قصب...
جاءه منها البنات والبنون.. فاختطفتهم منه يد المنون.. فلا وريث ولا شقيق ولا عصب...
هموم وآلام.. ونفاق من اللئام.. وليل لا ينام.. ونهار للجهاد قد اصطحب...
لم ينعم بلذيذ الحياة.. ولم ينل فيها ما تمناه.. والموت منه قد اقترب...
وُوري في التراب وجهه الأنور، وغُطِّي بالأكفان جبينه الأزهر، بعد شديد مرض وتعب...
لم يورث منه مال.. بل علم تناقلته الأجيال.. ونور في الآفاق قد ضرب...
أضاء للمؤمنين طريقهم.. أحبهم وحبَّب إليهم ربهم.. فتنوع العطاء والحب السبب...
إمام الغر المحجلين.. وخاتم الأنبياء والمرسلين.. وجهك بدر وصوتك طرب.
سيدي وحبيبي.. قدوتي وشفيعي.. الشوق مشتعل والدمع للخدِّ خضب..
فهل تنعم برؤية وجهك عيناي؟ فالعمر ولى والزمان قد اغترب...
فيا رب يا أكرم مسؤول.. ويا خير مُرتجى ومأمول.. صلِّ على سيد الأعاجم والعرب...
على الصحب ومن تبع وكل من إليه انتسب...
ما لاح في الأفق نجم أو غرب...
أو ظهر في السماء هلال أو احتجب...
وكلما انحنى لك في الصلاة ظهر أو انتصب...
صلى عليك الله
صلو على خير خلق الله
• •.......
امابعد_____________
ايها المؤمنون
اوصيكم اولا ونفسي بتقوى الله
(( ياايها الذين اتقو الله وقولو قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ))
اخواني في الله:—
ارجو ان تعيروني اسماعكم وانتباهكم فالكلام مهم والموضوع يعالج مانعانيه نحن اليوم بصراحه إنها لمكاسب عظيمه لا تحتاج إلى عناء اوتعب لا تحتاج الى رأس مال
لاتحتاج الى وقت كثير إنها
لكنها تحتاج إخلاص ورقابه وقلوب صادقه مع الله
موضوع خطبة اليوم
من مادتين
الاولى
♕أبشروا يااهل صلاة الفجر ♕
==================
والثانيه
♕لماذا ميز الله الجمعه بالمواعظ والخطب ♕
فلنبدأ بالمادة الاولى
أما بعـد: في حوالي الساعة الرابعه فجرًا، من كل يوم
في هذا الوقت البديع المبارك، يدوِّي في سماء الكون النداء الخالد؛ نداء الأذان لصلاة الفجر، فتهتف الأرض كلها: الله أكبر، الله أكبر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وتكون صلاة الفجر فاتحة اليوم في حياة المسلم، وكأنما هي شكرٌ لله على نعمة الإصباح بعد الإظلام، ونعمة الحياة بعد الممات؛ فالنوم هو الموتة الصغرى.
أيها المؤمنون،فلتعدو معي هذه المكاسب من الوقوف لله في كل يوم وقت لايتجاوز خمس دقائق لصلاة الفجر في جماعه ستنهال بعدها عليك الفضائل والأجور والدرجات إذا حافظ عليها في المساجد حيث يُنادَى بها كل يوم.
أيها المؤمنون،
أهل صلاة الفجر فئة مباركة وُفِّقت للخير، لَبَّوا أمر ربهم مستشعرين الأجور والفضائل، خائفين وَجِلين، إنهم الرجال حقًّا الذين قال الله عنهم: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 36 - 38]، فيا أهل صلاة الفجر،
1- أبشروا بالأجور العظام، والحسنات والخيرات، فربكم كريم رحيم عظيم الفضل والثناء.
2-أبشروا يا أهل صلاة الفجر بشهود ملائكة الرحمن؛ فلقد قال سبحانه: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]؛ قال ابن كثير رحمه الله: "يعني: صلاة الفجر". وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرُجُ الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلُّون وأتيناهم وهم يصلُّون»، فيا من صليت الفجر في جماعة، هنيئًا لك؛ فسيُرفع اسمك مع أولئك النفر، وستشهد لك الملائكة؛ فأبشر بكل خير.
3- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بأجر قيام الليل كله؛ فلقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلَّى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله»، الله أكبر، تصلي الفجر في دقائق معدودات، ثم يُكتَب لك أجر قيام الليل، وأنت كنت نائمًا على فراشك، إنه فضل عظيم من رب كريم، فأين المشمرون؟
4- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بـأجر عظيم لا يعلمه إلا الله؛ فقد أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( «(ولو يعلمون ما في العَتَمَة - [أي: العشاء] - والصبح لأتَوهما ولو حبوًا»؛ أي: ولو يعلم الناس ما في هاتين الصلاتين من عظيم الأجر، ثم لم يستطيعوا أن يحضروا إليها على أقدامهم بسبب عذر ما، لأتَوا وهم يحبون كما يحبو الصغير؛ حتى لا يفوتهم الأجر؛ لذلك كان ابن مسعود يقول: "ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادَى بين الرَّجُلَيْنِ حتى يُقام في الصف"؛ أي: من شدة المرض لا يستطيع أن يقف في الصف بمفرده، فيستند على الرجلين، ومع ذلك لا يترك الجماعة؛ لأنه يعلم عظم الأجر
ولتعد معي بشائر الحفاظ على صلاة الفجر
5- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بالنور التام يوم القيامة؛ قال رسول الله: «بشِّر المشَّائين في الظُّلَمِ إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»؛ (رواه ابن ماجه بسند حسن).
6- أبشروا يا أهل صلاة الفجر، فأنتم في ذمة الله وحفظه؛ فقد قال النبي قال: «من صلى الصبح في جماعة، فهو في ذمة الله تعالى»؛ أي: في حفظه ورعايته؛ (رواه ابن ماجه بسند صحيح)، فاذهب إلى أي مكان شئتَ يا من صليت الفجر في جماعة ولا تخَفْ؛ فأنت في حفظ الله
لا ملك من ملوك الدنيا، كلا والله، بل في حفظ ملك الملوك جل وعلا.
7- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بأعظم نعيم في الجنان وهو رؤية الرحمن؛ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما إنكم سترَون ربكم كما ترون القمر لا تضامُّون في رؤيته - أي: لا يصيبكم الضيم وهو المشقة والتعب - فإن استطعتم ألَّا تُغلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا - يعني: صلاة العصر والفجر - ثم قرأ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130].
8- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بالوعد من الله بدخول الجنان وبالنجاة من النار؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى البَرْدَيْنِ، دخل الجنة»؛ (رواه البخاري ومسلم)، والبردان هما: الصبح والعصر، وقال صلى الله عليه وسلم: «لن يَلِجَ النار أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»؛ يعني: الفجر والعصر؛ (رواه مسلم).
9- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بنشاط أبدانكم وطِيب نفوسكم؛ فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يعقِد الشيطان علي قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليلٌ طويلٌ فارْقُدْ، فإن استيقظ فذكر الله انحلَّت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة؛ فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 10-أبشروا يا أهل صلاة الفجر بصلاةٍ سُنَّتُها خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ فلقد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، والمقصود ليست الفريضة بل السنة القبلية، فسنة الفجر خير من الدنيا وما فيها من قصور وأموال ودور وملذات، فإذا كان هذا الفضل للسنة، فكيف بالفريضة نفسها، لا شك أنها أعظم أجرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
وبعد ما سمعتَ يا عبدالله عن هذه الفضائل العظام، التي واحدة منها والله لكافية لأن تستيقظ وتقوم لتصلي مع المسلمين، فهل ستتركها بعد ذلك؟ وهل ستحرم نفسك كل هذه الأجور؟ فيا أهل صلاة الفجر، اثبتوا على ما أنتم عليه، واحتسبوا الأجر عند ربكم، وجاهدوا وثابروا حتى تصِلوا الجنة بإذن الله. أيها المؤمنون، إن أردتم سعادة في القلب وانشراحًا في الصدر، فعليكم بصلاة الفجر.
احباب المصطفى بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بمافيه من الايات والذكر الحكيم قلت ماسمعتم واستغفروا الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فااستغفروه فيا فوز المستغفرين _________________________
خطبة الجمعه
الخطبة الثانيه بعنوان
لماذا ميز الله صلاة الجمعه بالخطب والمواعظ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمدلله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده خير من خلق وبخير الكلام نطق وعلى هديه جميع الكائنات تتفق
صلوات ربي وسلامه عليك ياحبيبي يارسول الله
وبعد اخواني المؤمنين المرابطين هناك ظاهرة صغيره طالما سمعت تكراراها من كثير من الناس ليس هنا فقط بل في كل مكان واحببت ان اذكرها لكم في هذا المقام......
لعلنا نعمل على تغير انفسنا ونأخذ من الكلام ماينفعنا فربما كلمة تسمعها قد تغير حياتك وفقني الله واياكم الى كل خير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد البحث الطويل في قول أُناسٍ بعد انتهاء الخطيب من خطبته،
او المحاضر من محاضرته او المحدث من حديثه تسمع كثيرمن الناس يقولون؟!
لم نستفد ولم نفهم شيئًا من الخطبة، فقد درست هذا الأمر جيدًا، ولم أرَ العيب في الخطيب دائمًا
بل في كثير من الأحيان يكون العيب في المستمع الذي لم يفهم ولم يستفد من الخطبة شيئًا، حتى لو معلومة واحدة أو آية أو حديثًا، إني أعي ما أقول جيدًا، أين قلبك من خطبة الجمعة؟ فها هو صحابيٌّ جليل، اسمه ضماد، تأثر قلبه بخطبة الحاجة وهو كافر، فأسلم، (إن الحمد لله نحمده ونستعينه..) لها قصة، وفي القصة عِبرة وعِظة، يرويها الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ ضِمادًا رضي الله عنه جاء إلى مكة قبل إسلامه، وكان يُرقِي، فسمِع سفهاء مكة يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم: مجنون، فقال: لعلي رأيت هذا الرجل فيجعل الله شفاءه على يدي، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك في أن أرقيَك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فهو المهتدِ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد..»، فقال ضماد: أعِد عليَّ كلماتك، فعادهن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ثم قال: هاتِ يدك أبايعك على الإسلام فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وعلى قومك» ؟ قال: وعلى قومي))، إنها كلمات يسيرات وفي مجلس واحد تأثر ضماد رضي الله عنه، نقلته هذه المقدمة فقط من الكفر إلى التوحيد، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، بل أخرجته وأخرجت قومه معه، كلمات ترددت كثيرًا على منابرنا، وتكررت كثيرًا في الجمعة على مسامعنا، فأين أثرها في قلوبنا، وأثر ما بعدها من الموعظة علينا، من أثرها على ضماد رضي الله عنه؟
عباد الرحمن، لقد منَّ الله عليكم بيوم هو خير الأيام؛ قال عنه نبيكم صلى الله عليه وسلم: «هو خيرُ يوم طلعت عليه الشمس»، هو يوم الجمعة وزيَّنه لكم بأحكم الشرائع، ففرض عليكم فيه صلاة هي أفرض الصلوات؛ صلاة الجمعة، وقدمها لكم بخطبة؛ فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]؛ أي: إلى الخطبة والمواعظ لتخرجوا بعد الخطبة بقلوب غير التي دخلتم بها، وبحال أفضل من الحال الذي دخلتم به، مُتَّعِظين معتبرين، قلوبكم بالإيمان عامرة، وعن الذنوب والمعاصي تائبين. عباد الله، خطبة الجمعة للأسف هي الفرصة الوحيدة لكثير من المسلمين في سماع وتلقِّي العلم، حين فرطوا في دينهم، فما تفقَّهوا فيه، ويا أسفاه ويا حسرتاه حين تُقلب النظر في أبناء الجمعة، فلا ترى لها فيهم أثرًا للخطبة، ولا تلحظ لها عليهم خبرًا!
اخواني في الله ارجو الله ان نكون قد وفقنا فيما قلته أنا واستوعبته انت وان يعيينا على جهاد انفسنا وينصرنا على عدونا
هذا وصلو وسلمو على من امرنا جل وعلا بالصلاة عليه
حيث بدأها بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم ايها المؤمنون من إنسه وجنه
حيث قال عز من قائل
(( إن الله وملائكته يصلون على النبي ياايها الذين امنو صلو عليه وسلمو تسليما
اللهم فصلي وسلم على نبينا محمد نور شمس العرفان ومهبط اسرار القرآن المرشد العظيم والقائد الحكيم وخير داعٍ الى الصراط المستقيم
اللهم اجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه
اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعه ولوالديه وفتح للموعظه قلبه واذنيه
اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهديين
اللهم إنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنه والنجاة من النار
اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين
اللهم انصر من نصر الدين
واخذل من خذل المسلمين
اللهم انصر جنودك المرابطين
في فلسطين اللهم نصرك الذي وعدت ياكريم
اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين
اللهم انصرنا وانصر اخواننا المرابطين في جميع الثغور والجبهات والميادين يارب العالمين
اللهم لاتصرفنا من مقامنا هذا هذا الا بذنب مغفور وسعيا مشكور وتجارة لن تبور عزيز ياغفور
وفقكم الله حفظكم الله رعاكم الله نصركم الله أيدكم الله
عباد الله إن الله يأمركم بثلاث فأدوها وينهاكم عن ثلاث فانتهو عنها إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتا ذي القربى وينهى عن الفحشاءوالمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
فاذكرو الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ماتصنعون واقم الصلاة
================
#خطبة الجمعه
للقائد المجاهد# محمد المحرابي ...المزيد
أبشروا يا أهل صلاة الفجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعداد وأداء
القائد، المجاهد
محمد المحرابي
الجمعه 24/ ذي الحجه/1446
الحمد لله رب العالمين.. لا يسأم من كثرة السؤال والطلب...
سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب.. وإذا لم يُسأَل غضب...
يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب.. ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب...
من رضي بالقليل أعطاه الكثير.. ومن سخط فالحرمان قد وجب...
رزق الأمان لمن لقضائه استكان.. ومن لم يستكن انزعج واضطرب...
من ركن إلى غيره ذلَّ وهان.. ومن اعتز به ظهر وغلب...
نحمَده تبارك وتعالى على كل ما منح أو سلب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العناء والنصَب...
ونسأله الخلود في دار السلام حيث لا لغو ولا صخب...
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وإليه المنقلب...
هو المالك.. وهو الملك.. يحكم ما يريد فلا تعقيب ولا عجب...
قبض قبضتين.. فقبضة الجنة لرحمته.. وقبضة النار للغضب...
احتجب عن الخلق بنوره.. وخفي عليهم بشدة ظهوره.. أفلح من التزم الأدب...
نخاف الله ونخشاه.. ونرجوه ونطلب رضاه.. والعفو منه مرتقب...
نحب الصلاح ونتمناه.. ونكره الفساد ونتحاشاه.. فهل ذاك يكفي لبلوغ الأرب...
تساؤل في نفوسنا تساءلناه.. وبأمل في قلوبنا رجوناه.. تبارك الذي إذا شاء وهب...
وأشهد أن خاتم المرسلين هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب...
نطق بأفصح الكلام.. وجاء بأعدل الأحكام.. وما قرأ ولا كتب...
آية الآيات.. ومعجزة المعجزات.. لمن سلم عقله من العطب...
تأمل في حياته وانظر.. وتمعن بقلبك وتدبر.. وهاك بعض النسب...
الأب يموت ولا يراه.. والأم تسلمه لغريبة ترعاه.. فلا حنان ولا لعب...
عم كفله ورباه.. وعم هو أسد الله.. وعم يَصلى نارًا ذات لهب...
تمنى الإسلام لمن رعاه.. وأراد الهدى لمن عاداه.. فما أجيب لما تمنى وطلب...
زوجة حنون تكبره بأعوام.. يعيش معها في وئام وسلام.. وفجأة تغير الحال وانقلب...
رسالة لم تتحملها الجبال، وعشيرة يرى منها الأهوال.. وتتركه الوليفة إلى بيت في الجنة من قصب...
جاءه منها البنات والبنون.. فاختطفتهم منه يد المنون.. فلا وريث ولا شقيق ولا عصب...
هموم وآلام.. ونفاق من اللئام.. وليل لا ينام.. ونهار للجهاد قد اصطحب...
لم ينعم بلذيذ الحياة.. ولم ينل فيها ما تمناه.. والموت منه قد اقترب...
وُوري في التراب وجهه الأنور، وغُطِّي بالأكفان جبينه الأزهر، بعد شديد مرض وتعب...
لم يورث منه مال.. بل علم تناقلته الأجيال.. ونور في الآفاق قد ضرب...
أضاء للمؤمنين طريقهم.. أحبهم وحبَّب إليهم ربهم.. فتنوع العطاء والحب السبب...
إمام الغر المحجلين.. وخاتم الأنبياء والمرسلين.. وجهك بدر وصوتك طرب.
سيدي وحبيبي.. قدوتي وشفيعي.. الشوق مشتعل والدمع للخدِّ خضب..
فهل تنعم برؤية وجهك عيناي؟ فالعمر ولى والزمان قد اغترب...
فيا رب يا أكرم مسؤول.. ويا خير مُرتجى ومأمول.. صلِّ على سيد الأعاجم والعرب...
على الصحب ومن تبع وكل من إليه انتسب...
ما لاح في الأفق نجم أو غرب...
أو ظهر في السماء هلال أو احتجب...
وكلما انحنى لك في الصلاة ظهر أو انتصب...
صلى عليك الله
صلو على خير خلق الله
• •.......
امابعد_____________
ايها المؤمنون
اوصيكم اولا ونفسي بتقوى الله
(( ياايها الذين اتقو الله وقولو قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ))
اخواني في الله:—
ارجو ان تعيروني اسماعكم وانتباهكم فالكلام مهم والموضوع يعالج مانعانيه نحن اليوم بصراحه إنها لمكاسب عظيمه لا تحتاج إلى عناء اوتعب لا تحتاج الى رأس مال
لاتحتاج الى وقت كثير إنها
لكنها تحتاج إخلاص ورقابه وقلوب صادقه مع الله
موضوع خطبة اليوم
من مادتين
الاولى
♕أبشروا يااهل صلاة الفجر ♕
==================
والثانيه
♕لماذا ميز الله الجمعه بالمواعظ والخطب ♕
فلنبدأ بالمادة الاولى
أما بعـد: في حوالي الساعة الرابعه فجرًا، من كل يوم
في هذا الوقت البديع المبارك، يدوِّي في سماء الكون النداء الخالد؛ نداء الأذان لصلاة الفجر، فتهتف الأرض كلها: الله أكبر، الله أكبر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وتكون صلاة الفجر فاتحة اليوم في حياة المسلم، وكأنما هي شكرٌ لله على نعمة الإصباح بعد الإظلام، ونعمة الحياة بعد الممات؛ فالنوم هو الموتة الصغرى.
أيها المؤمنون،فلتعدو معي هذه المكاسب من الوقوف لله في كل يوم وقت لايتجاوز خمس دقائق لصلاة الفجر في جماعه ستنهال بعدها عليك الفضائل والأجور والدرجات إذا حافظ عليها في المساجد حيث يُنادَى بها كل يوم.
أيها المؤمنون،
أهل صلاة الفجر فئة مباركة وُفِّقت للخير، لَبَّوا أمر ربهم مستشعرين الأجور والفضائل، خائفين وَجِلين، إنهم الرجال حقًّا الذين قال الله عنهم: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 36 - 38]، فيا أهل صلاة الفجر،
1- أبشروا بالأجور العظام، والحسنات والخيرات، فربكم كريم رحيم عظيم الفضل والثناء.
2-أبشروا يا أهل صلاة الفجر بشهود ملائكة الرحمن؛ فلقد قال سبحانه: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]؛ قال ابن كثير رحمه الله: "يعني: صلاة الفجر". وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرُجُ الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلُّون وأتيناهم وهم يصلُّون»، فيا من صليت الفجر في جماعة، هنيئًا لك؛ فسيُرفع اسمك مع أولئك النفر، وستشهد لك الملائكة؛ فأبشر بكل خير.
3- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بأجر قيام الليل كله؛ فلقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلَّى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله»، الله أكبر، تصلي الفجر في دقائق معدودات، ثم يُكتَب لك أجر قيام الليل، وأنت كنت نائمًا على فراشك، إنه فضل عظيم من رب كريم، فأين المشمرون؟
4- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بـأجر عظيم لا يعلمه إلا الله؛ فقد أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( «(ولو يعلمون ما في العَتَمَة - [أي: العشاء] - والصبح لأتَوهما ولو حبوًا»؛ أي: ولو يعلم الناس ما في هاتين الصلاتين من عظيم الأجر، ثم لم يستطيعوا أن يحضروا إليها على أقدامهم بسبب عذر ما، لأتَوا وهم يحبون كما يحبو الصغير؛ حتى لا يفوتهم الأجر؛ لذلك كان ابن مسعود يقول: "ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادَى بين الرَّجُلَيْنِ حتى يُقام في الصف"؛ أي: من شدة المرض لا يستطيع أن يقف في الصف بمفرده، فيستند على الرجلين، ومع ذلك لا يترك الجماعة؛ لأنه يعلم عظم الأجر
ولتعد معي بشائر الحفاظ على صلاة الفجر
5- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بالنور التام يوم القيامة؛ قال رسول الله: «بشِّر المشَّائين في الظُّلَمِ إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»؛ (رواه ابن ماجه بسند حسن).
6- أبشروا يا أهل صلاة الفجر، فأنتم في ذمة الله وحفظه؛ فقد قال النبي قال: «من صلى الصبح في جماعة، فهو في ذمة الله تعالى»؛ أي: في حفظه ورعايته؛ (رواه ابن ماجه بسند صحيح)، فاذهب إلى أي مكان شئتَ يا من صليت الفجر في جماعة ولا تخَفْ؛ فأنت في حفظ الله
لا ملك من ملوك الدنيا، كلا والله، بل في حفظ ملك الملوك جل وعلا.
7- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بأعظم نعيم في الجنان وهو رؤية الرحمن؛ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما إنكم سترَون ربكم كما ترون القمر لا تضامُّون في رؤيته - أي: لا يصيبكم الضيم وهو المشقة والتعب - فإن استطعتم ألَّا تُغلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا - يعني: صلاة العصر والفجر - ثم قرأ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130].
8- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بالوعد من الله بدخول الجنان وبالنجاة من النار؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى البَرْدَيْنِ، دخل الجنة»؛ (رواه البخاري ومسلم)، والبردان هما: الصبح والعصر، وقال صلى الله عليه وسلم: «لن يَلِجَ النار أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»؛ يعني: الفجر والعصر؛ (رواه مسلم).
9- أبشروا يا أهل صلاة الفجر بنشاط أبدانكم وطِيب نفوسكم؛ فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يعقِد الشيطان علي قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليلٌ طويلٌ فارْقُدْ، فإن استيقظ فذكر الله انحلَّت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة؛ فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 10-أبشروا يا أهل صلاة الفجر بصلاةٍ سُنَّتُها خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ فلقد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، والمقصود ليست الفريضة بل السنة القبلية، فسنة الفجر خير من الدنيا وما فيها من قصور وأموال ودور وملذات، فإذا كان هذا الفضل للسنة، فكيف بالفريضة نفسها، لا شك أنها أعظم أجرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
وبعد ما سمعتَ يا عبدالله عن هذه الفضائل العظام، التي واحدة منها والله لكافية لأن تستيقظ وتقوم لتصلي مع المسلمين، فهل ستتركها بعد ذلك؟ وهل ستحرم نفسك كل هذه الأجور؟ فيا أهل صلاة الفجر، اثبتوا على ما أنتم عليه، واحتسبوا الأجر عند ربكم، وجاهدوا وثابروا حتى تصِلوا الجنة بإذن الله. أيها المؤمنون، إن أردتم سعادة في القلب وانشراحًا في الصدر، فعليكم بصلاة الفجر.
احباب المصطفى بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بمافيه من الايات والذكر الحكيم قلت ماسمعتم واستغفروا الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فااستغفروه فيا فوز المستغفرين _________________________
خطبة الجمعه
الخطبة الثانيه بعنوان
لماذا ميز الله صلاة الجمعه بالخطب والمواعظ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمدلله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده خير من خلق وبخير الكلام نطق وعلى هديه جميع الكائنات تتفق
صلوات ربي وسلامه عليك ياحبيبي يارسول الله
وبعد اخواني المؤمنين المرابطين هناك ظاهرة صغيره طالما سمعت تكراراها من كثير من الناس ليس هنا فقط بل في كل مكان واحببت ان اذكرها لكم في هذا المقام......
لعلنا نعمل على تغير انفسنا ونأخذ من الكلام ماينفعنا فربما كلمة تسمعها قد تغير حياتك وفقني الله واياكم الى كل خير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد البحث الطويل في قول أُناسٍ بعد انتهاء الخطيب من خطبته،
او المحاضر من محاضرته او المحدث من حديثه تسمع كثيرمن الناس يقولون؟!
لم نستفد ولم نفهم شيئًا من الخطبة، فقد درست هذا الأمر جيدًا، ولم أرَ العيب في الخطيب دائمًا
بل في كثير من الأحيان يكون العيب في المستمع الذي لم يفهم ولم يستفد من الخطبة شيئًا، حتى لو معلومة واحدة أو آية أو حديثًا، إني أعي ما أقول جيدًا، أين قلبك من خطبة الجمعة؟ فها هو صحابيٌّ جليل، اسمه ضماد، تأثر قلبه بخطبة الحاجة وهو كافر، فأسلم، (إن الحمد لله نحمده ونستعينه..) لها قصة، وفي القصة عِبرة وعِظة، يرويها الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ ضِمادًا رضي الله عنه جاء إلى مكة قبل إسلامه، وكان يُرقِي، فسمِع سفهاء مكة يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم: مجنون، فقال: لعلي رأيت هذا الرجل فيجعل الله شفاءه على يدي، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك في أن أرقيَك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فهو المهتدِ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد..»، فقال ضماد: أعِد عليَّ كلماتك، فعادهن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ثم قال: هاتِ يدك أبايعك على الإسلام فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وعلى قومك» ؟ قال: وعلى قومي))، إنها كلمات يسيرات وفي مجلس واحد تأثر ضماد رضي الله عنه، نقلته هذه المقدمة فقط من الكفر إلى التوحيد، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، بل أخرجته وأخرجت قومه معه، كلمات ترددت كثيرًا على منابرنا، وتكررت كثيرًا في الجمعة على مسامعنا، فأين أثرها في قلوبنا، وأثر ما بعدها من الموعظة علينا، من أثرها على ضماد رضي الله عنه؟
عباد الرحمن، لقد منَّ الله عليكم بيوم هو خير الأيام؛ قال عنه نبيكم صلى الله عليه وسلم: «هو خيرُ يوم طلعت عليه الشمس»، هو يوم الجمعة وزيَّنه لكم بأحكم الشرائع، ففرض عليكم فيه صلاة هي أفرض الصلوات؛ صلاة الجمعة، وقدمها لكم بخطبة؛ فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]؛ أي: إلى الخطبة والمواعظ لتخرجوا بعد الخطبة بقلوب غير التي دخلتم بها، وبحال أفضل من الحال الذي دخلتم به، مُتَّعِظين معتبرين، قلوبكم بالإيمان عامرة، وعن الذنوب والمعاصي تائبين. عباد الله، خطبة الجمعة للأسف هي الفرصة الوحيدة لكثير من المسلمين في سماع وتلقِّي العلم، حين فرطوا في دينهم، فما تفقَّهوا فيه، ويا أسفاه ويا حسرتاه حين تُقلب النظر في أبناء الجمعة، فلا ترى لها فيهم أثرًا للخطبة، ولا تلحظ لها عليهم خبرًا!
اخواني في الله ارجو الله ان نكون قد وفقنا فيما قلته أنا واستوعبته انت وان يعيينا على جهاد انفسنا وينصرنا على عدونا
هذا وصلو وسلمو على من امرنا جل وعلا بالصلاة عليه
حيث بدأها بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم ايها المؤمنون من إنسه وجنه
حيث قال عز من قائل
(( إن الله وملائكته يصلون على النبي ياايها الذين امنو صلو عليه وسلمو تسليما
اللهم فصلي وسلم على نبينا محمد نور شمس العرفان ومهبط اسرار القرآن المرشد العظيم والقائد الحكيم وخير داعٍ الى الصراط المستقيم
اللهم اجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه
اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعه ولوالديه وفتح للموعظه قلبه واذنيه
اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهديين
اللهم إنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنه والنجاة من النار
اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين
اللهم انصر من نصر الدين
واخذل من خذل المسلمين
اللهم انصر جنودك المرابطين
في فلسطين اللهم نصرك الذي وعدت ياكريم
اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين
اللهم انصرنا وانصر اخواننا المرابطين في جميع الثغور والجبهات والميادين يارب العالمين
اللهم لاتصرفنا من مقامنا هذا هذا الا بذنب مغفور وسعيا مشكور وتجارة لن تبور عزيز ياغفور
وفقكم الله حفظكم الله رعاكم الله نصركم الله أيدكم الله
عباد الله إن الله يأمركم بثلاث فأدوها وينهاكم عن ثلاث فانتهو عنها إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتا ذي القربى وينهى عن الفحشاءوالمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
فاذكرو الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ماتصنعون واقم الصلاة
================
#خطبة الجمعه
للقائد المجاهد# محمد المحرابي ...المزيد
خطبة الجمعه1447/1/2هـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعنوان ...
خطبة الجمعه1447/1/2هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعنوان ــــــــــــــــــــــــ
♕الخطبة الأولى ♕
(معالم من التضحيات في الهجره النبويه المشرفه
♕الخطبة الثانيه♕
( الجرد السنوي محاسبة ومشارطه)
===================
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
ـــــــــــــــــ
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلهٌ عزَّ مَن اعتز به فلا يضام، وذلَّ مَن تكبر عن أمره ولقي الآثام.
ــــــــــــــــ
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خاتم أنبيائه، وسيد أصفيائه، المخصوص بالمقام المحمود، في اليوم المشهود، الذي جُمع فيه الأنبياء تحت لوائه.
آياتُ أحمدَ لا تحدُّ لواصف
ولوَ انَّه أُمليْ وعاش دهورَا
بشراكمُ يا أمة المختار في
يوم القيامة جنة وحريرَا
فُضِّلتمُ حقًّا بأشرف مرسَل
خير البرية باديًا وحضورَا
صلى عليه الله ربي دائمًا
ما دامت الدنيا وزاد كثيرَا
ـــــــ
وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه، وتمسَّك بسنته، واقتدى بهديه، واتَّبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين.
وبعد ـــــــــــــــــ
ايها الاخوة الأعزاء
اوصيكم اولاً ونفسي بتقوى الله عزوجل قال عز من قائل ({ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }
[سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٠٢]»»»»»»
لقد كرر القرآن المجيد الحديث عن الهجرة، ومجد أهلها، وعطر حديثها.. فهو حدث ليس ككل حدث. بل يحتاج منا إلى الوقوف عنده طويلا والتأمل في دروسه ونتائجه كثيرا؛ حتى تزداد العقول نورا وإيمانا وعطاء، وتضحية وإخاء، وبذلا وفداء... يشرق على الوجود هلال شهر الله المحرم، فيجدد فينا ذكرى من أروع الذكريات في تاريخ الإسلام، وأعظمها أثرا، وأرفعها شأنا، وأوسعها يمنا، وأنبلها قصدا.. إنه حادث الهجرة النبوية المباركة. اللهم اجعلنا مهاجرين إليك، مقبلين بكلنا عليك، مستعينين في كل أمورنا بك، متوكلين في كل شأننا عليك. اللهم اجعل هجرتنا من المعاصي والمنكرات إلى فعل الخيرات واكتساب الطاعات. لقد كرر القرآن المجيد الحديث عن الهجرة، ومجد أهلها، وعطر حديثها.. فهو حدث ليس ككل حدث. بل يحتاج منا إلى الوقوف عنده طويلا والتأمل في دروسه ونتائجه كثيرا؛ حتى تزداد العقول نورا وإيمانا وعطاء، وتضحية وإخاء، وبذلا وفداء. لنعلم أن المعالي لا تنال بالأماني، وأن الدعوات لا تقوم إلا على ألوان البذل والتضحيات، وأشرف التضحيات وأسماها ما كان ابتغاء وجه الله تعالى. ولقد كانت الهجرة في ذاتها نوعا من أرقى أنواع التضحية. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور، وسخاوة النفوس، والنصيحة للأمة، وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. لقد عاش الصحابة في حادث الهجرة التضحية في أروع صورها، وسجل القرآن لهم فيها روعة الفداء، وصدق التضحية، وقوة الإيمان، وثبات اليقين. لقد عاشوا هذا المعنى في كل حركاتهم وسكناتهم، وبذلوا في سبيل دينهم الغالي والرخيص، والنفس والنفيس، وبذلوا الجهد الجهيد والوقت الثمين. لم تشغلهم الأموال والأعمال، ولا الزوجات والأولاد عن الخروج في سبيل الله، ونصرة الدين، ضحوا بكل شيء ـ نعم بكل شيء ـ حتى تبقى راية الإسلام خفاقة، ولتبقى كلمة التوحيد تتردد في جنبات هذا الكون. زوج يفارق زوجته، وأب يفارق أبناءه، وابن يفارق والديه، ورجل يبيع نفسه لله ، وآخر يقدم ماله.. وكلهم جميعا تركوا والديار والأوطان، والأموال والأقارب والخلان.. كل ذلك في سبيل رضا الرحمن وإعلاء كلمة الواحد الديان. فيا رسول الله طـب نفــسا بطائفة .. باعـوا إلى الله أرواحــا وأبدانــا دفعوا ضريبة نصر الله من دمهــم .. والناس تزعم نصر الدين مجانـا نماذج من التضحيات: مصعب ابن عمير: شاب غني رخي باع الغنى والقرابة، والاستقرار والثروة، والمال والجاه والراحة، والحياة الهانئة الرخية، وارتضى الحرمان والمشقة والأذى والبلاء، حتى تحشف جلده بعد أن كان أنعم فتى في مكة كلها، تضرب بنعومته الأمثال، وبعد أن كان أغنى فتى في مكة، وأكثرها دلالا، وأبهاها جمالا، وأغناها جاها ومالا، إذا به يموت في أرض غريبة وفي فقر مدقع، حتى لا يجد الناس ما يكفنونه به بعد موته إلا خميصة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا به رجليه بدا رأسه.. في سبيل من كل هذا؟ إنه في سبيل الجنات، ورضا رب الأرض والسموات. أبو سلمة بن عبد الأسد: مثال راق من التضحية لله ولدينه ولرسوله، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، لما أراد أن يهاجر أراد اصطحاب زوجته المؤمنة، وابنه سلمة الصغير معه.. فاجتمع عليه أصهاره، وقالوا: نفسك غلبتنا عليها، أما ابنتنا (يعنون زوجته) فلا والله لا نتركك تأخذها معك. وجاء أقاربه فقالوا: ونحن والله لا نترك ابننا (يعنون سلمة) معكم؛ ففرقوا بين الرجل وأسرته، ثم فرقوا بين المرأة وابنها، بعد أن تجاذبوه حتى خلعوا يده، وترك أبو سلمة كل ذلك وهاجر لله ولرسوله. علي بن أبي طالب: ذاك الفدائي العظيم، يبيت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، معرضا نفسه للقتل الذي ما منه بد في حالة علم المشركون وقدروا عليه، لكنها نفس ترخص في سبيل الدفاع عن الدين وعن رسوله. يجود بالنفس إن ضن الجواد بها .. والجود بالنفس أقصى غاية الجود صهيب الرومي: صاحب البشارة العظيمة، [ربح البيع أبا يحيى ربح البيع]، ذلك أنه عندما أراد الهجرة وعلم به المشركون وقفوا في طريقه وأرادوا أن يمنعوه من الهجرة، وقالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، وتريد أن نتركك تهاجر بكل هذا المال؟ (وكان قد جمع مالا كثيرا بتجارته بالسيوف التي كان يصنعها ويبيعها).. فقال: إن تركت لكم المال تتركوني أهاجر؟ قالوا نعم. فدلهم على مكان المال، فأخذوا المال وتركوه؛ فهاجر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع». وأنزل الله فيه وفي أمثاله: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد}. وماذا نقول عن أبي بكر وعمر وغيرهما؟ وكل واحد من المهاجرين كانت له قصة فداء وتضحية في سبيل الله، خالصة صادقة لا رياء فيها ولا سمعة حتى شهد الله لهم جميعا بالصدق وابتغاء وجهه الكريم فقال سبحانه: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحشر:8]. تضحيات الأنصار: غير أنه مما يبهر العقل والقلب ويبعث على العجب كل العجب، أنه لم يقابل تضحيات المهاجرين في سبيل ربهم ودينهم ورسولهم إلا ما قام به الأنصار رضوان الله تعالى على الجميع.
فقد ضربوا أعظم الأمثلة في الإيثار والمحبة والأخوة، ففتحوا لإخوانهم المهاجرين قلوبهم قبل أن يفتحوا لهم بيوتهم، ووسعوهم بنفوسهم قبل أن يسعوهم بأموالهم، وتسابقوا في إكرامهم، وتقاسموا معهم أموالهم وطعامهم ودورهم وأرضهم، وآثروهم على أنفسهم، وأنفقوا عليهم مما رزقهم الله، وآتوهم المال على حبه، ولم يكن ثم أحد يجازيهم على فعالهم بأفضل مما أثنى الله به عليهم في كتابه العزيز، وخلد مآثرهم إلى يوم يبعث الناس لرب العالمين، فقال وهو العزيز الحكيم: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر:9]. لقد علمنا الصحابة الكرام ـ عليهم الرحمة والرضوان ـ أن التضحية والإيثار صفات أهل السبق والإيمان، وأن دين الله أغلى من كل شيء، وأن إقامة هذا الدين والتمكين له في الأرض لا يكون بالأماني، وأن النصر لا يتأتي للقاعدين الخاملين، وإنما النصر مقرون بالبذل والتضحية والفداء والعطاء. إن حجم العداوات والتحديات التي يقابلها الإسلام وأهله في هذا الزمان تستوجب كثيرا من مثل هذه التضحيات، ولا يمكن تحرير المقدسات والذود عن الدين والعرض، والوطن والأرض بالخطب والمقالات والمؤتمرات والاجتماعات، ولكن بالاستعداد والإعداد، والجهد والجهاد، جهود صادقة، وتضحيات غالية، وعمل دؤوب يسترجع المفقود ويحقق المنشود {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال:60]. وحقيقة أخرى تتعلق بتلك الحقيقة الأولى، وهو أن التضحيات لا تضيع أبدا، وما بذل في سبيل الله لا يذهب سدى، فمن ضحى بالنفس يحوز الفردوس، ومن ضحى بالمال فالله يخلفه أضعافا مضاعفة، ومن ضحى بوقته بورك له في عمره، ومن بذل حياته لله رخيصة عوضه الله أحسن العوض {وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [آل عمران:157]. ويبقى وعد الله لا يتخلف على مر الأعوام والأزمان: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [محمد:
قلت ماسمعتم فاستغفرو الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغروا الله فيافوز المستغفرين
======================================
الخطبه الثانيه ١٤٤٧/١/٢هجرية
الجرد السنوي للعام المنصرم
المحاسبة والمشارطه::::::
الحمدلله والصلاة والسلام على البشير النذير المجاهد الشهيد الشفيع يوم الوعيد
سيدنا وحبيبنامحمدﷺ
وبعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيها المؤمنون احبتي في الله، عامٌ مضى، وعام أتى، والمؤمن لا يحتفل بأعوام قد مضت، أو أخرى قد أقبلت بقدر ما يقف مع نفسه وقفة محاسبة، فيحاسبها عمَّا قدَّم وأخَّر؛ (محاسبة ومشارطة). • محاسبة لِما مضى. • ومشارطة لِما هو آتٍ. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحشر: 18]. قال عمر رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنوا أعمالكم قبل أن تُوزَن عليكم، وتزيَّنوا للعرض الأكبر: {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ} [الحاقة: 18]. • ومعنى محاسبة النفس: أن يتصفح العبد ما صدر منه من أفعال وأقوال؛ فإن كانت محمودة أمضاها، وإن كانت مذمومة استدركها. ومن فوائد المحاسبة: 1- أن يعرف العبد حقَّ الله تعالى عليه، ثم يسأل نفسه: هل قام بهذا الحق كما ينبغي أم لا؟ 2- مطالعة عيوب النفس لتلافيها ومعالجتها؛ فمن لم يطلع على عيوبه لم يمكنه إزالتها. وحتى تُؤتِيَ المحاسبة ثمارَها المرجوَّةَ؛ لا بد أن تعرف هذه القواعد المهمة للمحاسبة: ما هو رأس المال؟ ما هي أسباب الأرباح؟ ما هي أسباب الخسران؟ • قال ابن القيم رحمه الله في طريقة محاسبة النفس: "وجِماعُ ذلك أن يحاسب نفسه أولًا عن الفرائض، فإن تذكَّر فيها نقصًا، تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها عن المناهي، فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئًا، تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية". • فأما رأس المال، فهي الفرائض والواجبات. • وأوجب الواجبات هو التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد؛ فهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من ذرية آدم وهم في أصلاب آبائهم. قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} [الأعراف: 172]. • فيحاسب العبد نفسه؛ حذرًا وخوفًا من الوقوع في الشرك؛ حتى لا يخسر دنياه وآخرته. قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65]. • ثم يحاسب نفسه على الصلوات الخمس؛ لئلا يكون فيها نقص أو تقصير؛ لأنه سيُحاسَب عليها يوم القيامة. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ أولَ ما يُحاسب به العبدُ المسلمُ يومَ القيامةِ الصلاةُ المكتوبة، فإن أتمَّها، وإلا قيل: انظروا هل له مِنْ تطوُّعٍ؟ فإن كان له تطوُّع، أُكملت الفريضةُ مِنْ تطوُّعه، ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك». فيحاسب العبد نفسه على: 1800 صلاة طوال العام، كم منها في أوقاتها جماعة؟ وكم ضيع منها؟ 1800 فرصة لدخول الجنة بقراءة آية الكرسي دُبُرَ كل صلاة مكتوبة.ز 1800 فرصة لدعوة مستجابة عقب كل أذان. 1800 فرصة لإدراك تكبيرة الإحرام. ويحاسب العبد نفسه على صلاة الجمعة: أكثر من 48 فرصة للصلاة والسلام على خير الأنام في أفضل الأيام، فكم جعل لنفسه من هذا الخير العظيم؟ أكثر من 48 فرصة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ ليحظى بالنور والخير العظيم، فكم أدركت من ذلك؟ أكثر من 48 فرصة ساعة إجابة آخر ساعة من يوم الجمعة، فكم أدرك من هذه الساعات؟ • وأما أسباب الأرباح، فهي النوافل وأبواب الخير والقربات التي ترفع العبد درجات؛ فيحاسب العبد نفسه على قراءة القرآن، وهل له ختمة شهرية لكتاب الله تعالى أم لا؟ 12 ختمة قرآن. 360 أذكار صباحٍ ومساء. 360 صلاة ضحى. 360 بيت في الجنة (الرواتب). كم مجلس علم حضره؟ كم حلقة قرآن حضرها؟ كم تصدقت؟ كم ذكرت الله تعالى؟ • وأما أسباب الخسران، فهي كل معصية أو تضييع لواجب من الواجبات؛ فيحاسب العبد نفسه على الذنوب والمعاصي والتفريط قبل الندم. • لما تم لبعض السلف سبعون سنة من عمره، وقف مع نفسه وقفة محاسبة، فنظر فإذا به قد مضى عليه منذ بلوغه أكثر من عشرين ألف يوم، فعاتب نفسه، وقال: ماذا لو لقيت ربي كل يوم بذنب واحد فقط؟! أألقى الله بعشرين ألف ذنب؟ ثم بكى رحمه الله. • فيسارع العبد بالتوبة إلى الله تعالى، وكثرة الاستغفار، والحسنات المكفِّرة، ويأخذ بأسباب المغفرة، قبل أن يلقى الله تعالى؛ فيندم شديد الندم على التضييع والتفريط.
قال جل في علاه:
: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ} [الزمر: 56]، وقال الله تعالى:{ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون: 9، 10].
عباد الله صلوا وسلمو على من امرتم بالصلاة عليه امتثالا لأمر الله تعالى حيث قال (( إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلمو تسليما
نسأل الله العظيم أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يوفِّقنا لِما يحب ويرضى.
اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل عامنا هذا وما بعده من أعوامٍ أعوامَ أمن وطمأنينة وعلم نافع وعمل صالح به رشاد الأمة وذلُّ الأعداء في جميع البلاد يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعه ولوالديه وفتح للموعظه قلبه وأذنيه
اللهم انصر الاسلام واعز المسلمي
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين
اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل بقاع الارض عامه وفي غزه وبلادنا خاصه ياقوي ياعزيز
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتا ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكرو الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ماتصنعون واقم الصلاة ===================
إعداد وأداء / القائد المجاهد
محمد المحرابي ...المزيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعنوان ــــــــــــــــــــــــ
♕الخطبة الأولى ♕
(معالم من التضحيات في الهجره النبويه المشرفه
♕الخطبة الثانيه♕
( الجرد السنوي محاسبة ومشارطه)
===================
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
ـــــــــــــــــ
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلهٌ عزَّ مَن اعتز به فلا يضام، وذلَّ مَن تكبر عن أمره ولقي الآثام.
ــــــــــــــــ
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خاتم أنبيائه، وسيد أصفيائه، المخصوص بالمقام المحمود، في اليوم المشهود، الذي جُمع فيه الأنبياء تحت لوائه.
آياتُ أحمدَ لا تحدُّ لواصف
ولوَ انَّه أُمليْ وعاش دهورَا
بشراكمُ يا أمة المختار في
يوم القيامة جنة وحريرَا
فُضِّلتمُ حقًّا بأشرف مرسَل
خير البرية باديًا وحضورَا
صلى عليه الله ربي دائمًا
ما دامت الدنيا وزاد كثيرَا
ـــــــ
وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه، وتمسَّك بسنته، واقتدى بهديه، واتَّبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين.
وبعد ـــــــــــــــــ
ايها الاخوة الأعزاء
اوصيكم اولاً ونفسي بتقوى الله عزوجل قال عز من قائل ({ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }
[سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٠٢]»»»»»»
لقد كرر القرآن المجيد الحديث عن الهجرة، ومجد أهلها، وعطر حديثها.. فهو حدث ليس ككل حدث. بل يحتاج منا إلى الوقوف عنده طويلا والتأمل في دروسه ونتائجه كثيرا؛ حتى تزداد العقول نورا وإيمانا وعطاء، وتضحية وإخاء، وبذلا وفداء... يشرق على الوجود هلال شهر الله المحرم، فيجدد فينا ذكرى من أروع الذكريات في تاريخ الإسلام، وأعظمها أثرا، وأرفعها شأنا، وأوسعها يمنا، وأنبلها قصدا.. إنه حادث الهجرة النبوية المباركة. اللهم اجعلنا مهاجرين إليك، مقبلين بكلنا عليك، مستعينين في كل أمورنا بك، متوكلين في كل شأننا عليك. اللهم اجعل هجرتنا من المعاصي والمنكرات إلى فعل الخيرات واكتساب الطاعات. لقد كرر القرآن المجيد الحديث عن الهجرة، ومجد أهلها، وعطر حديثها.. فهو حدث ليس ككل حدث. بل يحتاج منا إلى الوقوف عنده طويلا والتأمل في دروسه ونتائجه كثيرا؛ حتى تزداد العقول نورا وإيمانا وعطاء، وتضحية وإخاء، وبذلا وفداء. لنعلم أن المعالي لا تنال بالأماني، وأن الدعوات لا تقوم إلا على ألوان البذل والتضحيات، وأشرف التضحيات وأسماها ما كان ابتغاء وجه الله تعالى. ولقد كانت الهجرة في ذاتها نوعا من أرقى أنواع التضحية. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور، وسخاوة النفوس، والنصيحة للأمة، وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. لقد عاش الصحابة في حادث الهجرة التضحية في أروع صورها، وسجل القرآن لهم فيها روعة الفداء، وصدق التضحية، وقوة الإيمان، وثبات اليقين. لقد عاشوا هذا المعنى في كل حركاتهم وسكناتهم، وبذلوا في سبيل دينهم الغالي والرخيص، والنفس والنفيس، وبذلوا الجهد الجهيد والوقت الثمين. لم تشغلهم الأموال والأعمال، ولا الزوجات والأولاد عن الخروج في سبيل الله، ونصرة الدين، ضحوا بكل شيء ـ نعم بكل شيء ـ حتى تبقى راية الإسلام خفاقة، ولتبقى كلمة التوحيد تتردد في جنبات هذا الكون. زوج يفارق زوجته، وأب يفارق أبناءه، وابن يفارق والديه، ورجل يبيع نفسه لله ، وآخر يقدم ماله.. وكلهم جميعا تركوا والديار والأوطان، والأموال والأقارب والخلان.. كل ذلك في سبيل رضا الرحمن وإعلاء كلمة الواحد الديان. فيا رسول الله طـب نفــسا بطائفة .. باعـوا إلى الله أرواحــا وأبدانــا دفعوا ضريبة نصر الله من دمهــم .. والناس تزعم نصر الدين مجانـا نماذج من التضحيات: مصعب ابن عمير: شاب غني رخي باع الغنى والقرابة، والاستقرار والثروة، والمال والجاه والراحة، والحياة الهانئة الرخية، وارتضى الحرمان والمشقة والأذى والبلاء، حتى تحشف جلده بعد أن كان أنعم فتى في مكة كلها، تضرب بنعومته الأمثال، وبعد أن كان أغنى فتى في مكة، وأكثرها دلالا، وأبهاها جمالا، وأغناها جاها ومالا، إذا به يموت في أرض غريبة وفي فقر مدقع، حتى لا يجد الناس ما يكفنونه به بعد موته إلا خميصة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا به رجليه بدا رأسه.. في سبيل من كل هذا؟ إنه في سبيل الجنات، ورضا رب الأرض والسموات. أبو سلمة بن عبد الأسد: مثال راق من التضحية لله ولدينه ولرسوله، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، لما أراد أن يهاجر أراد اصطحاب زوجته المؤمنة، وابنه سلمة الصغير معه.. فاجتمع عليه أصهاره، وقالوا: نفسك غلبتنا عليها، أما ابنتنا (يعنون زوجته) فلا والله لا نتركك تأخذها معك. وجاء أقاربه فقالوا: ونحن والله لا نترك ابننا (يعنون سلمة) معكم؛ ففرقوا بين الرجل وأسرته، ثم فرقوا بين المرأة وابنها، بعد أن تجاذبوه حتى خلعوا يده، وترك أبو سلمة كل ذلك وهاجر لله ولرسوله. علي بن أبي طالب: ذاك الفدائي العظيم، يبيت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، معرضا نفسه للقتل الذي ما منه بد في حالة علم المشركون وقدروا عليه، لكنها نفس ترخص في سبيل الدفاع عن الدين وعن رسوله. يجود بالنفس إن ضن الجواد بها .. والجود بالنفس أقصى غاية الجود صهيب الرومي: صاحب البشارة العظيمة، [ربح البيع أبا يحيى ربح البيع]، ذلك أنه عندما أراد الهجرة وعلم به المشركون وقفوا في طريقه وأرادوا أن يمنعوه من الهجرة، وقالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، وتريد أن نتركك تهاجر بكل هذا المال؟ (وكان قد جمع مالا كثيرا بتجارته بالسيوف التي كان يصنعها ويبيعها).. فقال: إن تركت لكم المال تتركوني أهاجر؟ قالوا نعم. فدلهم على مكان المال، فأخذوا المال وتركوه؛ فهاجر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع». وأنزل الله فيه وفي أمثاله: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد}. وماذا نقول عن أبي بكر وعمر وغيرهما؟ وكل واحد من المهاجرين كانت له قصة فداء وتضحية في سبيل الله، خالصة صادقة لا رياء فيها ولا سمعة حتى شهد الله لهم جميعا بالصدق وابتغاء وجهه الكريم فقال سبحانه: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحشر:8]. تضحيات الأنصار: غير أنه مما يبهر العقل والقلب ويبعث على العجب كل العجب، أنه لم يقابل تضحيات المهاجرين في سبيل ربهم ودينهم ورسولهم إلا ما قام به الأنصار رضوان الله تعالى على الجميع.
فقد ضربوا أعظم الأمثلة في الإيثار والمحبة والأخوة، ففتحوا لإخوانهم المهاجرين قلوبهم قبل أن يفتحوا لهم بيوتهم، ووسعوهم بنفوسهم قبل أن يسعوهم بأموالهم، وتسابقوا في إكرامهم، وتقاسموا معهم أموالهم وطعامهم ودورهم وأرضهم، وآثروهم على أنفسهم، وأنفقوا عليهم مما رزقهم الله، وآتوهم المال على حبه، ولم يكن ثم أحد يجازيهم على فعالهم بأفضل مما أثنى الله به عليهم في كتابه العزيز، وخلد مآثرهم إلى يوم يبعث الناس لرب العالمين، فقال وهو العزيز الحكيم: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر:9]. لقد علمنا الصحابة الكرام ـ عليهم الرحمة والرضوان ـ أن التضحية والإيثار صفات أهل السبق والإيمان، وأن دين الله أغلى من كل شيء، وأن إقامة هذا الدين والتمكين له في الأرض لا يكون بالأماني، وأن النصر لا يتأتي للقاعدين الخاملين، وإنما النصر مقرون بالبذل والتضحية والفداء والعطاء. إن حجم العداوات والتحديات التي يقابلها الإسلام وأهله في هذا الزمان تستوجب كثيرا من مثل هذه التضحيات، ولا يمكن تحرير المقدسات والذود عن الدين والعرض، والوطن والأرض بالخطب والمقالات والمؤتمرات والاجتماعات، ولكن بالاستعداد والإعداد، والجهد والجهاد، جهود صادقة، وتضحيات غالية، وعمل دؤوب يسترجع المفقود ويحقق المنشود {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال:60]. وحقيقة أخرى تتعلق بتلك الحقيقة الأولى، وهو أن التضحيات لا تضيع أبدا، وما بذل في سبيل الله لا يذهب سدى، فمن ضحى بالنفس يحوز الفردوس، ومن ضحى بالمال فالله يخلفه أضعافا مضاعفة، ومن ضحى بوقته بورك له في عمره، ومن بذل حياته لله رخيصة عوضه الله أحسن العوض {وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [آل عمران:157]. ويبقى وعد الله لا يتخلف على مر الأعوام والأزمان: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [محمد:
قلت ماسمعتم فاستغفرو الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغروا الله فيافوز المستغفرين
======================================
الخطبه الثانيه ١٤٤٧/١/٢هجرية
الجرد السنوي للعام المنصرم
المحاسبة والمشارطه::::::
الحمدلله والصلاة والسلام على البشير النذير المجاهد الشهيد الشفيع يوم الوعيد
سيدنا وحبيبنامحمدﷺ
وبعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيها المؤمنون احبتي في الله، عامٌ مضى، وعام أتى، والمؤمن لا يحتفل بأعوام قد مضت، أو أخرى قد أقبلت بقدر ما يقف مع نفسه وقفة محاسبة، فيحاسبها عمَّا قدَّم وأخَّر؛ (محاسبة ومشارطة). • محاسبة لِما مضى. • ومشارطة لِما هو آتٍ. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحشر: 18]. قال عمر رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا، وزِنوا أعمالكم قبل أن تُوزَن عليكم، وتزيَّنوا للعرض الأكبر: {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ} [الحاقة: 18]. • ومعنى محاسبة النفس: أن يتصفح العبد ما صدر منه من أفعال وأقوال؛ فإن كانت محمودة أمضاها، وإن كانت مذمومة استدركها. ومن فوائد المحاسبة: 1- أن يعرف العبد حقَّ الله تعالى عليه، ثم يسأل نفسه: هل قام بهذا الحق كما ينبغي أم لا؟ 2- مطالعة عيوب النفس لتلافيها ومعالجتها؛ فمن لم يطلع على عيوبه لم يمكنه إزالتها. وحتى تُؤتِيَ المحاسبة ثمارَها المرجوَّةَ؛ لا بد أن تعرف هذه القواعد المهمة للمحاسبة: ما هو رأس المال؟ ما هي أسباب الأرباح؟ ما هي أسباب الخسران؟ • قال ابن القيم رحمه الله في طريقة محاسبة النفس: "وجِماعُ ذلك أن يحاسب نفسه أولًا عن الفرائض، فإن تذكَّر فيها نقصًا، تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها عن المناهي، فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئًا، تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية". • فأما رأس المال، فهي الفرائض والواجبات. • وأوجب الواجبات هو التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد؛ فهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من ذرية آدم وهم في أصلاب آبائهم. قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} [الأعراف: 172]. • فيحاسب العبد نفسه؛ حذرًا وخوفًا من الوقوع في الشرك؛ حتى لا يخسر دنياه وآخرته. قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65]. • ثم يحاسب نفسه على الصلوات الخمس؛ لئلا يكون فيها نقص أو تقصير؛ لأنه سيُحاسَب عليها يوم القيامة. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ أولَ ما يُحاسب به العبدُ المسلمُ يومَ القيامةِ الصلاةُ المكتوبة، فإن أتمَّها، وإلا قيل: انظروا هل له مِنْ تطوُّعٍ؟ فإن كان له تطوُّع، أُكملت الفريضةُ مِنْ تطوُّعه، ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك». فيحاسب العبد نفسه على: 1800 صلاة طوال العام، كم منها في أوقاتها جماعة؟ وكم ضيع منها؟ 1800 فرصة لدخول الجنة بقراءة آية الكرسي دُبُرَ كل صلاة مكتوبة.ز 1800 فرصة لدعوة مستجابة عقب كل أذان. 1800 فرصة لإدراك تكبيرة الإحرام. ويحاسب العبد نفسه على صلاة الجمعة: أكثر من 48 فرصة للصلاة والسلام على خير الأنام في أفضل الأيام، فكم جعل لنفسه من هذا الخير العظيم؟ أكثر من 48 فرصة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ ليحظى بالنور والخير العظيم، فكم أدركت من ذلك؟ أكثر من 48 فرصة ساعة إجابة آخر ساعة من يوم الجمعة، فكم أدرك من هذه الساعات؟ • وأما أسباب الأرباح، فهي النوافل وأبواب الخير والقربات التي ترفع العبد درجات؛ فيحاسب العبد نفسه على قراءة القرآن، وهل له ختمة شهرية لكتاب الله تعالى أم لا؟ 12 ختمة قرآن. 360 أذكار صباحٍ ومساء. 360 صلاة ضحى. 360 بيت في الجنة (الرواتب). كم مجلس علم حضره؟ كم حلقة قرآن حضرها؟ كم تصدقت؟ كم ذكرت الله تعالى؟ • وأما أسباب الخسران، فهي كل معصية أو تضييع لواجب من الواجبات؛ فيحاسب العبد نفسه على الذنوب والمعاصي والتفريط قبل الندم. • لما تم لبعض السلف سبعون سنة من عمره، وقف مع نفسه وقفة محاسبة، فنظر فإذا به قد مضى عليه منذ بلوغه أكثر من عشرين ألف يوم، فعاتب نفسه، وقال: ماذا لو لقيت ربي كل يوم بذنب واحد فقط؟! أألقى الله بعشرين ألف ذنب؟ ثم بكى رحمه الله. • فيسارع العبد بالتوبة إلى الله تعالى، وكثرة الاستغفار، والحسنات المكفِّرة، ويأخذ بأسباب المغفرة، قبل أن يلقى الله تعالى؛ فيندم شديد الندم على التضييع والتفريط.
قال جل في علاه:
: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ} [الزمر: 56]، وقال الله تعالى:{ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون: 9، 10].
عباد الله صلوا وسلمو على من امرتم بالصلاة عليه امتثالا لأمر الله تعالى حيث قال (( إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلمو تسليما
نسأل الله العظيم أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يوفِّقنا لِما يحب ويرضى.
اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل عامنا هذا وما بعده من أعوامٍ أعوامَ أمن وطمأنينة وعلم نافع وعمل صالح به رشاد الأمة وذلُّ الأعداء في جميع البلاد يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعه ولوالديه وفتح للموعظه قلبه وأذنيه
اللهم انصر الاسلام واعز المسلمي
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين
اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل بقاع الارض عامه وفي غزه وبلادنا خاصه ياقوي ياعزيز
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتا ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكرو الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ماتصنعون واقم الصلاة ===================
إعداد وأداء / القائد المجاهد
محمد المحرابي ...المزيد
بسم الله الرحمن الرحيم حاسبو انفسكم قبل ان تحاسبو وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
حاسبو انفسكم قبل ان تحاسبو وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم
حاسبو انفسكم قبل ان تحاسبو وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم
سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية (3-4) • تَكْفِيرُ الْمُشْـرِكِينَ الحمد لله رب العالمين، ...
سلسلة علمية
في بيان مسائل منهجية
(3-4)
• تَكْفِيرُ الْمُشْـرِكِينَ
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
ففي هذه الحلقة نبدأ الحديث -بعون الله تعالى- عن تكفير المشـركين، وسنتكلم عن مسألتين:
المسألة الأولى: سنجيب فيها على سؤال: ما هي منزلة التكفير من الدين؟
المسألة الثانية: نذكر فيها العلة أو المناط أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشـركين.
وقبل الشـروع في ذلك نذكر بعض نصوص أهل العلم في كفر من لم يكفر الكافر...
قال أبو الحسين الملطي الشافعي -رحمه الله-: "جميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر". (1) انتهى كلامه.
وقال القاضـي عياض -رحمه الله: "نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك". (2) انتهى كلامه.
وقال النووي -رحمه الله-: "من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر". (3)
ونص الحجاوي -رحمه الله- على أن من "لم يكفر من دان بغير الإسلام؛ كالنصارى، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم... فهو كافر".(4) انتهى كلامه.
ونص البهوتي -رحمه الله- على تكفير من "لم يكفر من دان بغير دين الإسلام كأهل الكتاب، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم".(5)
وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "من لم يكفر المشـركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر إجماعا". ا.هـ(6)
انتهى كلامهم رحمهم الله.
ونشـرع الآن في بيان المسألة الأولى: وهي الإجابة على سؤال: ما هي منزلة التكفير من الدين؟
والجواب هو أن التكفير حكم شـرعي محض، لا مدخل للعقل فيه، ولا يدخل تحت مسائل ومعاني أصل الدين، والتي سبق وأن بيناها في الحلقة السابقة.
إذن تكفير المشـركين من واجبات الدين وليس من أصل الدين.
طيب ما الفرق؟
الفرق أن ما كان من أصل الدين، فإنه لا يعذر المرء فيه بجهل، ولا تشترط إقامة الحجة على تاركه أو تارك بعضه.
أما التكفير فهو حكم شـرعي قد يعذر فيه بالجهل والتأويل.
ثم إن التكفير ليس على مستوى واحد، بل له مراتب، فأعلاها ما هو معلوم من الدين بالضـرورة؛ كتكفير من كفرهم الله تعالى في كتابه على التعيين؛ كإبليس وفرعون وكل من دان بغير الإسلام؛ كاليهود والنصارى وعباد الأصنام.
وأدناها ما اختلف في تكفير مرتكبه؛ كتارك الصلاة وغير ذلك، وبينهما مراتب متفاوتة، وهو ما سوف نتناوله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
قلنا: إن التكفير من واجبات الدين، وأنه حكم شـرعي، وليس له مورد سوى الأدلة الشـرعية، ولا مدخل للعقل فيه، وقد تتابع أهل العلم على تقرير ذلك وتأكيده، وإليكم بعض أقوالهم:
قال القاضـي عياض -رحمه الله-: "فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشـرع، ولا مجال للعقل فيه".(7) انتهى كلامه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "التكفير حكم شـرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدماء، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشـرعية".(8)
وقال -رحمه الله-: "فإن الكفر والفسق أحكام شـرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل؛ فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما..-إلى أن قال: - فهذه المسائل كلها ثابتة بالشـرع".(9)
وقال -رحمه الله-: "الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة، وبالأدلة الشـرعية يميز بين المؤمن والكافر، لا بمجرد الأدلة العقلية". (10) انتهى كلامه.
وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- :
الكفر حق الله ثم رسوله
بالنص يثبت لا بقول فلان
من كان رب العالمين وعبده
قد كفراه فذاك ذو الكفران(11)
وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه الله: "أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا، ولا نزاع في ذلك".(12) انتهى كلامه
وعليه نقول: إن من جهل حكم الشـرع في أحد الكفار أو المشـركين أو إحدى طوائفهم: لا يكون حكمه كحكم من أشـرك، لأن الذي أشـرك نقض أصل الدين؛ كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وإنما حكمه كحكم كل من جهل شـريعة أو فريضة من فرائض الإسلام، فمن قامت عليه الحجة الرسالية في ذلك كفر، ومن لم تبلغه الحجة الرسالية في ذلك فليس بكافر، بخلاف من جهل التوحيد؛ الذي هو أصل الدين؛ فإنه كافر كفر جهل.
هذا وقد تتابع أهل العلم على تقرير الفرق بين الجهل بأصل الدين والجهل بالواجبات الشـرعية:
فقد نقل الإمام محمد بن نصـر المروزي عن طائفة من أهل الحديث قولهم: "ولما كان العلم بـالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر... إلى أن قالوا: وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافرا، وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا، والجهل بـالله في كل حال كفر، قبل الخبر وبعد الخبر". (13) انتهى كلامه -رحمه الله-
وأما صفة قيام الحجة وكيفية تحقيق هذا الشـرط قبل التكفير، فإن ذلك يختلف بحسب ظهور المسألة وخفائها، فقد تقوم الحجة بمجرد وجود المتوقف عن التكفير في مظنة العلم، بحيث يكون بتوقفه معرضا لا جاهلا، وبحيث لا يعذر إلا من كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، وقد تكون إقامة الحجة بتبيين النص الشـرعي الدال على كفر من فعل كذا أو قال كذا، ولا يكتفى بمجرد البلوغ العام للقرآن، وقد تكون إقامة الحجة بتبيين الدليل مع إزالة الشبهة والإجابة عن الدليل المعارض، وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة عند الحديث عن مراتب المتوقفين.
ويستدل على التفريق بين الجهل بالشـرائع والجهل بأصل الدين أو على أن تكفير المشـركين من الشـرائع ليس من أصل الدين بعدة من الأدلة، أذكر منها:
إن جميع الأنبياء عليهم السلام بدءوا أقوامهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شـريك له، ولو أن الجهل بأحكام التكفير كفر لما تأخر بيانها عن بيان أصل الدين لحظة واحدة.
ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين وأنه حكم شـرعي وليس من أصل الدين ما ثبت أن من الصحابة رضي الله عنهم، من توقف في تكفير قوم وقعوا في الردة، وسموهم مسلمين، ولما نزلت الآيات التي بينت كفر هؤلاء القوم لم يستتابوا من توقفهم، بينما ثبت أن أحد الصحابة وقع في الشـرك جاهلا، ومع ذلك كفره الصحابة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه، وهذا يدل على الفرق بين من وقع في الشـرك جاهلا، وبين من جهل الشـرائع.
فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشـركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: "كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فـــاستغفروا لهم"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97، 98]، قال: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية، وأنه لا عذر لهم، قال: فخرجوا فلحقهم المشـركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} [العنكبوت: ١٠] الْآيَةَ".(14)
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله : "فأنزل الله هذه الآية، وبين فيها حكم هؤلاء المشـركين، وأنهم من أهل النار مع تكلمهم بالإسلام".(15) انتهى كلامه.
وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: كنا نذكر بعض الأمر، وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته، فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، ولا تعد له».(16)
وقال ابن الوزير الصنعاني-رحمه الله- معلقا على هذا الحديث: "وهذا أمر بتجديد الإسلام".(17) انتهى كلامه.
وقال ابن العربي المالكي -رحمه الله- "فمن قال في الإسلام في يمينه واللات والعزى مؤكدا ليمينه بذلك على معنى التعظيم فيه: كافر حقيقة". ا.هـ(18)
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله- : "أخذ به -يعني حديث سعد -رضي الله عنه- طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شـرك، قالوا: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول لا إله إلا الله، فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك، وقال الجمهور: لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، لكنه من الشـرك الأصغر".(19) انتهى كلامه.
فلم يعذر- رضي الله عنه- في ذلك مع أنه حديث عهد بجاهلية..
ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين، وأنه حكم شـرعي وليس من أصل الدين الذي لا يعذر فيه أحد: ما روي أن الصحابة -رضي الله عنهم- اختلفوا في تكفير بعض المرتدين، فلما بين الله تعالى كفر هؤلاء القوم لم يأمر من توقف فيهم بتجديد إسلامه.
فقد قال الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا * وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 88 - 89]
وصح في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: "نقتلهم"، وقال بعضهم: "لا".(20)
وصح عن مجاهد -رحمه الله- أنه قال: "قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فـاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؛ ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فـاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: "هم منافقون"، وقائل يقول: "هم مؤمنون"، فبين الله نفاقهم، فأمر بقتالهم".(21)
وقد روي بهذا المعنى عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وصح بنحوه مرسلا عن عدة من التابعين وهم: عكرمة، والسدي، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي رحمهم الله.
وقال الإمام الطبري -رحمه الله- في تأويل قوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا { [النساء: ٨٨]، قال: "يعني بذلك: والله ردهم إلى أحكام أهل الشـرك في إباحة دمائهم، وسبي ذراريهم". (22) انتهى كلامه.
وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، حيث قال بعدما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة".(23) انتهى كلامه.
وقال ابن أبي زمنين -رحمه الله-: "هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فـارتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشـرك، فلقيهم المسلمون، فكانوا فيهم فئتين؛ أي فرقتين، فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشـركون مرتدون، وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة، فقال الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ}".(24) انْتَهَىٰ كَلَامُهُ رحمه الله.
ومن الأدلة أيضا: ما رجحه طائفة من العلماء أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- توقف في تكفير مانعي الزكاة في بادئ أمرهم، ولما بين له أبو بكر -رضي الله عنه- كفرهم وافقه، ولم يستتبه على توقفه فيهم.
فقد صح عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لأبي بكر -رضي الله عنه- في شأن "المرتدين" : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ».(25)
وقد توقف بعض أئمة السلف -في بادئ الأمر- كفر من قال بخلق القرآن، ومنهم توقف في كفر الجهمية على الرغم من شدته، فلم يكونوا بذلك كفارا، ولما تبين لهم الدليل على كفرهم لم يتوقفوا فيهم، ولم يجددوا إسلامهم لأجل ما سبق من توقفهم.
فعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: "سألت أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق، فقال: "كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [البقرة: 145]، وَقَوْلَهُ: {بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [البقرة: 120[" وقوله: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ } [النساء: 166]" .(26)
وعن ابن عمار الموصلي -رحمه الله- قال: "يقول لي ابن المديني: ما يمنعك أن تكفرهم؟! -يعني: الجهمية- قال: وكنت أنا أولا أمتنع أن أكفرهم حتى قال ابن المديني ما قال، فلما أجاب إلى المحنة، كتبت إليه كتابا أذكره الله، وأذكره ما قال لي في تكفيرهم".(27)
وبذلك نكون قد انتهينا من المسألة الأولى...
ونشـرع الآن في بيان المسألة الثانية: وهي ما هو المناط أو العلة أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشـركين.
الجواب: هو تكذيب الشـرائع وردها.
فبالنظر إلى نصوص أهل العلم في هذا الناقض يظهر جليا ما قرروه من أن مناط الكفر في المتوقف في الكافر يرجع إلى تكذيب الشـرائع وردها، لا من جهة انتقاض أصل الدين.
وقد تتابع أكثر أهل العلم على ذكر هذا المناط بناء على أن الكفر إنما يكون بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها، أو بإنكار المعلوم من الدين ضـرورة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضـرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها ونحو ذلك". ا.هـ(28)
* وإليكم بعض ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم الذين نصوا على مناط كفر المتوقف في الكافر:
فقد علل القاضـي عياض تكفير المتوقف في اليهود والنصارى ومن فارق دين الإسلام بما نقله عن الباقلاني، قال: "لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف، أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر".(29) انتهى كلامه.
وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه الله- في تكفير الشاك في عابد الصنم ومن لم يكفره: "ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضـرورة". (30) انتهى كلامه.
وعلل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- تكفير من قال: (أن من شهد الشهادتين لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله)، فقال: "لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله، وإجماع المسلمين". (31) انتهى كلامه
وقال بعض أئمة الدعوة النجدية: "فإن الذي لا يكفر المشـركين غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشـركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم".(32) انتهى كلامهم.
ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى...
ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا...
• ( الْحَلَقَةُ الرابعة )
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
فهذه حلقة نتناول فيها الحديث -بعون الله تعالى- عن مسألتين:
الأولى: هل تكفير المشـركين كله على مرتبة واحدة أم على مراتب...
والثانية: نذكر فيها مراتب المتوقفين في تكفير المشـركين...
ونشـرع الآن في المسألة الأولى: هل تكفير المشـركين كله على مرتبة واحدة أم على مراتب؟
• والجواب: نص أهل العلم على أن التكفير حكم شـرعي له مراتب بحسب أمرين:
فالأول: قوة ثبوته في الشـرع؛ أي وضوح وظهور الدليل الشـرعي على كفر فلان من الناس، وهو ما يعرف بمعرفة الحكم...
والثاني: قوة ثبوته على المعين الذي وقع في الشـرك أو الكفر، وهو ما يسمى بمعرفة الحال، ويكون من خلال الرؤية أو السماع أو شهادة الشهود...
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "التكفير حكم شـرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدماء، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشـرعية، فتارة يدرك بيقين، وتارة يدرك بظن غالب، وتارة يتردد فيه، ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل ".(1) انتهى كلامه رحمه الله.
وذلك بخلاف من زعم أن جميع صور الكفر أو الشـرك على مرتبة واحدة؛ بحيث يستوي في إدراكها العالم والجاهل، ولا شك في بطلان هذا القول، ومخالفته لما قرره أهل العلم في هذا الشأن، بل ومخالفته للنصوص التي دلت على أن الكفر بعضه أشد من بعض.
قَالَ تَعَالَىٰ: {هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ} [آل عمران: 167]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا} [آل عمران: 90]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا} [التوبة: 97].
أما المسألة الثانية: وهي مراتب المتوقفين في تكفير المشـركين...
فنقول: إن للمتوقفين في المشـركين مراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشـرعي، وظهور الكفر أو الشـرك...
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له، ويأمرون به الناس: كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر: فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لا يقبل خطه ولا شهادته، ولا يصلى خلفه". (2) انتهى كلامه رحمه الله.
فتأمل كلامه؛ كيف أنه جعل للمتوقف في هؤلاء الطواغيت أحوالا أقلها الفسق، وهذا يؤكد على أن للمتوقفين في المشـركين أحوالا ومراتب.
* وهذه المراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشـرعي، وظهور الكفر أو الشـرك بغض النظر عن شدته؛ فقد يكون الشـرك أشد في حال من الأحوال، ولكنه في الظهور أقل مما هو أخف منه شدة.
مثال ذلك: شـرك عباد الأصنام مع شـرك الجهمية؛ فالحكم بتكفير المتوقف في عباد الأصنام أقوى من الحكم بتكفير المتوقف في الجهمية؛ وذلك لأن عبادة الأصنام أشد ظهورا من التجهم، مع أن التجهم أشد شـركا.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "فإن المشـرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله... فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد، يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا؟ فداء التعطيل هذا الداء العضال الذي لا دواء له".(3)
وقال أيضا رحمه الله: "فشـرك عباد الأصنام والأوثان والشمس والقمر والكواكب خير من توحيد هؤلاء بكثير، فإنه شـرك في الإلهية مع إثبات صانع العالم وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات والجزئيات، وتوحيد هؤلاء تعطيل لربوبيته وإلهيته وسائر صفاته، وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشـرك، ولهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شـركا".(4) انتهى كلامه رحمه الله.
بناء على ما سبق؛ سنذكر مراتب المتوقفين في المشـركين أو الكفار بناء على ظهور الأدلة على كفرهم وشهرتها، معتمدين على نصوص أهل العلم في ذلك:
المرتبة الأولى- من توقف فيمن علم كفره بالضـرورة من دين أهل الملل، فمن ذلك:
أولا: من توقف في إبليس أو فرعون أو مدع الإلهية لنفسه أو لغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير من لم يكفر فرعون: "وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل؛ المسلمين واليهود والنصارى: أن فرعون من أكفر الخلق بـالله". (5) انتهى كلامه رحمه الله.
ثانيا: من توقف في عباد الأصنام، ولو انتسبوا للإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير من صحح عبادة الأصنام: "ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى؛ فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام".(6) انتهى كلامه.
وقال ابن الوزير الصنعاني رحمه الله: "ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره، ومن لم يكفره، ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضـرورة".(7) انتهى كلامه.
وحكم المتوقف في هذه المرتبة الكفر، ولا يعذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية.
المرتبة الثانية- من توقف فيمن علم كفرهم بالضـرورة من دين المسلمين خاصة؛ كمن توقف في اليهود والنصارى، أو كل من فارق دين الإسلام.
قال القاضـي عياض رحمه الله: "نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم".(8) انتهى كلامه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم بـاتفاق المسلمين". (9) انتهى كلامه.
وحكم المتوقف في هذه المرتبة الكفر، ولا يعذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية.
المرتبة الثالثة- من توقف فيمن ينتسب للإسلام ووقع في شـرك أو كفر مجمع على كفر من وقع فيه، وهؤلاء على مراتب:
الأول من المرتبة الثالثة: من لم يكن له تأويل؛ فإنه إما أن يقتصـر على تبيين الحال له، وإما أن يقتصـر على تبيين حكم الشـرع فيهم، وإما أن تبين له حالهم ويبين له حكم الشـرع فيهم، وهذا بناء على ظهور الشـرك وظهور حال المتوقف فيهم؛ فإن توقف بعد ذلك فهو كافر، وأما إن كان حالهم ظاهرا، وحكم الشـرع فيهم ظاهرا؛ فيحكم بكفر المتوقف من غير تبيين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من الباطنية: "ومن كان محسنا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم: عرف حالهم؛ فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم".(10) انتهى كلامه.
* فـانظر هنا كيف اقتصـر شيخ الإسلام في تكفير المتوقف في هذه الطائفة على تعريفه بحالهم.
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في بعض مرتدي زمانه: "فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم، بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد، فإنه كافر بإجماع العلماء على: أن من شك في كفر الكافر فهو كافر".(11) انتهى كلامه رحمه الله.
* نلاحظ هنا أن الشيخ سليمان اشترط تبيين الحكم الشـرعي للمتوقف قبل تكفيره.
وقال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله فيمن قال بخلق القرآن: "ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن كان جاهلا علم؛ فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر". (12) انتهى كلامه رحمه الله.
* في هذه الصورة اشترط أبو حاتم تعليم المتوقف قبل تكفيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحلولية: "ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر؛ كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشـركين".(13) انتهى كلامه.
* أما في هذه الصورة فقد اشترط تعريف الحال والحكم الشـرعي معا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "طائفة الدروز": "كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم". (14) انتهى كلامه.
* ونلاحظ في هذه الصورة أنه لم يشترط في تكفير المتوقف تبيين الحال، ولا تبيين الحكم؛ وذلك لظهور حال تلك الطائفة، وظهور الأدلة على كفرهم.
والقسم الثاني من المرتبة الثالثة: من كانت له أصول فاسدة فتأول؛ فيؤثر في الحكم عليه شدة ظهور كفر المعين أو الطائفة، ففي حال شدة ظهور الكفر يعتبر كافرا معاندا متسترا بتأويله، وفي حالات أخرى اختلف بين تفسيقه وتكفيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من الباطنية: "وأما من قال: (لكلامهم تأويل يوافق الشـريعة)؛ فإنه من رءوسهم وأئمتهم؛ فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى؛ فمن لم يكفر هؤلاء، وجعل لكلامهم تأويلا، كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد".(15)
وقال أيضا رحمه الله: "وعنه -أي الإمام أحمد- في تكفير من لا يكفر روايتان؛ -يعني في تكفير من لم يكفر الجهمية- أصحهما لا يكفر".(16) انتهى كلامه.
وقال الإمام البخاري رحمه الله: "نظرت في كلام اليهود، والنصارى، والمجوس، فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم -يعني الجهمية-، وإني لأستجهل من لا يكفرهم، إلا من لا يعرف كفرهم".(17) انتهى كلامه رحمه الله.
والظاهر من قول الإمام البخاري أنه يذهب إلى عدم تكفير المتوقف في الجهمية؛ كإحدى الروايتين عن أحمد.
وقال المرداوي رحمه الله: "وذكر ابن حامد في أصوله كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، وقال: "من لم يكفر من كفرناه فسق وهجر، وفي كفره وجهان"، والذي ذكره هو وغيره من رواة المروذي، وأبي طالب، ويعقوب، وغيرهم: أنه لا يكفر -إلى أن قال:- وقال في إنكار المعتزلة استخراج قلبه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسـراء وإعادته: في كفرهم به وجهان، بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله وأنه صفة له، وعلى من قال: لا أكفر من لا يكفر الجهمية".(18) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة -يعني الذين يفضلون عليا على سائر الصحابة بلا طعن فيهم- ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع -من هؤلاء وغيرهم- خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشـريعة". (19) انتهى كلامه رحمه الله.
والقسم الثالث من المرتبة الثالثة: من كانت له أصول صحيحة فتأول؛ كما جاء في خطأ بعض الصحابة رضي الله عنهم في تكفير بعض المرتدين؛ حيث بين الله تعالى خطأ من توقف، ولم يحكم عليهم بكفر.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشـركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: "كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فـــاستغفروا لهم"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97]، قال: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية، وأنه لا عذر لهم، قال: فخرجوا فلحقهم المشـركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} [العنكبوت: 10] الآية".(20)
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: "فأنزل الله هذه الآية، وبين فيها حكم هؤلاء المشـركين، وأنهم من أهل النار، مع تكلمهم بالإسلام".(21) انتهى كلامه.
وروي أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تكفير بعض المرتدين، فلما بين الله تعالى كفر هؤلاء القوم لم يأمر من توقف فيهم بتجديد إسلامه.
فقد قال الله تعالى:{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} [النساء: 88].
وصح في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: "نقتلهم"، وقال بعضهم: "لا".(22)
وصح عن مجاهد رحمه الله، أنه قال: "قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فـاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فـاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: "هم منافقون"، وقائل يقول: "هم مؤمنون"، فبين الله نفاقهم، فأمر بقتالهم".(23)
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شـيء، فنزلت: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} [النساء: 88] الآية". (24)
وقال الإمام الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى-: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} [النساء: 88] قال: "يعني بذلك: والله ردهم إلى أحكام أهل الشـرك في إباحة دمائهم، وسبي ذراريهم".(25) انتهى كلامه رحمه الله.
وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، حيث قال بعدما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة".(26) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال ابن أبي زَمَنِين رحمه الله -وهو من أئمة أهل السنة-: "هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فـرتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشـرك، فلقيهم المسلمون، فكانوا فيهم فئتين؛ أي فرقتين، فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشـركون مرتدون، وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة، فقال الله -تعالى-: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} [النساء: 88]".(27) انتهى كلامه رحمه الله.
ورجح طائفة من العلماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقف في تكفير مانعي الزكاة في بادئ أمرهم، ولما بين له أبو بكر رضي الله عنه كفرهم وافقه، ولم يستتبه على توقفه فيهم؛ فقد صح عن عمر رضي الله عنه، أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه في شأن "المرتدين": كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ».(28)
* والحكم في هذه الحال: أن المتوقف لا يكفر ابتداء، بل يحكم عليه بالخطأ، وهذا الحكم مبني على أن التكفير من الأحكام الشـرعية، وأن حكم المجتهد المخطئ فيه كحكم غيره ممن أخطأ في المسائل الشـرعية، فإذا بينت له الأدلة وانقطع تأويله ثم توقف بعد ذلك فهو كافر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة: هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه".(29) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: "ثم لو قدر أن أحدا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية، أو الجهال المقلدين لعباد القبور، أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذور، ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطأ، والإجماع في ذلك قطعي".(30) انتهى كلامه.
المرتبة الرابعة- من توقف فيمن وقع في كفر أو شـرك، وكان سبب توقفه غرضا شـرعيا مباحا، فمن ذلك:
1- من توقف فيمن وقع في نوع شـرك أو كفر مختلف في أنه مخرج من الملة؛ كترك الصلاة.
2- ومن ذلك من توقف فيمن انتسب للعلم الشـرعي بغرض الدفع عن تكفير علماء المسلمين.
وحكم المتوقف في هاتين الصورتين أنه مجتهد مأجور بإذن الله؛ إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطئوا هو من أحق الأغراض الشـرعية؛ حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له، ونصـرا لأخيه المسلم: لكان هذا غرضا شـرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد". (31) انتهى كلامه.
* وههنا سؤال مهم، وهو: أين مرتبة المتوقف في عباد القبور من هذه المراتب؟
• والجواب أن مرتبة المتوقف في القبورية تختلف بحسب ظهور الشـرك أو الاعتقاد في صاحب القبر، ولا شك أن منها ما يماثل عبادة الأصنام أو يزيد عليها، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما يقتصـر على الابتداع في الدين ولا يبلغ الشـرك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والمراتب في هذا الباب ثلاث:
إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصـرني على عدوي، ونحو ذلك فهذا هو الشـرك بالله...
* وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي؛ كما يفعله طائفة من الجهال المشـركين..
* وأعظم من ذلك: أن يسجد لقبره ويصلي إليه، ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص، والكعبة قبلة العوام..
* وأعظم من ذلك: أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول: (إن السفر إليه مرات يعدل حجة)، وغلاتهم يقولون: (الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة)، ونحو ذلك؛ فهذا شـرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه..
الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي، أو ادع لنا ربك، أو اسأل الله لنا؛ كما تقول النصارى لمريم وغيرها؛ فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة...
فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا: لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شـيء من مصائب الدنيا والدين؛ ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته؛ فإن ذلك في حياته لا يفضـي إلى الشـرك، وهذا يفضـي إلى الشـرك..
الثالثة: أن يقال: أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه".(32) انتهى كلامه رحمه الله.
ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى التوفيق والعون والسداد، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 101
الخميس 22 محرم 1439 هـ ...المزيد
في بيان مسائل منهجية
(3-4)
• تَكْفِيرُ الْمُشْـرِكِينَ
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
ففي هذه الحلقة نبدأ الحديث -بعون الله تعالى- عن تكفير المشـركين، وسنتكلم عن مسألتين:
المسألة الأولى: سنجيب فيها على سؤال: ما هي منزلة التكفير من الدين؟
المسألة الثانية: نذكر فيها العلة أو المناط أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشـركين.
وقبل الشـروع في ذلك نذكر بعض نصوص أهل العلم في كفر من لم يكفر الكافر...
قال أبو الحسين الملطي الشافعي -رحمه الله-: "جميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر". (1) انتهى كلامه.
وقال القاضـي عياض -رحمه الله: "نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك". (2) انتهى كلامه.
وقال النووي -رحمه الله-: "من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر". (3)
ونص الحجاوي -رحمه الله- على أن من "لم يكفر من دان بغير الإسلام؛ كالنصارى، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم... فهو كافر".(4) انتهى كلامه.
ونص البهوتي -رحمه الله- على تكفير من "لم يكفر من دان بغير دين الإسلام كأهل الكتاب، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم".(5)
وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "من لم يكفر المشـركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر إجماعا". ا.هـ(6)
انتهى كلامهم رحمهم الله.
ونشـرع الآن في بيان المسألة الأولى: وهي الإجابة على سؤال: ما هي منزلة التكفير من الدين؟
والجواب هو أن التكفير حكم شـرعي محض، لا مدخل للعقل فيه، ولا يدخل تحت مسائل ومعاني أصل الدين، والتي سبق وأن بيناها في الحلقة السابقة.
إذن تكفير المشـركين من واجبات الدين وليس من أصل الدين.
طيب ما الفرق؟
الفرق أن ما كان من أصل الدين، فإنه لا يعذر المرء فيه بجهل، ولا تشترط إقامة الحجة على تاركه أو تارك بعضه.
أما التكفير فهو حكم شـرعي قد يعذر فيه بالجهل والتأويل.
ثم إن التكفير ليس على مستوى واحد، بل له مراتب، فأعلاها ما هو معلوم من الدين بالضـرورة؛ كتكفير من كفرهم الله تعالى في كتابه على التعيين؛ كإبليس وفرعون وكل من دان بغير الإسلام؛ كاليهود والنصارى وعباد الأصنام.
وأدناها ما اختلف في تكفير مرتكبه؛ كتارك الصلاة وغير ذلك، وبينهما مراتب متفاوتة، وهو ما سوف نتناوله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
قلنا: إن التكفير من واجبات الدين، وأنه حكم شـرعي، وليس له مورد سوى الأدلة الشـرعية، ولا مدخل للعقل فيه، وقد تتابع أهل العلم على تقرير ذلك وتأكيده، وإليكم بعض أقوالهم:
قال القاضـي عياض -رحمه الله-: "فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشـرع، ولا مجال للعقل فيه".(7) انتهى كلامه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "التكفير حكم شـرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدماء، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشـرعية".(8)
وقال -رحمه الله-: "فإن الكفر والفسق أحكام شـرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل؛ فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما..-إلى أن قال: - فهذه المسائل كلها ثابتة بالشـرع".(9)
وقال -رحمه الله-: "الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة، وبالأدلة الشـرعية يميز بين المؤمن والكافر، لا بمجرد الأدلة العقلية". (10) انتهى كلامه.
وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- :
الكفر حق الله ثم رسوله
بالنص يثبت لا بقول فلان
من كان رب العالمين وعبده
قد كفراه فذاك ذو الكفران(11)
وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه الله: "أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا، ولا نزاع في ذلك".(12) انتهى كلامه
وعليه نقول: إن من جهل حكم الشـرع في أحد الكفار أو المشـركين أو إحدى طوائفهم: لا يكون حكمه كحكم من أشـرك، لأن الذي أشـرك نقض أصل الدين؛ كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وإنما حكمه كحكم كل من جهل شـريعة أو فريضة من فرائض الإسلام، فمن قامت عليه الحجة الرسالية في ذلك كفر، ومن لم تبلغه الحجة الرسالية في ذلك فليس بكافر، بخلاف من جهل التوحيد؛ الذي هو أصل الدين؛ فإنه كافر كفر جهل.
هذا وقد تتابع أهل العلم على تقرير الفرق بين الجهل بأصل الدين والجهل بالواجبات الشـرعية:
فقد نقل الإمام محمد بن نصـر المروزي عن طائفة من أهل الحديث قولهم: "ولما كان العلم بـالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر... إلى أن قالوا: وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافرا، وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا، والجهل بـالله في كل حال كفر، قبل الخبر وبعد الخبر". (13) انتهى كلامه -رحمه الله-
وأما صفة قيام الحجة وكيفية تحقيق هذا الشـرط قبل التكفير، فإن ذلك يختلف بحسب ظهور المسألة وخفائها، فقد تقوم الحجة بمجرد وجود المتوقف عن التكفير في مظنة العلم، بحيث يكون بتوقفه معرضا لا جاهلا، وبحيث لا يعذر إلا من كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، وقد تكون إقامة الحجة بتبيين النص الشـرعي الدال على كفر من فعل كذا أو قال كذا، ولا يكتفى بمجرد البلوغ العام للقرآن، وقد تكون إقامة الحجة بتبيين الدليل مع إزالة الشبهة والإجابة عن الدليل المعارض، وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة عند الحديث عن مراتب المتوقفين.
ويستدل على التفريق بين الجهل بالشـرائع والجهل بأصل الدين أو على أن تكفير المشـركين من الشـرائع ليس من أصل الدين بعدة من الأدلة، أذكر منها:
إن جميع الأنبياء عليهم السلام بدءوا أقوامهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شـريك له، ولو أن الجهل بأحكام التكفير كفر لما تأخر بيانها عن بيان أصل الدين لحظة واحدة.
ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين وأنه حكم شـرعي وليس من أصل الدين ما ثبت أن من الصحابة رضي الله عنهم، من توقف في تكفير قوم وقعوا في الردة، وسموهم مسلمين، ولما نزلت الآيات التي بينت كفر هؤلاء القوم لم يستتابوا من توقفهم، بينما ثبت أن أحد الصحابة وقع في الشـرك جاهلا، ومع ذلك كفره الصحابة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه، وهذا يدل على الفرق بين من وقع في الشـرك جاهلا، وبين من جهل الشـرائع.
فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشـركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: "كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فـــاستغفروا لهم"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97، 98]، قال: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية، وأنه لا عذر لهم، قال: فخرجوا فلحقهم المشـركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} [العنكبوت: ١٠] الْآيَةَ".(14)
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله : "فأنزل الله هذه الآية، وبين فيها حكم هؤلاء المشـركين، وأنهم من أهل النار مع تكلمهم بالإسلام".(15) انتهى كلامه.
وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: كنا نذكر بعض الأمر، وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته، فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، ولا تعد له».(16)
وقال ابن الوزير الصنعاني-رحمه الله- معلقا على هذا الحديث: "وهذا أمر بتجديد الإسلام".(17) انتهى كلامه.
وقال ابن العربي المالكي -رحمه الله- "فمن قال في الإسلام في يمينه واللات والعزى مؤكدا ليمينه بذلك على معنى التعظيم فيه: كافر حقيقة". ا.هـ(18)
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله- : "أخذ به -يعني حديث سعد -رضي الله عنه- طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شـرك، قالوا: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول لا إله إلا الله، فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك، وقال الجمهور: لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، لكنه من الشـرك الأصغر".(19) انتهى كلامه.
فلم يعذر- رضي الله عنه- في ذلك مع أنه حديث عهد بجاهلية..
ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين، وأنه حكم شـرعي وليس من أصل الدين الذي لا يعذر فيه أحد: ما روي أن الصحابة -رضي الله عنهم- اختلفوا في تكفير بعض المرتدين، فلما بين الله تعالى كفر هؤلاء القوم لم يأمر من توقف فيهم بتجديد إسلامه.
فقد قال الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا * وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 88 - 89]
وصح في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: "نقتلهم"، وقال بعضهم: "لا".(20)
وصح عن مجاهد -رحمه الله- أنه قال: "قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فـاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؛ ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فـاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: "هم منافقون"، وقائل يقول: "هم مؤمنون"، فبين الله نفاقهم، فأمر بقتالهم".(21)
وقد روي بهذا المعنى عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وصح بنحوه مرسلا عن عدة من التابعين وهم: عكرمة، والسدي، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي رحمهم الله.
وقال الإمام الطبري -رحمه الله- في تأويل قوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا { [النساء: ٨٨]، قال: "يعني بذلك: والله ردهم إلى أحكام أهل الشـرك في إباحة دمائهم، وسبي ذراريهم". (22) انتهى كلامه.
وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، حيث قال بعدما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة".(23) انتهى كلامه.
وقال ابن أبي زمنين -رحمه الله-: "هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فـارتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشـرك، فلقيهم المسلمون، فكانوا فيهم فئتين؛ أي فرقتين، فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشـركون مرتدون، وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة، فقال الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ}".(24) انْتَهَىٰ كَلَامُهُ رحمه الله.
ومن الأدلة أيضا: ما رجحه طائفة من العلماء أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- توقف في تكفير مانعي الزكاة في بادئ أمرهم، ولما بين له أبو بكر -رضي الله عنه- كفرهم وافقه، ولم يستتبه على توقفه فيهم.
فقد صح عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لأبي بكر -رضي الله عنه- في شأن "المرتدين" : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ».(25)
وقد توقف بعض أئمة السلف -في بادئ الأمر- كفر من قال بخلق القرآن، ومنهم توقف في كفر الجهمية على الرغم من شدته، فلم يكونوا بذلك كفارا، ولما تبين لهم الدليل على كفرهم لم يتوقفوا فيهم، ولم يجددوا إسلامهم لأجل ما سبق من توقفهم.
فعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: "سألت أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق، فقال: "كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [البقرة: 145]، وَقَوْلَهُ: {بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [البقرة: 120[" وقوله: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ } [النساء: 166]" .(26)
وعن ابن عمار الموصلي -رحمه الله- قال: "يقول لي ابن المديني: ما يمنعك أن تكفرهم؟! -يعني: الجهمية- قال: وكنت أنا أولا أمتنع أن أكفرهم حتى قال ابن المديني ما قال، فلما أجاب إلى المحنة، كتبت إليه كتابا أذكره الله، وأذكره ما قال لي في تكفيرهم".(27)
وبذلك نكون قد انتهينا من المسألة الأولى...
ونشـرع الآن في بيان المسألة الثانية: وهي ما هو المناط أو العلة أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشـركين.
الجواب: هو تكذيب الشـرائع وردها.
فبالنظر إلى نصوص أهل العلم في هذا الناقض يظهر جليا ما قرروه من أن مناط الكفر في المتوقف في الكافر يرجع إلى تكذيب الشـرائع وردها، لا من جهة انتقاض أصل الدين.
وقد تتابع أكثر أهل العلم على ذكر هذا المناط بناء على أن الكفر إنما يكون بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها، أو بإنكار المعلوم من الدين ضـرورة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضـرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها ونحو ذلك". ا.هـ(28)
* وإليكم بعض ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم الذين نصوا على مناط كفر المتوقف في الكافر:
فقد علل القاضـي عياض تكفير المتوقف في اليهود والنصارى ومن فارق دين الإسلام بما نقله عن الباقلاني، قال: "لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف، أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر".(29) انتهى كلامه.
وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه الله- في تكفير الشاك في عابد الصنم ومن لم يكفره: "ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضـرورة". (30) انتهى كلامه.
وعلل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- تكفير من قال: (أن من شهد الشهادتين لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله)، فقال: "لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله، وإجماع المسلمين". (31) انتهى كلامه
وقال بعض أئمة الدعوة النجدية: "فإن الذي لا يكفر المشـركين غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشـركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم".(32) انتهى كلامهم.
ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى...
ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا...
• ( الْحَلَقَةُ الرابعة )
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
فهذه حلقة نتناول فيها الحديث -بعون الله تعالى- عن مسألتين:
الأولى: هل تكفير المشـركين كله على مرتبة واحدة أم على مراتب...
والثانية: نذكر فيها مراتب المتوقفين في تكفير المشـركين...
ونشـرع الآن في المسألة الأولى: هل تكفير المشـركين كله على مرتبة واحدة أم على مراتب؟
• والجواب: نص أهل العلم على أن التكفير حكم شـرعي له مراتب بحسب أمرين:
فالأول: قوة ثبوته في الشـرع؛ أي وضوح وظهور الدليل الشـرعي على كفر فلان من الناس، وهو ما يعرف بمعرفة الحكم...
والثاني: قوة ثبوته على المعين الذي وقع في الشـرك أو الكفر، وهو ما يسمى بمعرفة الحال، ويكون من خلال الرؤية أو السماع أو شهادة الشهود...
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "التكفير حكم شـرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدماء، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشـرعية، فتارة يدرك بيقين، وتارة يدرك بظن غالب، وتارة يتردد فيه، ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل ".(1) انتهى كلامه رحمه الله.
وذلك بخلاف من زعم أن جميع صور الكفر أو الشـرك على مرتبة واحدة؛ بحيث يستوي في إدراكها العالم والجاهل، ولا شك في بطلان هذا القول، ومخالفته لما قرره أهل العلم في هذا الشأن، بل ومخالفته للنصوص التي دلت على أن الكفر بعضه أشد من بعض.
قَالَ تَعَالَىٰ: {هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ} [آل عمران: 167]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا} [آل عمران: 90]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا} [التوبة: 97].
أما المسألة الثانية: وهي مراتب المتوقفين في تكفير المشـركين...
فنقول: إن للمتوقفين في المشـركين مراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشـرعي، وظهور الكفر أو الشـرك...
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له، ويأمرون به الناس: كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر: فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لا يقبل خطه ولا شهادته، ولا يصلى خلفه". (2) انتهى كلامه رحمه الله.
فتأمل كلامه؛ كيف أنه جعل للمتوقف في هؤلاء الطواغيت أحوالا أقلها الفسق، وهذا يؤكد على أن للمتوقفين في المشـركين أحوالا ومراتب.
* وهذه المراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشـرعي، وظهور الكفر أو الشـرك بغض النظر عن شدته؛ فقد يكون الشـرك أشد في حال من الأحوال، ولكنه في الظهور أقل مما هو أخف منه شدة.
مثال ذلك: شـرك عباد الأصنام مع شـرك الجهمية؛ فالحكم بتكفير المتوقف في عباد الأصنام أقوى من الحكم بتكفير المتوقف في الجهمية؛ وذلك لأن عبادة الأصنام أشد ظهورا من التجهم، مع أن التجهم أشد شـركا.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "فإن المشـرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله... فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد، يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا؟ فداء التعطيل هذا الداء العضال الذي لا دواء له".(3)
وقال أيضا رحمه الله: "فشـرك عباد الأصنام والأوثان والشمس والقمر والكواكب خير من توحيد هؤلاء بكثير، فإنه شـرك في الإلهية مع إثبات صانع العالم وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات والجزئيات، وتوحيد هؤلاء تعطيل لربوبيته وإلهيته وسائر صفاته، وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشـرك، ولهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شـركا".(4) انتهى كلامه رحمه الله.
بناء على ما سبق؛ سنذكر مراتب المتوقفين في المشـركين أو الكفار بناء على ظهور الأدلة على كفرهم وشهرتها، معتمدين على نصوص أهل العلم في ذلك:
المرتبة الأولى- من توقف فيمن علم كفره بالضـرورة من دين أهل الملل، فمن ذلك:
أولا: من توقف في إبليس أو فرعون أو مدع الإلهية لنفسه أو لغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير من لم يكفر فرعون: "وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل؛ المسلمين واليهود والنصارى: أن فرعون من أكفر الخلق بـالله". (5) انتهى كلامه رحمه الله.
ثانيا: من توقف في عباد الأصنام، ولو انتسبوا للإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير من صحح عبادة الأصنام: "ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى؛ فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام".(6) انتهى كلامه.
وقال ابن الوزير الصنعاني رحمه الله: "ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره، ومن لم يكفره، ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضـرورة".(7) انتهى كلامه.
وحكم المتوقف في هذه المرتبة الكفر، ولا يعذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية.
المرتبة الثانية- من توقف فيمن علم كفرهم بالضـرورة من دين المسلمين خاصة؛ كمن توقف في اليهود والنصارى، أو كل من فارق دين الإسلام.
قال القاضـي عياض رحمه الله: "نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم".(8) انتهى كلامه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم بـاتفاق المسلمين". (9) انتهى كلامه.
وحكم المتوقف في هذه المرتبة الكفر، ولا يعذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية.
المرتبة الثالثة- من توقف فيمن ينتسب للإسلام ووقع في شـرك أو كفر مجمع على كفر من وقع فيه، وهؤلاء على مراتب:
الأول من المرتبة الثالثة: من لم يكن له تأويل؛ فإنه إما أن يقتصـر على تبيين الحال له، وإما أن يقتصـر على تبيين حكم الشـرع فيهم، وإما أن تبين له حالهم ويبين له حكم الشـرع فيهم، وهذا بناء على ظهور الشـرك وظهور حال المتوقف فيهم؛ فإن توقف بعد ذلك فهو كافر، وأما إن كان حالهم ظاهرا، وحكم الشـرع فيهم ظاهرا؛ فيحكم بكفر المتوقف من غير تبيين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من الباطنية: "ومن كان محسنا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم: عرف حالهم؛ فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم".(10) انتهى كلامه.
* فـانظر هنا كيف اقتصـر شيخ الإسلام في تكفير المتوقف في هذه الطائفة على تعريفه بحالهم.
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في بعض مرتدي زمانه: "فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم، بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد، فإنه كافر بإجماع العلماء على: أن من شك في كفر الكافر فهو كافر".(11) انتهى كلامه رحمه الله.
* نلاحظ هنا أن الشيخ سليمان اشترط تبيين الحكم الشـرعي للمتوقف قبل تكفيره.
وقال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله فيمن قال بخلق القرآن: "ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن كان جاهلا علم؛ فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر". (12) انتهى كلامه رحمه الله.
* في هذه الصورة اشترط أبو حاتم تعليم المتوقف قبل تكفيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحلولية: "ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر؛ كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشـركين".(13) انتهى كلامه.
* أما في هذه الصورة فقد اشترط تعريف الحال والحكم الشـرعي معا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "طائفة الدروز": "كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم". (14) انتهى كلامه.
* ونلاحظ في هذه الصورة أنه لم يشترط في تكفير المتوقف تبيين الحال، ولا تبيين الحكم؛ وذلك لظهور حال تلك الطائفة، وظهور الأدلة على كفرهم.
والقسم الثاني من المرتبة الثالثة: من كانت له أصول فاسدة فتأول؛ فيؤثر في الحكم عليه شدة ظهور كفر المعين أو الطائفة، ففي حال شدة ظهور الكفر يعتبر كافرا معاندا متسترا بتأويله، وفي حالات أخرى اختلف بين تفسيقه وتكفيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من الباطنية: "وأما من قال: (لكلامهم تأويل يوافق الشـريعة)؛ فإنه من رءوسهم وأئمتهم؛ فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى؛ فمن لم يكفر هؤلاء، وجعل لكلامهم تأويلا، كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد".(15)
وقال أيضا رحمه الله: "وعنه -أي الإمام أحمد- في تكفير من لا يكفر روايتان؛ -يعني في تكفير من لم يكفر الجهمية- أصحهما لا يكفر".(16) انتهى كلامه.
وقال الإمام البخاري رحمه الله: "نظرت في كلام اليهود، والنصارى، والمجوس، فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم -يعني الجهمية-، وإني لأستجهل من لا يكفرهم، إلا من لا يعرف كفرهم".(17) انتهى كلامه رحمه الله.
والظاهر من قول الإمام البخاري أنه يذهب إلى عدم تكفير المتوقف في الجهمية؛ كإحدى الروايتين عن أحمد.
وقال المرداوي رحمه الله: "وذكر ابن حامد في أصوله كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، وقال: "من لم يكفر من كفرناه فسق وهجر، وفي كفره وجهان"، والذي ذكره هو وغيره من رواة المروذي، وأبي طالب، ويعقوب، وغيرهم: أنه لا يكفر -إلى أن قال:- وقال في إنكار المعتزلة استخراج قلبه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسـراء وإعادته: في كفرهم به وجهان، بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله وأنه صفة له، وعلى من قال: لا أكفر من لا يكفر الجهمية".(18) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة -يعني الذين يفضلون عليا على سائر الصحابة بلا طعن فيهم- ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع -من هؤلاء وغيرهم- خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشـريعة". (19) انتهى كلامه رحمه الله.
والقسم الثالث من المرتبة الثالثة: من كانت له أصول صحيحة فتأول؛ كما جاء في خطأ بعض الصحابة رضي الله عنهم في تكفير بعض المرتدين؛ حيث بين الله تعالى خطأ من توقف، ولم يحكم عليهم بكفر.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشـركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: "كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فـــاستغفروا لهم"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97]، قال: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية، وأنه لا عذر لهم، قال: فخرجوا فلحقهم المشـركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} [العنكبوت: 10] الآية".(20)
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: "فأنزل الله هذه الآية، وبين فيها حكم هؤلاء المشـركين، وأنهم من أهل النار، مع تكلمهم بالإسلام".(21) انتهى كلامه.
وروي أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تكفير بعض المرتدين، فلما بين الله تعالى كفر هؤلاء القوم لم يأمر من توقف فيهم بتجديد إسلامه.
فقد قال الله تعالى:{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} [النساء: 88].
وصح في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: "نقتلهم"، وقال بعضهم: "لا".(22)
وصح عن مجاهد رحمه الله، أنه قال: "قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فـاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فـاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: "هم منافقون"، وقائل يقول: "هم مؤمنون"، فبين الله نفاقهم، فأمر بقتالهم".(23)
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شـيء، فنزلت: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} [النساء: 88] الآية". (24)
وقال الإمام الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى-: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} [النساء: 88] قال: "يعني بذلك: والله ردهم إلى أحكام أهل الشـرك في إباحة دمائهم، وسبي ذراريهم".(25) انتهى كلامه رحمه الله.
وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، حيث قال بعدما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة".(26) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال ابن أبي زَمَنِين رحمه الله -وهو من أئمة أهل السنة-: "هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فـرتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشـرك، فلقيهم المسلمون، فكانوا فيهم فئتين؛ أي فرقتين، فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشـركون مرتدون، وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة، فقال الله -تعالى-: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} [النساء: 88]".(27) انتهى كلامه رحمه الله.
ورجح طائفة من العلماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقف في تكفير مانعي الزكاة في بادئ أمرهم، ولما بين له أبو بكر رضي الله عنه كفرهم وافقه، ولم يستتبه على توقفه فيهم؛ فقد صح عن عمر رضي الله عنه، أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه في شأن "المرتدين": كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ».(28)
* والحكم في هذه الحال: أن المتوقف لا يكفر ابتداء، بل يحكم عليه بالخطأ، وهذا الحكم مبني على أن التكفير من الأحكام الشـرعية، وأن حكم المجتهد المخطئ فيه كحكم غيره ممن أخطأ في المسائل الشـرعية، فإذا بينت له الأدلة وانقطع تأويله ثم توقف بعد ذلك فهو كافر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة: هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه".(29) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: "ثم لو قدر أن أحدا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية، أو الجهال المقلدين لعباد القبور، أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذور، ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطأ، والإجماع في ذلك قطعي".(30) انتهى كلامه.
المرتبة الرابعة- من توقف فيمن وقع في كفر أو شـرك، وكان سبب توقفه غرضا شـرعيا مباحا، فمن ذلك:
1- من توقف فيمن وقع في نوع شـرك أو كفر مختلف في أنه مخرج من الملة؛ كترك الصلاة.
2- ومن ذلك من توقف فيمن انتسب للعلم الشـرعي بغرض الدفع عن تكفير علماء المسلمين.
وحكم المتوقف في هاتين الصورتين أنه مجتهد مأجور بإذن الله؛ إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطئوا هو من أحق الأغراض الشـرعية؛ حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له، ونصـرا لأخيه المسلم: لكان هذا غرضا شـرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد". (31) انتهى كلامه.
* وههنا سؤال مهم، وهو: أين مرتبة المتوقف في عباد القبور من هذه المراتب؟
• والجواب أن مرتبة المتوقف في القبورية تختلف بحسب ظهور الشـرك أو الاعتقاد في صاحب القبر، ولا شك أن منها ما يماثل عبادة الأصنام أو يزيد عليها، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما يقتصـر على الابتداع في الدين ولا يبلغ الشـرك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والمراتب في هذا الباب ثلاث:
إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصـرني على عدوي، ونحو ذلك فهذا هو الشـرك بالله...
* وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي؛ كما يفعله طائفة من الجهال المشـركين..
* وأعظم من ذلك: أن يسجد لقبره ويصلي إليه، ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص، والكعبة قبلة العوام..
* وأعظم من ذلك: أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول: (إن السفر إليه مرات يعدل حجة)، وغلاتهم يقولون: (الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة)، ونحو ذلك؛ فهذا شـرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه..
الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي، أو ادع لنا ربك، أو اسأل الله لنا؛ كما تقول النصارى لمريم وغيرها؛ فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة...
فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا: لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شـيء من مصائب الدنيا والدين؛ ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته؛ فإن ذلك في حياته لا يفضـي إلى الشـرك، وهذا يفضـي إلى الشـرك..
الثالثة: أن يقال: أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه".(32) انتهى كلامه رحمه الله.
ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى التوفيق والعون والسداد، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 101
الخميس 22 محرم 1439 هـ ...المزيد
سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية (3-4) • تَكْفِيرُ الْمُشْـرِكِينَ الحمد لله رب العالمين، ...
سلسلة علمية
في بيان مسائل منهجية
(3-4)
• تَكْفِيرُ الْمُشْـرِكِينَ
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
ففي هذه الحلقة نبدأ الحديث -بعون الله تعالى- عن تكفير المشـركين، وسنتكلم عن مسألتين:
المسألة الأولى: سنجيب فيها على سؤال: ما هي منزلة التكفير من الدين؟
المسألة الثانية: نذكر فيها العلة أو المناط أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشـركين.
وقبل الشـروع في ذلك نذكر بعض نصوص أهل العلم في كفر من لم يكفر الكافر...
قال أبو الحسين الملطي الشافعي -رحمه الله-: "جميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر". (1) انتهى كلامه.
وقال القاضـي عياض -رحمه الله: "نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك". (2) انتهى كلامه.
وقال النووي -رحمه الله-: "من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر". (3)
ونص الحجاوي -رحمه الله- على أن من "لم يكفر من دان بغير الإسلام؛ كالنصارى، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم... فهو كافر".(4) انتهى كلامه.
ونص البهوتي -رحمه الله- على تكفير من "لم يكفر من دان بغير دين الإسلام كأهل الكتاب، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم".(5)
وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "من لم يكفر المشـركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر إجماعا". ا.هـ(6)
انتهى كلامهم رحمهم الله.
ونشـرع الآن في بيان المسألة الأولى: وهي الإجابة على سؤال: ما هي منزلة التكفير من الدين؟
والجواب هو أن التكفير حكم شـرعي محض، لا مدخل للعقل فيه، ولا يدخل تحت مسائل ومعاني أصل الدين، والتي سبق وأن بيناها في الحلقة السابقة.
إذن تكفير المشـركين من واجبات الدين وليس من أصل الدين.
طيب ما الفرق؟
الفرق أن ما كان من أصل الدين، فإنه لا يعذر المرء فيه بجهل، ولا تشترط إقامة الحجة على تاركه أو تارك بعضه.
أما التكفير فهو حكم شـرعي قد يعذر فيه بالجهل والتأويل.
ثم إن التكفير ليس على مستوى واحد، بل له مراتب، فأعلاها ما هو معلوم من الدين بالضـرورة؛ كتكفير من كفرهم الله تعالى في كتابه على التعيين؛ كإبليس وفرعون وكل من دان بغير الإسلام؛ كاليهود والنصارى وعباد الأصنام.
وأدناها ما اختلف في تكفير مرتكبه؛ كتارك الصلاة وغير ذلك، وبينهما مراتب متفاوتة، وهو ما سوف نتناوله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
قلنا: إن التكفير من واجبات الدين، وأنه حكم شـرعي، وليس له مورد سوى الأدلة الشـرعية، ولا مدخل للعقل فيه، وقد تتابع أهل العلم على تقرير ذلك وتأكيده، وإليكم بعض أقوالهم:
قال القاضـي عياض -رحمه الله-: "فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشـرع، ولا مجال للعقل فيه".(7) انتهى كلامه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "التكفير حكم شـرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدماء، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشـرعية".(8)
وقال -رحمه الله-: "فإن الكفر والفسق أحكام شـرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل؛ فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما..-إلى أن قال: - فهذه المسائل كلها ثابتة بالشـرع".(9)
وقال -رحمه الله-: "الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة، وبالأدلة الشـرعية يميز بين المؤمن والكافر، لا بمجرد الأدلة العقلية". (10) انتهى كلامه.
وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- :
الكفر حق الله ثم رسوله
بالنص يثبت لا بقول فلان
من كان رب العالمين وعبده
قد كفراه فذاك ذو الكفران(11)
وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه الله: "أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا، ولا نزاع في ذلك".(12) انتهى كلامه
وعليه نقول: إن من جهل حكم الشـرع في أحد الكفار أو المشـركين أو إحدى طوائفهم: لا يكون حكمه كحكم من أشـرك، لأن الذي أشـرك نقض أصل الدين؛ كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وإنما حكمه كحكم كل من جهل شـريعة أو فريضة من فرائض الإسلام، فمن قامت عليه الحجة الرسالية في ذلك كفر، ومن لم تبلغه الحجة الرسالية في ذلك فليس بكافر، بخلاف من جهل التوحيد؛ الذي هو أصل الدين؛ فإنه كافر كفر جهل.
هذا وقد تتابع أهل العلم على تقرير الفرق بين الجهل بأصل الدين والجهل بالواجبات الشـرعية:
فقد نقل الإمام محمد بن نصـر المروزي عن طائفة من أهل الحديث قولهم: "ولما كان العلم بـالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر... إلى أن قالوا: وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافرا، وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا، والجهل بـالله في كل حال كفر، قبل الخبر وبعد الخبر". (13) انتهى كلامه -رحمه الله-
وأما صفة قيام الحجة وكيفية تحقيق هذا الشـرط قبل التكفير، فإن ذلك يختلف بحسب ظهور المسألة وخفائها، فقد تقوم الحجة بمجرد وجود المتوقف عن التكفير في مظنة العلم، بحيث يكون بتوقفه معرضا لا جاهلا، وبحيث لا يعذر إلا من كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، وقد تكون إقامة الحجة بتبيين النص الشـرعي الدال على كفر من فعل كذا أو قال كذا، ولا يكتفى بمجرد البلوغ العام للقرآن، وقد تكون إقامة الحجة بتبيين الدليل مع إزالة الشبهة والإجابة عن الدليل المعارض، وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة عند الحديث عن مراتب المتوقفين.
ويستدل على التفريق بين الجهل بالشـرائع والجهل بأصل الدين أو على أن تكفير المشـركين من الشـرائع ليس من أصل الدين بعدة من الأدلة، أذكر منها:
إن جميع الأنبياء عليهم السلام بدءوا أقوامهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شـريك له، ولو أن الجهل بأحكام التكفير كفر لما تأخر بيانها عن بيان أصل الدين لحظة واحدة.
ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين وأنه حكم شـرعي وليس من أصل الدين ما ثبت أن من الصحابة رضي الله عنهم، من توقف في تكفير قوم وقعوا في الردة، وسموهم مسلمين، ولما نزلت الآيات التي بينت كفر هؤلاء القوم لم يستتابوا من توقفهم، بينما ثبت أن أحد الصحابة وقع في الشـرك جاهلا، ومع ذلك كفره الصحابة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه، وهذا يدل على الفرق بين من وقع في الشـرك جاهلا، وبين من جهل الشـرائع.
فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشـركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: "كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فـــاستغفروا لهم"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97، 98]، قال: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية، وأنه لا عذر لهم، قال: فخرجوا فلحقهم المشـركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} [العنكبوت: ١٠] الْآيَةَ".(14)
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله : "فأنزل الله هذه الآية، وبين فيها حكم هؤلاء المشـركين، وأنهم من أهل النار مع تكلمهم بالإسلام".(15) انتهى كلامه.
وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: كنا نذكر بعض الأمر، وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته، فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، ولا تعد له».(16)
وقال ابن الوزير الصنعاني-رحمه الله- معلقا على هذا الحديث: "وهذا أمر بتجديد الإسلام".(17) انتهى كلامه.
وقال ابن العربي المالكي -رحمه الله- "فمن قال في الإسلام في يمينه واللات والعزى مؤكدا ليمينه بذلك على معنى التعظيم فيه: كافر حقيقة". ا.هـ(18)
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله- : "أخذ به -يعني حديث سعد -رضي الله عنه- طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شـرك، قالوا: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول لا إله إلا الله، فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك، وقال الجمهور: لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، لكنه من الشـرك الأصغر".(19) انتهى كلامه.
فلم يعذر- رضي الله عنه- في ذلك مع أنه حديث عهد بجاهلية..
ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين، وأنه حكم شـرعي وليس من أصل الدين الذي لا يعذر فيه أحد: ما روي أن الصحابة -رضي الله عنهم- اختلفوا في تكفير بعض المرتدين، فلما بين الله تعالى كفر هؤلاء القوم لم يأمر من توقف فيهم بتجديد إسلامه.
فقد قال الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا * وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 88 - 89]
وصح في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: "نقتلهم"، وقال بعضهم: "لا".(20)
وصح عن مجاهد -رحمه الله- أنه قال: "قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فـاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؛ ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فـاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: "هم منافقون"، وقائل يقول: "هم مؤمنون"، فبين الله نفاقهم، فأمر بقتالهم".(21)
وقد روي بهذا المعنى عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وصح بنحوه مرسلا عن عدة من التابعين وهم: عكرمة، والسدي، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي رحمهم الله.
وقال الإمام الطبري -رحمه الله- في تأويل قوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا { [النساء: ٨٨]، قال: "يعني بذلك: والله ردهم إلى أحكام أهل الشـرك في إباحة دمائهم، وسبي ذراريهم". (22) انتهى كلامه.
وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، حيث قال بعدما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة".(23) انتهى كلامه.
وقال ابن أبي زمنين -رحمه الله-: "هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فـارتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشـرك، فلقيهم المسلمون، فكانوا فيهم فئتين؛ أي فرقتين، فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشـركون مرتدون، وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة، فقال الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ}".(24) انْتَهَىٰ كَلَامُهُ رحمه الله.
ومن الأدلة أيضا: ما رجحه طائفة من العلماء أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- توقف في تكفير مانعي الزكاة في بادئ أمرهم، ولما بين له أبو بكر -رضي الله عنه- كفرهم وافقه، ولم يستتبه على توقفه فيهم.
فقد صح عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لأبي بكر -رضي الله عنه- في شأن "المرتدين" : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ».(25)
وقد توقف بعض أئمة السلف -في بادئ الأمر- كفر من قال بخلق القرآن، ومنهم توقف في كفر الجهمية على الرغم من شدته، فلم يكونوا بذلك كفارا، ولما تبين لهم الدليل على كفرهم لم يتوقفوا فيهم، ولم يجددوا إسلامهم لأجل ما سبق من توقفهم.
فعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: "سألت أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق، فقال: "كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [البقرة: 145]، وَقَوْلَهُ: {بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [البقرة: 120[" وقوله: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ } [النساء: 166]" .(26)
وعن ابن عمار الموصلي -رحمه الله- قال: "يقول لي ابن المديني: ما يمنعك أن تكفرهم؟! -يعني: الجهمية- قال: وكنت أنا أولا أمتنع أن أكفرهم حتى قال ابن المديني ما قال، فلما أجاب إلى المحنة، كتبت إليه كتابا أذكره الله، وأذكره ما قال لي في تكفيرهم".(27)
وبذلك نكون قد انتهينا من المسألة الأولى...
ونشـرع الآن في بيان المسألة الثانية: وهي ما هو المناط أو العلة أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشـركين.
الجواب: هو تكذيب الشـرائع وردها.
فبالنظر إلى نصوص أهل العلم في هذا الناقض يظهر جليا ما قرروه من أن مناط الكفر في المتوقف في الكافر يرجع إلى تكذيب الشـرائع وردها، لا من جهة انتقاض أصل الدين.
وقد تتابع أكثر أهل العلم على ذكر هذا المناط بناء على أن الكفر إنما يكون بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها، أو بإنكار المعلوم من الدين ضـرورة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضـرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها ونحو ذلك". ا.هـ(28)
* وإليكم بعض ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم الذين نصوا على مناط كفر المتوقف في الكافر:
فقد علل القاضـي عياض تكفير المتوقف في اليهود والنصارى ومن فارق دين الإسلام بما نقله عن الباقلاني، قال: "لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف، أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر".(29) انتهى كلامه.
وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه الله- في تكفير الشاك في عابد الصنم ومن لم يكفره: "ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضـرورة". (30) انتهى كلامه.
وعلل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- تكفير من قال: (أن من شهد الشهادتين لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله)، فقال: "لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله، وإجماع المسلمين". (31) انتهى كلامه
وقال بعض أئمة الدعوة النجدية: "فإن الذي لا يكفر المشـركين غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشـركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم".(32) انتهى كلامهم.
ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى...
ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا...
• ( الْحَلَقَةُ الرابعة )
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
فهذه حلقة نتناول فيها الحديث -بعون الله تعالى- عن مسألتين:
الأولى: هل تكفير المشـركين كله على مرتبة واحدة أم على مراتب...
والثانية: نذكر فيها مراتب المتوقفين في تكفير المشـركين...
ونشـرع الآن في المسألة الأولى: هل تكفير المشـركين كله على مرتبة واحدة أم على مراتب؟
• والجواب: نص أهل العلم على أن التكفير حكم شـرعي له مراتب بحسب أمرين:
فالأول: قوة ثبوته في الشـرع؛ أي وضوح وظهور الدليل الشـرعي على كفر فلان من الناس، وهو ما يعرف بمعرفة الحكم...
والثاني: قوة ثبوته على المعين الذي وقع في الشـرك أو الكفر، وهو ما يسمى بمعرفة الحال، ويكون من خلال الرؤية أو السماع أو شهادة الشهود...
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "التكفير حكم شـرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدماء، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشـرعية، فتارة يدرك بيقين، وتارة يدرك بظن غالب، وتارة يتردد فيه، ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل ".(1) انتهى كلامه رحمه الله.
وذلك بخلاف من زعم أن جميع صور الكفر أو الشـرك على مرتبة واحدة؛ بحيث يستوي في إدراكها العالم والجاهل، ولا شك في بطلان هذا القول، ومخالفته لما قرره أهل العلم في هذا الشأن، بل ومخالفته للنصوص التي دلت على أن الكفر بعضه أشد من بعض.
قَالَ تَعَالَىٰ: {هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ} [آل عمران: 167]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا} [آل عمران: 90]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا} [التوبة: 97].
أما المسألة الثانية: وهي مراتب المتوقفين في تكفير المشـركين...
فنقول: إن للمتوقفين في المشـركين مراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشـرعي، وظهور الكفر أو الشـرك...
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له، ويأمرون به الناس: كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر: فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لا يقبل خطه ولا شهادته، ولا يصلى خلفه". (2) انتهى كلامه رحمه الله.
فتأمل كلامه؛ كيف أنه جعل للمتوقف في هؤلاء الطواغيت أحوالا أقلها الفسق، وهذا يؤكد على أن للمتوقفين في المشـركين أحوالا ومراتب.
* وهذه المراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشـرعي، وظهور الكفر أو الشـرك بغض النظر عن شدته؛ فقد يكون الشـرك أشد في حال من الأحوال، ولكنه في الظهور أقل مما هو أخف منه شدة.
مثال ذلك: شـرك عباد الأصنام مع شـرك الجهمية؛ فالحكم بتكفير المتوقف في عباد الأصنام أقوى من الحكم بتكفير المتوقف في الجهمية؛ وذلك لأن عبادة الأصنام أشد ظهورا من التجهم، مع أن التجهم أشد شـركا.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "فإن المشـرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله... فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد، يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا؟ فداء التعطيل هذا الداء العضال الذي لا دواء له".(3)
وقال أيضا رحمه الله: "فشـرك عباد الأصنام والأوثان والشمس والقمر والكواكب خير من توحيد هؤلاء بكثير، فإنه شـرك في الإلهية مع إثبات صانع العالم وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات والجزئيات، وتوحيد هؤلاء تعطيل لربوبيته وإلهيته وسائر صفاته، وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشـرك، ولهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شـركا".(4) انتهى كلامه رحمه الله.
بناء على ما سبق؛ سنذكر مراتب المتوقفين في المشـركين أو الكفار بناء على ظهور الأدلة على كفرهم وشهرتها، معتمدين على نصوص أهل العلم في ذلك:
المرتبة الأولى- من توقف فيمن علم كفره بالضـرورة من دين أهل الملل، فمن ذلك:
أولا: من توقف في إبليس أو فرعون أو مدع الإلهية لنفسه أو لغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير من لم يكفر فرعون: "وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل؛ المسلمين واليهود والنصارى: أن فرعون من أكفر الخلق بـالله". (5) انتهى كلامه رحمه الله.
ثانيا: من توقف في عباد الأصنام، ولو انتسبوا للإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير من صحح عبادة الأصنام: "ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى؛ فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام".(6) انتهى كلامه.
وقال ابن الوزير الصنعاني رحمه الله: "ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره، ومن لم يكفره، ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضـرورة".(7) انتهى كلامه.
وحكم المتوقف في هذه المرتبة الكفر، ولا يعذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية.
المرتبة الثانية- من توقف فيمن علم كفرهم بالضـرورة من دين المسلمين خاصة؛ كمن توقف في اليهود والنصارى، أو كل من فارق دين الإسلام.
قال القاضـي عياض رحمه الله: "نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم".(8) انتهى كلامه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم بـاتفاق المسلمين". (9) انتهى كلامه.
وحكم المتوقف في هذه المرتبة الكفر، ولا يعذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية.
المرتبة الثالثة- من توقف فيمن ينتسب للإسلام ووقع في شـرك أو كفر مجمع على كفر من وقع فيه، وهؤلاء على مراتب:
الأول من المرتبة الثالثة: من لم يكن له تأويل؛ فإنه إما أن يقتصـر على تبيين الحال له، وإما أن يقتصـر على تبيين حكم الشـرع فيهم، وإما أن تبين له حالهم ويبين له حكم الشـرع فيهم، وهذا بناء على ظهور الشـرك وظهور حال المتوقف فيهم؛ فإن توقف بعد ذلك فهو كافر، وأما إن كان حالهم ظاهرا، وحكم الشـرع فيهم ظاهرا؛ فيحكم بكفر المتوقف من غير تبيين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من الباطنية: "ومن كان محسنا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم: عرف حالهم؛ فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم".(10) انتهى كلامه.
* فـانظر هنا كيف اقتصـر شيخ الإسلام في تكفير المتوقف في هذه الطائفة على تعريفه بحالهم.
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في بعض مرتدي زمانه: "فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم، بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد، فإنه كافر بإجماع العلماء على: أن من شك في كفر الكافر فهو كافر".(11) انتهى كلامه رحمه الله.
* نلاحظ هنا أن الشيخ سليمان اشترط تبيين الحكم الشـرعي للمتوقف قبل تكفيره.
وقال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله فيمن قال بخلق القرآن: "ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن كان جاهلا علم؛ فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر". (12) انتهى كلامه رحمه الله.
* في هذه الصورة اشترط أبو حاتم تعليم المتوقف قبل تكفيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحلولية: "ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر؛ كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشـركين".(13) انتهى كلامه.
* أما في هذه الصورة فقد اشترط تعريف الحال والحكم الشـرعي معا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "طائفة الدروز": "كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم". (14) انتهى كلامه.
* ونلاحظ في هذه الصورة أنه لم يشترط في تكفير المتوقف تبيين الحال، ولا تبيين الحكم؛ وذلك لظهور حال تلك الطائفة، وظهور الأدلة على كفرهم.
والقسم الثاني من المرتبة الثالثة: من كانت له أصول فاسدة فتأول؛ فيؤثر في الحكم عليه شدة ظهور كفر المعين أو الطائفة، ففي حال شدة ظهور الكفر يعتبر كافرا معاندا متسترا بتأويله، وفي حالات أخرى اختلف بين تفسيقه وتكفيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من الباطنية: "وأما من قال: (لكلامهم تأويل يوافق الشـريعة)؛ فإنه من رءوسهم وأئمتهم؛ فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى؛ فمن لم يكفر هؤلاء، وجعل لكلامهم تأويلا، كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد".(15)
وقال أيضا رحمه الله: "وعنه -أي الإمام أحمد- في تكفير من لا يكفر روايتان؛ -يعني في تكفير من لم يكفر الجهمية- أصحهما لا يكفر".(16) انتهى كلامه.
وقال الإمام البخاري رحمه الله: "نظرت في كلام اليهود، والنصارى، والمجوس، فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم -يعني الجهمية-، وإني لأستجهل من لا يكفرهم، إلا من لا يعرف كفرهم".(17) انتهى كلامه رحمه الله.
والظاهر من قول الإمام البخاري أنه يذهب إلى عدم تكفير المتوقف في الجهمية؛ كإحدى الروايتين عن أحمد.
وقال المرداوي رحمه الله: "وذكر ابن حامد في أصوله كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، وقال: "من لم يكفر من كفرناه فسق وهجر، وفي كفره وجهان"، والذي ذكره هو وغيره من رواة المروذي، وأبي طالب، ويعقوب، وغيرهم: أنه لا يكفر -إلى أن قال:- وقال في إنكار المعتزلة استخراج قلبه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسـراء وإعادته: في كفرهم به وجهان، بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله وأنه صفة له، وعلى من قال: لا أكفر من لا يكفر الجهمية".(18) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة -يعني الذين يفضلون عليا على سائر الصحابة بلا طعن فيهم- ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع -من هؤلاء وغيرهم- خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشـريعة". (19) انتهى كلامه رحمه الله.
والقسم الثالث من المرتبة الثالثة: من كانت له أصول صحيحة فتأول؛ كما جاء في خطأ بعض الصحابة رضي الله عنهم في تكفير بعض المرتدين؛ حيث بين الله تعالى خطأ من توقف، ولم يحكم عليهم بكفر.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشـركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: "كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فـــاستغفروا لهم"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97]، قال: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية، وأنه لا عذر لهم، قال: فخرجوا فلحقهم المشـركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} [العنكبوت: 10] الآية".(20)
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: "فأنزل الله هذه الآية، وبين فيها حكم هؤلاء المشـركين، وأنهم من أهل النار، مع تكلمهم بالإسلام".(21) انتهى كلامه.
وروي أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تكفير بعض المرتدين، فلما بين الله تعالى كفر هؤلاء القوم لم يأمر من توقف فيهم بتجديد إسلامه.
فقد قال الله تعالى:{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} [النساء: 88].
وصح في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: "نقتلهم"، وقال بعضهم: "لا".(22)
وصح عن مجاهد رحمه الله، أنه قال: "قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فـاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فـاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: "هم منافقون"، وقائل يقول: "هم مؤمنون"، فبين الله نفاقهم، فأمر بقتالهم".(23)
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شـيء، فنزلت: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} [النساء: 88] الآية". (24)
وقال الإمام الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى-: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} [النساء: 88] قال: "يعني بذلك: والله ردهم إلى أحكام أهل الشـرك في إباحة دمائهم، وسبي ذراريهم".(25) انتهى كلامه رحمه الله.
وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، حيث قال بعدما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة".(26) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال ابن أبي زَمَنِين رحمه الله -وهو من أئمة أهل السنة-: "هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فـرتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشـرك، فلقيهم المسلمون، فكانوا فيهم فئتين؛ أي فرقتين، فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشـركون مرتدون، وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة، فقال الله -تعالى-: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} [النساء: 88]".(27) انتهى كلامه رحمه الله.
ورجح طائفة من العلماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقف في تكفير مانعي الزكاة في بادئ أمرهم، ولما بين له أبو بكر رضي الله عنه كفرهم وافقه، ولم يستتبه على توقفه فيهم؛ فقد صح عن عمر رضي الله عنه، أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه في شأن "المرتدين": كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ».(28)
* والحكم في هذه الحال: أن المتوقف لا يكفر ابتداء، بل يحكم عليه بالخطأ، وهذا الحكم مبني على أن التكفير من الأحكام الشـرعية، وأن حكم المجتهد المخطئ فيه كحكم غيره ممن أخطأ في المسائل الشـرعية، فإذا بينت له الأدلة وانقطع تأويله ثم توقف بعد ذلك فهو كافر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة: هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه".(29) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: "ثم لو قدر أن أحدا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية، أو الجهال المقلدين لعباد القبور، أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذور، ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطأ، والإجماع في ذلك قطعي".(30) انتهى كلامه.
المرتبة الرابعة- من توقف فيمن وقع في كفر أو شـرك، وكان سبب توقفه غرضا شـرعيا مباحا، فمن ذلك:
1- من توقف فيمن وقع في نوع شـرك أو كفر مختلف في أنه مخرج من الملة؛ كترك الصلاة.
2- ومن ذلك من توقف فيمن انتسب للعلم الشـرعي بغرض الدفع عن تكفير علماء المسلمين.
وحكم المتوقف في هاتين الصورتين أنه مجتهد مأجور بإذن الله؛ إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطئوا هو من أحق الأغراض الشـرعية؛ حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له، ونصـرا لأخيه المسلم: لكان هذا غرضا شـرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد". (31) انتهى كلامه.
* وههنا سؤال مهم، وهو: أين مرتبة المتوقف في عباد القبور من هذه المراتب؟
• والجواب أن مرتبة المتوقف في القبورية تختلف بحسب ظهور الشـرك أو الاعتقاد في صاحب القبر، ولا شك أن منها ما يماثل عبادة الأصنام أو يزيد عليها، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما يقتصـر على الابتداع في الدين ولا يبلغ الشـرك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والمراتب في هذا الباب ثلاث:
إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصـرني على عدوي، ونحو ذلك فهذا هو الشـرك بالله...
* وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي؛ كما يفعله طائفة من الجهال المشـركين..
* وأعظم من ذلك: أن يسجد لقبره ويصلي إليه، ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص، والكعبة قبلة العوام..
* وأعظم من ذلك: أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول: (إن السفر إليه مرات يعدل حجة)، وغلاتهم يقولون: (الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة)، ونحو ذلك؛ فهذا شـرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه..
الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي، أو ادع لنا ربك، أو اسأل الله لنا؛ كما تقول النصارى لمريم وغيرها؛ فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة...
فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا: لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شـيء من مصائب الدنيا والدين؛ ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته؛ فإن ذلك في حياته لا يفضـي إلى الشـرك، وهذا يفضـي إلى الشـرك..
الثالثة: أن يقال: أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه".(32) انتهى كلامه رحمه الله.
ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى التوفيق والعون والسداد، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 101
الخميس 22 محرم 1439 هـ ...المزيد
في بيان مسائل منهجية
(3-4)
• تَكْفِيرُ الْمُشْـرِكِينَ
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
ففي هذه الحلقة نبدأ الحديث -بعون الله تعالى- عن تكفير المشـركين، وسنتكلم عن مسألتين:
المسألة الأولى: سنجيب فيها على سؤال: ما هي منزلة التكفير من الدين؟
المسألة الثانية: نذكر فيها العلة أو المناط أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشـركين.
وقبل الشـروع في ذلك نذكر بعض نصوص أهل العلم في كفر من لم يكفر الكافر...
قال أبو الحسين الملطي الشافعي -رحمه الله-: "جميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر". (1) انتهى كلامه.
وقال القاضـي عياض -رحمه الله: "نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك". (2) انتهى كلامه.
وقال النووي -رحمه الله-: "من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر". (3)
ونص الحجاوي -رحمه الله- على أن من "لم يكفر من دان بغير الإسلام؛ كالنصارى، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم... فهو كافر".(4) انتهى كلامه.
ونص البهوتي -رحمه الله- على تكفير من "لم يكفر من دان بغير دين الإسلام كأهل الكتاب، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم".(5)
وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "من لم يكفر المشـركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر إجماعا". ا.هـ(6)
انتهى كلامهم رحمهم الله.
ونشـرع الآن في بيان المسألة الأولى: وهي الإجابة على سؤال: ما هي منزلة التكفير من الدين؟
والجواب هو أن التكفير حكم شـرعي محض، لا مدخل للعقل فيه، ولا يدخل تحت مسائل ومعاني أصل الدين، والتي سبق وأن بيناها في الحلقة السابقة.
إذن تكفير المشـركين من واجبات الدين وليس من أصل الدين.
طيب ما الفرق؟
الفرق أن ما كان من أصل الدين، فإنه لا يعذر المرء فيه بجهل، ولا تشترط إقامة الحجة على تاركه أو تارك بعضه.
أما التكفير فهو حكم شـرعي قد يعذر فيه بالجهل والتأويل.
ثم إن التكفير ليس على مستوى واحد، بل له مراتب، فأعلاها ما هو معلوم من الدين بالضـرورة؛ كتكفير من كفرهم الله تعالى في كتابه على التعيين؛ كإبليس وفرعون وكل من دان بغير الإسلام؛ كاليهود والنصارى وعباد الأصنام.
وأدناها ما اختلف في تكفير مرتكبه؛ كتارك الصلاة وغير ذلك، وبينهما مراتب متفاوتة، وهو ما سوف نتناوله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
قلنا: إن التكفير من واجبات الدين، وأنه حكم شـرعي، وليس له مورد سوى الأدلة الشـرعية، ولا مدخل للعقل فيه، وقد تتابع أهل العلم على تقرير ذلك وتأكيده، وإليكم بعض أقوالهم:
قال القاضـي عياض -رحمه الله-: "فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشـرع، ولا مجال للعقل فيه".(7) انتهى كلامه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "التكفير حكم شـرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدماء، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشـرعية".(8)
وقال -رحمه الله-: "فإن الكفر والفسق أحكام شـرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل؛ فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما..-إلى أن قال: - فهذه المسائل كلها ثابتة بالشـرع".(9)
وقال -رحمه الله-: "الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة، وبالأدلة الشـرعية يميز بين المؤمن والكافر، لا بمجرد الأدلة العقلية". (10) انتهى كلامه.
وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- :
الكفر حق الله ثم رسوله
بالنص يثبت لا بقول فلان
من كان رب العالمين وعبده
قد كفراه فذاك ذو الكفران(11)
وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه الله: "أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا، ولا نزاع في ذلك".(12) انتهى كلامه
وعليه نقول: إن من جهل حكم الشـرع في أحد الكفار أو المشـركين أو إحدى طوائفهم: لا يكون حكمه كحكم من أشـرك، لأن الذي أشـرك نقض أصل الدين؛ كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وإنما حكمه كحكم كل من جهل شـريعة أو فريضة من فرائض الإسلام، فمن قامت عليه الحجة الرسالية في ذلك كفر، ومن لم تبلغه الحجة الرسالية في ذلك فليس بكافر، بخلاف من جهل التوحيد؛ الذي هو أصل الدين؛ فإنه كافر كفر جهل.
هذا وقد تتابع أهل العلم على تقرير الفرق بين الجهل بأصل الدين والجهل بالواجبات الشـرعية:
فقد نقل الإمام محمد بن نصـر المروزي عن طائفة من أهل الحديث قولهم: "ولما كان العلم بـالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر... إلى أن قالوا: وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافرا، وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا، والجهل بـالله في كل حال كفر، قبل الخبر وبعد الخبر". (13) انتهى كلامه -رحمه الله-
وأما صفة قيام الحجة وكيفية تحقيق هذا الشـرط قبل التكفير، فإن ذلك يختلف بحسب ظهور المسألة وخفائها، فقد تقوم الحجة بمجرد وجود المتوقف عن التكفير في مظنة العلم، بحيث يكون بتوقفه معرضا لا جاهلا، وبحيث لا يعذر إلا من كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، وقد تكون إقامة الحجة بتبيين النص الشـرعي الدال على كفر من فعل كذا أو قال كذا، ولا يكتفى بمجرد البلوغ العام للقرآن، وقد تكون إقامة الحجة بتبيين الدليل مع إزالة الشبهة والإجابة عن الدليل المعارض، وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة عند الحديث عن مراتب المتوقفين.
ويستدل على التفريق بين الجهل بالشـرائع والجهل بأصل الدين أو على أن تكفير المشـركين من الشـرائع ليس من أصل الدين بعدة من الأدلة، أذكر منها:
إن جميع الأنبياء عليهم السلام بدءوا أقوامهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شـريك له، ولو أن الجهل بأحكام التكفير كفر لما تأخر بيانها عن بيان أصل الدين لحظة واحدة.
ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين وأنه حكم شـرعي وليس من أصل الدين ما ثبت أن من الصحابة رضي الله عنهم، من توقف في تكفير قوم وقعوا في الردة، وسموهم مسلمين، ولما نزلت الآيات التي بينت كفر هؤلاء القوم لم يستتابوا من توقفهم، بينما ثبت أن أحد الصحابة وقع في الشـرك جاهلا، ومع ذلك كفره الصحابة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه، وهذا يدل على الفرق بين من وقع في الشـرك جاهلا، وبين من جهل الشـرائع.
فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشـركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: "كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فـــاستغفروا لهم"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97، 98]، قال: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية، وأنه لا عذر لهم، قال: فخرجوا فلحقهم المشـركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} [العنكبوت: ١٠] الْآيَةَ".(14)
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله : "فأنزل الله هذه الآية، وبين فيها حكم هؤلاء المشـركين، وأنهم من أهل النار مع تكلمهم بالإسلام".(15) انتهى كلامه.
وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: كنا نذكر بعض الأمر، وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته، فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، ولا تعد له».(16)
وقال ابن الوزير الصنعاني-رحمه الله- معلقا على هذا الحديث: "وهذا أمر بتجديد الإسلام".(17) انتهى كلامه.
وقال ابن العربي المالكي -رحمه الله- "فمن قال في الإسلام في يمينه واللات والعزى مؤكدا ليمينه بذلك على معنى التعظيم فيه: كافر حقيقة". ا.هـ(18)
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله- : "أخذ به -يعني حديث سعد -رضي الله عنه- طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شـرك، قالوا: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول لا إله إلا الله، فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك، وقال الجمهور: لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، لكنه من الشـرك الأصغر".(19) انتهى كلامه.
فلم يعذر- رضي الله عنه- في ذلك مع أنه حديث عهد بجاهلية..
ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين، وأنه حكم شـرعي وليس من أصل الدين الذي لا يعذر فيه أحد: ما روي أن الصحابة -رضي الله عنهم- اختلفوا في تكفير بعض المرتدين، فلما بين الله تعالى كفر هؤلاء القوم لم يأمر من توقف فيهم بتجديد إسلامه.
فقد قال الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا * وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 88 - 89]
وصح في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: "نقتلهم"، وقال بعضهم: "لا".(20)
وصح عن مجاهد -رحمه الله- أنه قال: "قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فـاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؛ ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فـاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: "هم منافقون"، وقائل يقول: "هم مؤمنون"، فبين الله نفاقهم، فأمر بقتالهم".(21)
وقد روي بهذا المعنى عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وصح بنحوه مرسلا عن عدة من التابعين وهم: عكرمة، والسدي، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي رحمهم الله.
وقال الإمام الطبري -رحمه الله- في تأويل قوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا { [النساء: ٨٨]، قال: "يعني بذلك: والله ردهم إلى أحكام أهل الشـرك في إباحة دمائهم، وسبي ذراريهم". (22) انتهى كلامه.
وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، حيث قال بعدما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة".(23) انتهى كلامه.
وقال ابن أبي زمنين -رحمه الله-: "هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فـارتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشـرك، فلقيهم المسلمون، فكانوا فيهم فئتين؛ أي فرقتين، فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشـركون مرتدون، وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة، فقال الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ}".(24) انْتَهَىٰ كَلَامُهُ رحمه الله.
ومن الأدلة أيضا: ما رجحه طائفة من العلماء أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- توقف في تكفير مانعي الزكاة في بادئ أمرهم، ولما بين له أبو بكر -رضي الله عنه- كفرهم وافقه، ولم يستتبه على توقفه فيهم.
فقد صح عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لأبي بكر -رضي الله عنه- في شأن "المرتدين" : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ».(25)
وقد توقف بعض أئمة السلف -في بادئ الأمر- كفر من قال بخلق القرآن، ومنهم توقف في كفر الجهمية على الرغم من شدته، فلم يكونوا بذلك كفارا، ولما تبين لهم الدليل على كفرهم لم يتوقفوا فيهم، ولم يجددوا إسلامهم لأجل ما سبق من توقفهم.
فعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: "سألت أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق، فقال: "كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [البقرة: 145]، وَقَوْلَهُ: {بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [البقرة: 120[" وقوله: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ } [النساء: 166]" .(26)
وعن ابن عمار الموصلي -رحمه الله- قال: "يقول لي ابن المديني: ما يمنعك أن تكفرهم؟! -يعني: الجهمية- قال: وكنت أنا أولا أمتنع أن أكفرهم حتى قال ابن المديني ما قال، فلما أجاب إلى المحنة، كتبت إليه كتابا أذكره الله، وأذكره ما قال لي في تكفيرهم".(27)
وبذلك نكون قد انتهينا من المسألة الأولى...
ونشـرع الآن في بيان المسألة الثانية: وهي ما هو المناط أو العلة أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشـركين.
الجواب: هو تكذيب الشـرائع وردها.
فبالنظر إلى نصوص أهل العلم في هذا الناقض يظهر جليا ما قرروه من أن مناط الكفر في المتوقف في الكافر يرجع إلى تكذيب الشـرائع وردها، لا من جهة انتقاض أصل الدين.
وقد تتابع أكثر أهل العلم على ذكر هذا المناط بناء على أن الكفر إنما يكون بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها، أو بإنكار المعلوم من الدين ضـرورة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضـرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها ونحو ذلك". ا.هـ(28)
* وإليكم بعض ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم الذين نصوا على مناط كفر المتوقف في الكافر:
فقد علل القاضـي عياض تكفير المتوقف في اليهود والنصارى ومن فارق دين الإسلام بما نقله عن الباقلاني، قال: "لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف، أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر".(29) انتهى كلامه.
وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه الله- في تكفير الشاك في عابد الصنم ومن لم يكفره: "ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضـرورة". (30) انتهى كلامه.
وعلل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- تكفير من قال: (أن من شهد الشهادتين لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله)، فقال: "لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله، وإجماع المسلمين". (31) انتهى كلامه
وقال بعض أئمة الدعوة النجدية: "فإن الذي لا يكفر المشـركين غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشـركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم".(32) انتهى كلامهم.
ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى...
ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا...
• ( الْحَلَقَةُ الرابعة )
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
فهذه حلقة نتناول فيها الحديث -بعون الله تعالى- عن مسألتين:
الأولى: هل تكفير المشـركين كله على مرتبة واحدة أم على مراتب...
والثانية: نذكر فيها مراتب المتوقفين في تكفير المشـركين...
ونشـرع الآن في المسألة الأولى: هل تكفير المشـركين كله على مرتبة واحدة أم على مراتب؟
• والجواب: نص أهل العلم على أن التكفير حكم شـرعي له مراتب بحسب أمرين:
فالأول: قوة ثبوته في الشـرع؛ أي وضوح وظهور الدليل الشـرعي على كفر فلان من الناس، وهو ما يعرف بمعرفة الحكم...
والثاني: قوة ثبوته على المعين الذي وقع في الشـرك أو الكفر، وهو ما يسمى بمعرفة الحال، ويكون من خلال الرؤية أو السماع أو شهادة الشهود...
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "التكفير حكم شـرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدماء، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشـرعية، فتارة يدرك بيقين، وتارة يدرك بظن غالب، وتارة يتردد فيه، ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل ".(1) انتهى كلامه رحمه الله.
وذلك بخلاف من زعم أن جميع صور الكفر أو الشـرك على مرتبة واحدة؛ بحيث يستوي في إدراكها العالم والجاهل، ولا شك في بطلان هذا القول، ومخالفته لما قرره أهل العلم في هذا الشأن، بل ومخالفته للنصوص التي دلت على أن الكفر بعضه أشد من بعض.
قَالَ تَعَالَىٰ: {هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ} [آل عمران: 167]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا} [آل عمران: 90]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا} [التوبة: 97].
أما المسألة الثانية: وهي مراتب المتوقفين في تكفير المشـركين...
فنقول: إن للمتوقفين في المشـركين مراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشـرعي، وظهور الكفر أو الشـرك...
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له، ويأمرون به الناس: كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر: فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لا يقبل خطه ولا شهادته، ولا يصلى خلفه". (2) انتهى كلامه رحمه الله.
فتأمل كلامه؛ كيف أنه جعل للمتوقف في هؤلاء الطواغيت أحوالا أقلها الفسق، وهذا يؤكد على أن للمتوقفين في المشـركين أحوالا ومراتب.
* وهذه المراتب يؤثر فيها قوة الدليل الشـرعي، وظهور الكفر أو الشـرك بغض النظر عن شدته؛ فقد يكون الشـرك أشد في حال من الأحوال، ولكنه في الظهور أقل مما هو أخف منه شدة.
مثال ذلك: شـرك عباد الأصنام مع شـرك الجهمية؛ فالحكم بتكفير المتوقف في عباد الأصنام أقوى من الحكم بتكفير المتوقف في الجهمية؛ وذلك لأن عبادة الأصنام أشد ظهورا من التجهم، مع أن التجهم أشد شـركا.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "فإن المشـرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله... فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد، يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا؟ فداء التعطيل هذا الداء العضال الذي لا دواء له".(3)
وقال أيضا رحمه الله: "فشـرك عباد الأصنام والأوثان والشمس والقمر والكواكب خير من توحيد هؤلاء بكثير، فإنه شـرك في الإلهية مع إثبات صانع العالم وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات والجزئيات، وتوحيد هؤلاء تعطيل لربوبيته وإلهيته وسائر صفاته، وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشـرك، ولهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شـركا".(4) انتهى كلامه رحمه الله.
بناء على ما سبق؛ سنذكر مراتب المتوقفين في المشـركين أو الكفار بناء على ظهور الأدلة على كفرهم وشهرتها، معتمدين على نصوص أهل العلم في ذلك:
المرتبة الأولى- من توقف فيمن علم كفره بالضـرورة من دين أهل الملل، فمن ذلك:
أولا: من توقف في إبليس أو فرعون أو مدع الإلهية لنفسه أو لغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير من لم يكفر فرعون: "وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل؛ المسلمين واليهود والنصارى: أن فرعون من أكفر الخلق بـالله". (5) انتهى كلامه رحمه الله.
ثانيا: من توقف في عباد الأصنام، ولو انتسبوا للإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير من صحح عبادة الأصنام: "ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى؛ فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام".(6) انتهى كلامه.
وقال ابن الوزير الصنعاني رحمه الله: "ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره، ومن لم يكفره، ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضـرورة".(7) انتهى كلامه.
وحكم المتوقف في هذه المرتبة الكفر، ولا يعذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية.
المرتبة الثانية- من توقف فيمن علم كفرهم بالضـرورة من دين المسلمين خاصة؛ كمن توقف في اليهود والنصارى، أو كل من فارق دين الإسلام.
قال القاضـي عياض رحمه الله: "نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم".(8) انتهى كلامه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم بـاتفاق المسلمين". (9) انتهى كلامه.
وحكم المتوقف في هذه المرتبة الكفر، ولا يعذر بالجهل في ذلك كل من بلغته الحجة الرسالية.
المرتبة الثالثة- من توقف فيمن ينتسب للإسلام ووقع في شـرك أو كفر مجمع على كفر من وقع فيه، وهؤلاء على مراتب:
الأول من المرتبة الثالثة: من لم يكن له تأويل؛ فإنه إما أن يقتصـر على تبيين الحال له، وإما أن يقتصـر على تبيين حكم الشـرع فيهم، وإما أن تبين له حالهم ويبين له حكم الشـرع فيهم، وهذا بناء على ظهور الشـرك وظهور حال المتوقف فيهم؛ فإن توقف بعد ذلك فهو كافر، وأما إن كان حالهم ظاهرا، وحكم الشـرع فيهم ظاهرا؛ فيحكم بكفر المتوقف من غير تبيين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من الباطنية: "ومن كان محسنا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم: عرف حالهم؛ فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم".(10) انتهى كلامه.
* فـانظر هنا كيف اقتصـر شيخ الإسلام في تكفير المتوقف في هذه الطائفة على تعريفه بحالهم.
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في بعض مرتدي زمانه: "فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم، بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد، فإنه كافر بإجماع العلماء على: أن من شك في كفر الكافر فهو كافر".(11) انتهى كلامه رحمه الله.
* نلاحظ هنا أن الشيخ سليمان اشترط تبيين الحكم الشـرعي للمتوقف قبل تكفيره.
وقال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله فيمن قال بخلق القرآن: "ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن كان جاهلا علم؛ فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر". (12) انتهى كلامه رحمه الله.
* في هذه الصورة اشترط أبو حاتم تعليم المتوقف قبل تكفيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحلولية: "ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر؛ كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشـركين".(13) انتهى كلامه.
* أما في هذه الصورة فقد اشترط تعريف الحال والحكم الشـرعي معا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "طائفة الدروز": "كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم". (14) انتهى كلامه.
* ونلاحظ في هذه الصورة أنه لم يشترط في تكفير المتوقف تبيين الحال، ولا تبيين الحكم؛ وذلك لظهور حال تلك الطائفة، وظهور الأدلة على كفرهم.
والقسم الثاني من المرتبة الثالثة: من كانت له أصول فاسدة فتأول؛ فيؤثر في الحكم عليه شدة ظهور كفر المعين أو الطائفة، ففي حال شدة ظهور الكفر يعتبر كافرا معاندا متسترا بتأويله، وفي حالات أخرى اختلف بين تفسيقه وتكفيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من الباطنية: "وأما من قال: (لكلامهم تأويل يوافق الشـريعة)؛ فإنه من رءوسهم وأئمتهم؛ فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى؛ فمن لم يكفر هؤلاء، وجعل لكلامهم تأويلا، كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد".(15)
وقال أيضا رحمه الله: "وعنه -أي الإمام أحمد- في تكفير من لا يكفر روايتان؛ -يعني في تكفير من لم يكفر الجهمية- أصحهما لا يكفر".(16) انتهى كلامه.
وقال الإمام البخاري رحمه الله: "نظرت في كلام اليهود، والنصارى، والمجوس، فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم -يعني الجهمية-، وإني لأستجهل من لا يكفرهم، إلا من لا يعرف كفرهم".(17) انتهى كلامه رحمه الله.
والظاهر من قول الإمام البخاري أنه يذهب إلى عدم تكفير المتوقف في الجهمية؛ كإحدى الروايتين عن أحمد.
وقال المرداوي رحمه الله: "وذكر ابن حامد في أصوله كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، وقال: "من لم يكفر من كفرناه فسق وهجر، وفي كفره وجهان"، والذي ذكره هو وغيره من رواة المروذي، وأبي طالب، ويعقوب، وغيرهم: أنه لا يكفر -إلى أن قال:- وقال في إنكار المعتزلة استخراج قلبه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسـراء وإعادته: في كفرهم به وجهان، بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله وأنه صفة له، وعلى من قال: لا أكفر من لا يكفر الجهمية".(18) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة -يعني الذين يفضلون عليا على سائر الصحابة بلا طعن فيهم- ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع -من هؤلاء وغيرهم- خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشـريعة". (19) انتهى كلامه رحمه الله.
والقسم الثالث من المرتبة الثالثة: من كانت له أصول صحيحة فتأول؛ كما جاء في خطأ بعض الصحابة رضي الله عنهم في تكفير بعض المرتدين؛ حيث بين الله تعالى خطأ من توقف، ولم يحكم عليهم بكفر.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشـركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: "كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فـــاستغفروا لهم"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97]، قال: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية، وأنه لا عذر لهم، قال: فخرجوا فلحقهم المشـركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} [العنكبوت: 10] الآية".(20)
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: "فأنزل الله هذه الآية، وبين فيها حكم هؤلاء المشـركين، وأنهم من أهل النار، مع تكلمهم بالإسلام".(21) انتهى كلامه.
وروي أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تكفير بعض المرتدين، فلما بين الله تعالى كفر هؤلاء القوم لم يأمر من توقف فيهم بتجديد إسلامه.
فقد قال الله تعالى:{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} [النساء: 88].
وصح في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: "نقتلهم"، وقال بعضهم: "لا".(22)
وصح عن مجاهد رحمه الله، أنه قال: "قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فـاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فـاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: "هم منافقون"، وقائل يقول: "هم مؤمنون"، فبين الله نفاقهم، فأمر بقتالهم".(23)
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شـيء، فنزلت: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} [النساء: 88] الآية". (24)
وقال الإمام الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى-: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} [النساء: 88] قال: "يعني بذلك: والله ردهم إلى أحكام أهل الشـرك في إباحة دمائهم، وسبي ذراريهم".(25) انتهى كلامه رحمه الله.
وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، حيث قال بعدما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة".(26) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال ابن أبي زَمَنِين رحمه الله -وهو من أئمة أهل السنة-: "هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا فـرتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشـرك، فلقيهم المسلمون، فكانوا فيهم فئتين؛ أي فرقتين، فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشـركون مرتدون، وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة، فقال الله -تعالى-: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} [النساء: 88]".(27) انتهى كلامه رحمه الله.
ورجح طائفة من العلماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقف في تكفير مانعي الزكاة في بادئ أمرهم، ولما بين له أبو بكر رضي الله عنه كفرهم وافقه، ولم يستتبه على توقفه فيهم؛ فقد صح عن عمر رضي الله عنه، أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه في شأن "المرتدين": كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ».(28)
* والحكم في هذه الحال: أن المتوقف لا يكفر ابتداء، بل يحكم عليه بالخطأ، وهذا الحكم مبني على أن التكفير من الأحكام الشـرعية، وأن حكم المجتهد المخطئ فيه كحكم غيره ممن أخطأ في المسائل الشـرعية، فإذا بينت له الأدلة وانقطع تأويله ثم توقف بعد ذلك فهو كافر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة: هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه".(29) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: "ثم لو قدر أن أحدا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية، أو الجهال المقلدين لعباد القبور، أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذور، ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطأ، والإجماع في ذلك قطعي".(30) انتهى كلامه.
المرتبة الرابعة- من توقف فيمن وقع في كفر أو شـرك، وكان سبب توقفه غرضا شـرعيا مباحا، فمن ذلك:
1- من توقف فيمن وقع في نوع شـرك أو كفر مختلف في أنه مخرج من الملة؛ كترك الصلاة.
2- ومن ذلك من توقف فيمن انتسب للعلم الشـرعي بغرض الدفع عن تكفير علماء المسلمين.
وحكم المتوقف في هاتين الصورتين أنه مجتهد مأجور بإذن الله؛ إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطئوا هو من أحق الأغراض الشـرعية؛ حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له، ونصـرا لأخيه المسلم: لكان هذا غرضا شـرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد". (31) انتهى كلامه.
* وههنا سؤال مهم، وهو: أين مرتبة المتوقف في عباد القبور من هذه المراتب؟
• والجواب أن مرتبة المتوقف في القبورية تختلف بحسب ظهور الشـرك أو الاعتقاد في صاحب القبر، ولا شك أن منها ما يماثل عبادة الأصنام أو يزيد عليها، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما يقتصـر على الابتداع في الدين ولا يبلغ الشـرك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والمراتب في هذا الباب ثلاث:
إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصـرني على عدوي، ونحو ذلك فهذا هو الشـرك بالله...
* وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي؛ كما يفعله طائفة من الجهال المشـركين..
* وأعظم من ذلك: أن يسجد لقبره ويصلي إليه، ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص، والكعبة قبلة العوام..
* وأعظم من ذلك: أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول: (إن السفر إليه مرات يعدل حجة)، وغلاتهم يقولون: (الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة)، ونحو ذلك؛ فهذا شـرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه..
الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي، أو ادع لنا ربك، أو اسأل الله لنا؛ كما تقول النصارى لمريم وغيرها؛ فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة...
فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا: لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شـيء من مصائب الدنيا والدين؛ ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته؛ فإن ذلك في حياته لا يفضـي إلى الشـرك، وهذا يفضـي إلى الشـرك..
الثالثة: أن يقال: أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه".(32) انتهى كلامه رحمه الله.
ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى التوفيق والعون والسداد، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 101
الخميس 22 محرم 1439 هـ ...المزيد
الدولة الإسلامية - صحيفة النبأ العدد 101 الافتتاحية: أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ ...
الدولة الإسلامية - صحيفة النبأ العدد 101
الافتتاحية:
أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
إن النَّاظر في حال الكفار اليوم بمختلف مللهم ونحلهم، يرى فيهم الكبر والعجب، والبطر والخيلاء، يصُّبون حِمم حقدهم على المسلمين، أينما وُجدوا، ولا يألون في ذلك جهدا، ولا يدَّخرون فيه وُسعا، يبذلون الغالي والنفيس لإطفاء نور الله، وردِّ المسلمين عن دينهم، حسِبوا أنهم على ذلك قادرون، وله منجزون، مصرِّحين للعالم أجمع بقولهم: "من أشد منا قوة"، قالوها وقد مُلئت قلوبهم تجبُّرا وعنادا، وكفرا وإلحادا، ظانِّين أنهم مُعجِزو الله، وأن لن يقدر عليهم أحد، {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} [فصلت: 15]، {أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ} [التوبة: 70]،{ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ} [غافر: 21].
إن الله الذي أهلك عادا وثمود، وفرعون وهامان وجنودهما، وكلَّ من قاتل الأنبياء وعادى الرُّسل، لن تُعجزه أمريكا وروسيا، ولا الروافض والنصيرية، ولا ملاحدة الأكراد ومرتدو الصحوات، بل ولا كفار الأرض مجتمعين، فإن إهلاكهم عليه يسير، وإنه عليهم لقدير، {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ} [الأنفال: 59]، كيف لا، وهم لا يشاؤون إلا أن يشاء، ولا يقدرون إلا أن يأذن، فإن طائراتهم تطير بقدر الله، وهو قادر على إسقاطها إن شاء، وإن سفنهم تجري بأمر الله، وهو قادر على إغراقها إن شاء، وإن آلياتهم تمشي بإذن الله، وهو قادر على تدميرها إن شاء، {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: 42].
وإن المسلمين إذا تيقنوا بأن الله للكافرين قاهر، ودينه عليهم ظاهر، وأن الله يبتليهم بالكافرين، ويبتلي الكافرين بهم، توكلوا على خالقهم حق التوكل، سألوه النصر وحده، وخاضوا غمار الحرب، حاديهم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك) [سنن الترمذي]، فإن الله ناصر جنده، ومعزُّ عباده، وهو قاهر أعدائه، {وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 147]، وإن من ظنُّوا غير ذلك فإنما {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} [آل عمران: 154]، {مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} [الحج: 15].
وإننا كلما اشتدت الكروب، وعظمت الخطوب، ازددنا يقينا بأن الله منجزنا ما وعدنا، وأن نصره لنا قد اقترب، وأن الله لن يخذلنا، وأنه جاعل لنا من هذا الضيق مخرجا، إنما هو الابتلاء الذي يُنقى به الصف، والامتحان الذي يخرج به الخبث، وإن الله قد ابتلى من كان قبلنا بما هو أشد، حتى إذا أذن بنزول النصر نزل، لم يمنعه عدد الكفار وعتادهم، ولا قوتهم وجبروتهم، {حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [يوسف: 110].
وإننا نعلن لأمم الكفر قاطبة، أننا اليوم بتنا من النصر أقرب من أي وقت مضى، فقد صقلتنا الشدائد، وخرج من صفوفنا الخبث، ونزداد في كل يوم من الله قربا وإليه التجاءً، وتزدادون منه بعدا وعنه نفورا، فما هي إلا مسألة وقت حتى تخور قواكم ويُكسر كبرياؤكم، {لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} [آل عمران: 196-197]، فأنتم تتربصون بنا أن تُفنينا حملتكم الأخيرة هذه، {وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ} [التوبة: 52]، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} [الشعراء: 227].
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 101
الخميس 22 محرم 1439 هـ ...المزيد
الافتتاحية:
أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
إن النَّاظر في حال الكفار اليوم بمختلف مللهم ونحلهم، يرى فيهم الكبر والعجب، والبطر والخيلاء، يصُّبون حِمم حقدهم على المسلمين، أينما وُجدوا، ولا يألون في ذلك جهدا، ولا يدَّخرون فيه وُسعا، يبذلون الغالي والنفيس لإطفاء نور الله، وردِّ المسلمين عن دينهم، حسِبوا أنهم على ذلك قادرون، وله منجزون، مصرِّحين للعالم أجمع بقولهم: "من أشد منا قوة"، قالوها وقد مُلئت قلوبهم تجبُّرا وعنادا، وكفرا وإلحادا، ظانِّين أنهم مُعجِزو الله، وأن لن يقدر عليهم أحد، {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} [فصلت: 15]، {أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ} [التوبة: 70]،{ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ} [غافر: 21].
إن الله الذي أهلك عادا وثمود، وفرعون وهامان وجنودهما، وكلَّ من قاتل الأنبياء وعادى الرُّسل، لن تُعجزه أمريكا وروسيا، ولا الروافض والنصيرية، ولا ملاحدة الأكراد ومرتدو الصحوات، بل ولا كفار الأرض مجتمعين، فإن إهلاكهم عليه يسير، وإنه عليهم لقدير، {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ} [الأنفال: 59]، كيف لا، وهم لا يشاؤون إلا أن يشاء، ولا يقدرون إلا أن يأذن، فإن طائراتهم تطير بقدر الله، وهو قادر على إسقاطها إن شاء، وإن سفنهم تجري بأمر الله، وهو قادر على إغراقها إن شاء، وإن آلياتهم تمشي بإذن الله، وهو قادر على تدميرها إن شاء، {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: 42].
وإن المسلمين إذا تيقنوا بأن الله للكافرين قاهر، ودينه عليهم ظاهر، وأن الله يبتليهم بالكافرين، ويبتلي الكافرين بهم، توكلوا على خالقهم حق التوكل، سألوه النصر وحده، وخاضوا غمار الحرب، حاديهم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك) [سنن الترمذي]، فإن الله ناصر جنده، ومعزُّ عباده، وهو قاهر أعدائه، {وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 147]، وإن من ظنُّوا غير ذلك فإنما {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} [آل عمران: 154]، {مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} [الحج: 15].
وإننا كلما اشتدت الكروب، وعظمت الخطوب، ازددنا يقينا بأن الله منجزنا ما وعدنا، وأن نصره لنا قد اقترب، وأن الله لن يخذلنا، وأنه جاعل لنا من هذا الضيق مخرجا، إنما هو الابتلاء الذي يُنقى به الصف، والامتحان الذي يخرج به الخبث، وإن الله قد ابتلى من كان قبلنا بما هو أشد، حتى إذا أذن بنزول النصر نزل، لم يمنعه عدد الكفار وعتادهم، ولا قوتهم وجبروتهم، {حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [يوسف: 110].
وإننا نعلن لأمم الكفر قاطبة، أننا اليوم بتنا من النصر أقرب من أي وقت مضى، فقد صقلتنا الشدائد، وخرج من صفوفنا الخبث، ونزداد في كل يوم من الله قربا وإليه التجاءً، وتزدادون منه بعدا وعنه نفورا، فما هي إلا مسألة وقت حتى تخور قواكم ويُكسر كبرياؤكم، {لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} [آل عمران: 196-197]، فأنتم تتربصون بنا أن تُفنينا حملتكم الأخيرة هذه، {وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ} [التوبة: 52]، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} [الشعراء: 227].
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 101
الخميس 22 محرم 1439 هـ ...المزيد
الدولة الإسلامية - صحيفة النبأ العدد 101 الافتتاحية: أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ ...
الدولة الإسلامية - صحيفة النبأ العدد 101
الافتتاحية:
أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
إن النَّاظر في حال الكفار اليوم بمختلف مللهم ونحلهم، يرى فيهم الكبر والعجب، والبطر والخيلاء، يصُّبون حِمم حقدهم على المسلمين، أينما وُجدوا، ولا يألون في ذلك جهدا، ولا يدَّخرون فيه وُسعا، يبذلون الغالي والنفيس لإطفاء نور الله، وردِّ المسلمين عن دينهم، حسِبوا أنهم على ذلك قادرون، وله منجزون، مصرِّحين للعالم أجمع بقولهم: "من أشد منا قوة"، قالوها وقد مُلئت قلوبهم تجبُّرا وعنادا، وكفرا وإلحادا، ظانِّين أنهم مُعجِزو الله، وأن لن يقدر عليهم أحد، {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} [فصلت: 15]، {أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ} [التوبة: 70]،{ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ} [غافر: 21].
إن الله الذي أهلك عادا وثمود، وفرعون وهامان وجنودهما، وكلَّ من قاتل الأنبياء وعادى الرُّسل، لن تُعجزه أمريكا وروسيا، ولا الروافض والنصيرية، ولا ملاحدة الأكراد ومرتدو الصحوات، بل ولا كفار الأرض مجتمعين، فإن إهلاكهم عليه يسير، وإنه عليهم لقدير، {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ} [الأنفال: 59]، كيف لا، وهم لا يشاؤون إلا أن يشاء، ولا يقدرون إلا أن يأذن، فإن طائراتهم تطير بقدر الله، وهو قادر على إسقاطها إن شاء، وإن سفنهم تجري بأمر الله، وهو قادر على إغراقها إن شاء، وإن آلياتهم تمشي بإذن الله، وهو قادر على تدميرها إن شاء، {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: 42].
وإن المسلمين إذا تيقنوا بأن الله للكافرين قاهر، ودينه عليهم ظاهر، وأن الله يبتليهم بالكافرين، ويبتلي الكافرين بهم، توكلوا على خالقهم حق التوكل، سألوه النصر وحده، وخاضوا غمار الحرب، حاديهم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك) [سنن الترمذي]، فإن الله ناصر جنده، ومعزُّ عباده، وهو قاهر أعدائه، {وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 147]، وإن من ظنُّوا غير ذلك فإنما {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} [آل عمران: 154]، {مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} [الحج: 15].
وإننا كلما اشتدت الكروب، وعظمت الخطوب، ازددنا يقينا بأن الله منجزنا ما وعدنا، وأن نصره لنا قد اقترب، وأن الله لن يخذلنا، وأنه جاعل لنا من هذا الضيق مخرجا، إنما هو الابتلاء الذي يُنقى به الصف، والامتحان الذي يخرج به الخبث، وإن الله قد ابتلى من كان قبلنا بما هو أشد، حتى إذا أذن بنزول النصر نزل، لم يمنعه عدد الكفار وعتادهم، ولا قوتهم وجبروتهم، {حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [يوسف: 110].
وإننا نعلن لأمم الكفر قاطبة، أننا اليوم بتنا من النصر أقرب من أي وقت مضى، فقد صقلتنا الشدائد، وخرج من صفوفنا الخبث، ونزداد في كل يوم من الله قربا وإليه التجاءً، وتزدادون منه بعدا وعنه نفورا، فما هي إلا مسألة وقت حتى تخور قواكم ويُكسر كبرياؤكم، {لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} [آل عمران: 196-197]، فأنتم تتربصون بنا أن تُفنينا حملتكم الأخيرة هذه، {وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ} [التوبة: 52]، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} [الشعراء: 227].
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 101
الخميس 22 محرم 1439 هـ ...المزيد
الافتتاحية:
أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
إن النَّاظر في حال الكفار اليوم بمختلف مللهم ونحلهم، يرى فيهم الكبر والعجب، والبطر والخيلاء، يصُّبون حِمم حقدهم على المسلمين، أينما وُجدوا، ولا يألون في ذلك جهدا، ولا يدَّخرون فيه وُسعا، يبذلون الغالي والنفيس لإطفاء نور الله، وردِّ المسلمين عن دينهم، حسِبوا أنهم على ذلك قادرون، وله منجزون، مصرِّحين للعالم أجمع بقولهم: "من أشد منا قوة"، قالوها وقد مُلئت قلوبهم تجبُّرا وعنادا، وكفرا وإلحادا، ظانِّين أنهم مُعجِزو الله، وأن لن يقدر عليهم أحد، {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} [فصلت: 15]، {أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ} [التوبة: 70]،{ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ} [غافر: 21].
إن الله الذي أهلك عادا وثمود، وفرعون وهامان وجنودهما، وكلَّ من قاتل الأنبياء وعادى الرُّسل، لن تُعجزه أمريكا وروسيا، ولا الروافض والنصيرية، ولا ملاحدة الأكراد ومرتدو الصحوات، بل ولا كفار الأرض مجتمعين، فإن إهلاكهم عليه يسير، وإنه عليهم لقدير، {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ} [الأنفال: 59]، كيف لا، وهم لا يشاؤون إلا أن يشاء، ولا يقدرون إلا أن يأذن، فإن طائراتهم تطير بقدر الله، وهو قادر على إسقاطها إن شاء، وإن سفنهم تجري بأمر الله، وهو قادر على إغراقها إن شاء، وإن آلياتهم تمشي بإذن الله، وهو قادر على تدميرها إن شاء، {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: 42].
وإن المسلمين إذا تيقنوا بأن الله للكافرين قاهر، ودينه عليهم ظاهر، وأن الله يبتليهم بالكافرين، ويبتلي الكافرين بهم، توكلوا على خالقهم حق التوكل، سألوه النصر وحده، وخاضوا غمار الحرب، حاديهم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك) [سنن الترمذي]، فإن الله ناصر جنده، ومعزُّ عباده، وهو قاهر أعدائه، {وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 147]، وإن من ظنُّوا غير ذلك فإنما {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} [آل عمران: 154]، {مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} [الحج: 15].
وإننا كلما اشتدت الكروب، وعظمت الخطوب، ازددنا يقينا بأن الله منجزنا ما وعدنا، وأن نصره لنا قد اقترب، وأن الله لن يخذلنا، وأنه جاعل لنا من هذا الضيق مخرجا، إنما هو الابتلاء الذي يُنقى به الصف، والامتحان الذي يخرج به الخبث، وإن الله قد ابتلى من كان قبلنا بما هو أشد، حتى إذا أذن بنزول النصر نزل، لم يمنعه عدد الكفار وعتادهم، ولا قوتهم وجبروتهم، {حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [يوسف: 110].
وإننا نعلن لأمم الكفر قاطبة، أننا اليوم بتنا من النصر أقرب من أي وقت مضى، فقد صقلتنا الشدائد، وخرج من صفوفنا الخبث، ونزداد في كل يوم من الله قربا وإليه التجاءً، وتزدادون منه بعدا وعنه نفورا، فما هي إلا مسألة وقت حتى تخور قواكم ويُكسر كبرياؤكم، {لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} [آل عمران: 196-197]، فأنتم تتربصون بنا أن تُفنينا حملتكم الأخيرة هذه، {وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ} [التوبة: 52]، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} [الشعراء: 227].
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 101
الخميس 22 محرم 1439 هـ ...المزيد
السلسلة العلمية المنهجية 2 (أصل الدين) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا ...
السلسلة العلمية المنهجية 2
(أصل الدين)
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
ففي هذه الحلقة سنتناول الحديث عن أصل الدين، وهو موضوع في غاية الأهمية؛ وذلك لأنه لا يصح إيمان أحد إلا إذا أتى به.
• فما هو أصل الدين؟
أصل الدين هو الإقرار بالله، وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه.
أربعة أمور ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإبراهيم وموسى قاما بأصل الدين؛ الذي هو الإقرار بالله، وعبادته وحده لا شـريك له، ومخاصمة من كفر بالله".([1]) انتهى كلامه.
"والبراءة ممن أشرك به سبحانه" هو ما عبَّر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بقوله: "ومخاصمة من كفر بالله"، فكلا العبارتين معناهما واحد: مخاصمة المشـركين والبراءة منهم.
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل الدين أن يكون الحب لله، والبغض لله، والموالاة لله، والمعاداة لله، والعبادة لله". ([2]) انتهى كلامه.
فنقول بناء على ما سبق: لو أن شخصا أتى بثلاثة أمور من أصل الدين ولم يأت بالرابع؛ كترك عبادة ما سوى الله تعالى، أو ترك البراءة ممن أشـرك به سبحانه، هل يصح إسلامه؟، الجواب: لا.
فماذا يسمى؟، يسمى مشـركا كافرا.
وهذا القدر الذي هو أصل الدين لا يعذر من لم يأت به أحد بلغ حد التكليف ولو كان جاهلا، سواء بلغته الحجة الرسالية أو لم تبلغه، أو بلفظ آخر سواء جاءه رسول أو لم يأته.
قال إمام المفسـرين ابن جرير الطبري رحمه الله بعد ذكره لشـيء من أصل الدين، قال: "لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف؛ كان ممَّن أتاه من الله تعالى رسول، أو لم يأته رسول، عاين من الخلق غيره، أو لم يعاين أحدا سوى نفسه".([3]) انتهى كلامه رحمه الله.
لم يعاين أحدا سوى نفسه؛ يعني لم ير إلا نفسه؛ كمن كان في جزيرة نائية ولم ير أحدا من الناس سوى نفسه.
نقول: فإذا جاءه رسول دخل في أصل الدين الإيمان به وبما جاء به على وجه الإجمال.
إذن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى الآن، وبما جاء به على وجه الإجمال يدخل في أصل الدين؛ لأن أصل الدين هو الشهادتان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أصل الدين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله". ([4]) انتهى كلامه رحمه الله.
• طيِّب ما معنى (الإقرار بالله)؟
يعني: الإيمان بوجوده تعالى، وأنه متصف بصفات الكمال، ومنزه عن النقائص والعيوب، وأنه سبحانه المتفرِّد بالخلق والأمر.
قال الله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]
والأمر منه ما هو كوني؛ أي أنه سبحانه يقول للشـيء كن فيكون، ومن الأمر ما هو شرعي؛ ويتمثل بتفرده سبحانه وتعالى بالتحليل والتحريم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله؛ فإن الله سبحانه في سورة الأنعام والأعراف عاب على المشـركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وأنهم شـرعوا من الدين ما لم يأذن به الله". ([5]) انتهى كلامه رحمه الله.
مرة ثانية: ما هو أصل الدين؟ هو الإقرار بالله، وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشـرك به سبحانه، شرحنا الإقرار بالله.
طيب، ما معنى: عبادته سبحانه وحده، وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه؟
معناه: توحيد الله، ومحبة التوحيد وتحسينه، وموالاة أهله، وتقبيح الشـرك، واجتنابه، ومخاصمة أهله.
قال ابن القيم رحمه الله: "واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشـرك معلوما بالعقل، مستقرا في الفطر، فلا وثوق بشـيء من قضايا العقل؛ فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات، وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر". ([6]) انتهى كلامه رحمه الله.
وموالاة أهله: هذا هو الولاء؛ موالاة المؤمنين ...، ومخاصمة أهله -يعني أهل الشـرك-: هذا هو البراء من المشركين ...
ومن هنا يتبيَّن أن الولاء والبراء يدخل في أصل الدين.
ولكن ههنا مسألة؛
وهي الفرق بين وجود العداوة للكافرين وبين إظهار العداوة، فالأول -وهو وجود العداوة- من أصل الدين، والثاني: وهو إظهار العداوة فمن واجبات الدين لا من أصله.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: "ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة؛ فالأول: يعذر به مع العجز والخوف، لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28]، والثاني: لا بد منه؛ لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب لله ورسوله تلازم كلي، لا ينفك عنه المؤمن". ([7]) انتهى كلامه.
أصل الدين كما قلنا: لا يُعذر بالجهل به أيُّ أحد؛ أي لا يصح إسلام من نقضه ولا يرتفع عنه اسم الكفر.
• لماذا لم يعتبر بجهل الرجل العاقل أو المرأة العاقلة في أصل الدين؟
لأنه مما علم وثبت بالميثاق وضرورة الفطرة والعقل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل الدين هو عبادة الله، الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواه، وهو الفطرة التي فطر عليها الناس". ([8]) انتهى كلامه.
وقال ابن القيم رحمه الله: "وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضـرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه". ([9]) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن هنا نعلم أن أصل الدين لا يشترط فيه إقامة الحجة للحكم بالكفر على من لم يأت به؛ أي نحكم على من لم يأت بأصل الدين بالكفر، سواء أقيمت عليه الحجة أم لم تقم.
ونؤكد على أنه لا عذر لأي أحد بالجهل في هذه المسائل، التي هي من أصل الدين؛ لأنها من العلوم الضرورية المستقرة في جميع الفطر والعقول، وبالتالي فمن انتقض أصل دينه فهو مشـرك، ولكن عذابه في الدنيا والآخرة متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من معرفتها؛ فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل". ([10]) انتهى كلامه رحمه الله.
سؤال: ما الذي يناقض أصل الدين؟
الجواب: الشـرك ...
حيث قلنا في تعريف أصل الدين: أنه الإقرار بالله وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه، إذن: الشرك بـالله يناقض أصل الدين وينافيه.
ومعنى الشـرك شـرعا: هو جعل الشـريك أو الند لله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته.
فمثال شـرك الربوبية: أن يجعل مع الله خالق أو رازق أو مدبر أو حاكم أو مشـرع.
ومثال الشـرك في الألوهية: السجود أوالدعاء أوالنذر أوالذبح لغير الله.
ومثال الشـرك في الأسماء والصفات: تعطيلها مثل نفي العلم والسمع والبصـر عن الله، أو تشبيهه سبحانه وتعالى بخلقه.
وكل هذا الشـرك لم يعذر فيه أحد من المشـركين بجهله؛ لأنه يناقض أصل الدين، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكم بكفر الأتباع والمقلدين، وحكم بكفر الأميين من أهل الكتاب مع جهلهم، وحكم بكفر جهلة مشـركي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "من مات مشـركا فهو في النار، وإن مات قبل البعثة؛ لأن المشـركين كانوا قد غيَّروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشـرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشـركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضـى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشـرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم". انتهى كلامه رحمه الله.
وأما الجهلة من المشـركين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من المنتسبين للإسلام وغيرهم فالأمر فيهم أشد؛ لأن غالب جهلهم جاء من جهة الإعراض عن رسالته صلى الله عليه وسلم، والإعراض بمجرده كفر، فكيف لو كان معه شـرك؟!
قال الشوكاني رحمه الله: "ومن وقع في الشرك جاهلا لم يعذر، لأن الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جهل فقد أتي من قبل نفسه؛ بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة، وإلا ففيهما البيان الواضح؛ كما قال سبحانه في القرآن: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً} [النحل: 89]، وكذلك السنة: قال أبو ذر رضي الله عنه: " توفي محمد صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه بين السماء والأرض إلا ذكر لنا منه علما"، أو كما قال رضي الله عنه؛ فمن جهل فبسبب إعراضه، ولا يعذر أحد بالإعراض". انتهى كلامه رحمه الله.
هذا وأدلة عدم عذر الجاهل في الشـرك والذي يناقض أصل الدين كثيرة.
منها قوله تعالى: {فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأعراف: 30].
قال الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة، إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة، باتخاذهم الشياطين نصـراء من دون الله وظهراء؛ جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق، وأن الصواب ما أتوه وركبوا.
وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فيركبها عنادا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد، وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية". ([11]) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن الأدلة على عدم عذر الجاهل في الشـرك: قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 103، 104].
قال الطبري رحمه الله: "وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته؛ وذلك أن الله -تعالى ذكره- أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه، كانوا مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم: أنهم بالله كفرة، وأن أعمالهم حابطة". ([12]) انتهى كلامه رحمه الله.
طيب: إذا حكمنا على شخص ما بالكفر والشـرك، ما الذي يترتب على ذلك؟
يترتب على حكمنا على أحد بالكفر والشـرك ولو كان جاهلا: قطع الموالاة الإيمانية بيننا وبينه حتى يتوب إلى الله تعالى، وعدم التناكح معه أو أكل ذبيحته، وكذا عدم الاستغفار له إن مات على ذلك، وأنه لا حظ له من الحقوق التي أوجبها الله للمسلمين، وغير ذلك من الأحكام.
وأما تعذيبه في الدنيا والآخرة فهذا متوقف على قيام الحجة الرسالية، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، ودليله قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، وقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
ونؤكد على: أن من وقع في الشـرك من هذه الأمة فهو مشـرك كافر أيضا، وإن كان مدعيا للإسلام ناطقا بالشهادتين.
قال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65].
وقال تعالى بعد ذكره لأنبيائه عليهم السلام: {ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 88].
وهذه الآيات من أقوى الأدلة على أن الإسلام يحبط بالشـرك، وأن من أشرك من هذه الأمة فهو كافر، وإن كان ناطقا بالشهادتين عاملا بشعائر الإسلام الأخرى.
ونختم بمسألتين:
الأولى: لو كان إنسان قائما بأصل الدين يعبد الله ولا يشـرك به شيئا، ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يجهل مصطلح أصل الدين.
بمعنى أنك لو سألته: ما هو أصل الدين تلعثم أو لم يحر جوابا، فلا يضـره ذلك؛ لقيامه بأصل الدين، إذ لا يضـره عدم معرفة ما اصطُلح عليه في هذه المسائل والمعاني.
والدليل على ما ذكرنا: ما جاء في الصحيحين -واللفظ للبخاري-: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معاذ)، قلت: لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: (هل تدري ما حق الله على العباد)، قلت: لا، قال: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشـركوا به شيئا).
فتصـريح معاذ رضي الله عنه بأنه يجهل حق الله على عباده لم يوقعه في الكفر أو الشرك؛ لأنه قائم بهذا الحق وإن لم يعلم الاصطلاح الشرعي الذي يدل على ذلك المعنى.
المسألة الثانية: أن إحدى المسائل التي ذكرنا أنها من أصل الدين قد يخفى على بعض طلبة العلم أنها من أصل الدين، وهي مسألة عداوة المشـركين، وموالاة المؤمنين؛ فيظن أنها من واجبات الدين لا من أصله، أو يتوقف فيها، فهذا لا يعد ناقضا لأصل الدين طالما أنه حقق البراءة من المشـركين، والموالاة للمؤمنين.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: "بحسب المسلم أن يعلم: أن الله افترض عليه عداوة المشـركين وعدم موالاتهم، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، ونفى الإيمان عمن يواد {مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22]، وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها، فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، إنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه، ومن عرف أن ذلك من معناها، أو من لازمها فهو حسن، وزيادة خير، ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته، لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شـر واختلاف، ووقوع فرقة بين المؤمنين، الذين قاموا بواجبات الإيمان، وجاهدوا في الله، وعادوا المشـركين، ووالوا المسلمين". ([13]) انتهى كلامه رحمه الله.
ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يجعلنا هداة مهديين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[1])) مجموع الفتاوى (16/203).
[2])) منهاج السنة النبوية (5/255).
[3])) التبصير في معالم الدين (ص126-132).
[4])) مجموع الفتاوى (1/10).
[5])) مجموع الفتاوى (20/357).
[6])) مدارج السالكين (3/455).
[7])) الدرر السنية (8/359).
[8])) مجموع الفتاوى (15/438).
[9])) مدارج السالكين (1/253).
[10])) طريق الهجرتين (ص414).
[11])) تفسير الطبري (12/388).
[12])) تفسير الطبري (18/128).
[13])) الدرر السنية (8/166).
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 100
الخميس 15 محرم 1439 هـ ...المزيد
(أصل الدين)
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
ففي هذه الحلقة سنتناول الحديث عن أصل الدين، وهو موضوع في غاية الأهمية؛ وذلك لأنه لا يصح إيمان أحد إلا إذا أتى به.
• فما هو أصل الدين؟
أصل الدين هو الإقرار بالله، وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه.
أربعة أمور ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإبراهيم وموسى قاما بأصل الدين؛ الذي هو الإقرار بالله، وعبادته وحده لا شـريك له، ومخاصمة من كفر بالله".([1]) انتهى كلامه.
"والبراءة ممن أشرك به سبحانه" هو ما عبَّر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بقوله: "ومخاصمة من كفر بالله"، فكلا العبارتين معناهما واحد: مخاصمة المشـركين والبراءة منهم.
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل الدين أن يكون الحب لله، والبغض لله، والموالاة لله، والمعاداة لله، والعبادة لله". ([2]) انتهى كلامه.
فنقول بناء على ما سبق: لو أن شخصا أتى بثلاثة أمور من أصل الدين ولم يأت بالرابع؛ كترك عبادة ما سوى الله تعالى، أو ترك البراءة ممن أشـرك به سبحانه، هل يصح إسلامه؟، الجواب: لا.
فماذا يسمى؟، يسمى مشـركا كافرا.
وهذا القدر الذي هو أصل الدين لا يعذر من لم يأت به أحد بلغ حد التكليف ولو كان جاهلا، سواء بلغته الحجة الرسالية أو لم تبلغه، أو بلفظ آخر سواء جاءه رسول أو لم يأته.
قال إمام المفسـرين ابن جرير الطبري رحمه الله بعد ذكره لشـيء من أصل الدين، قال: "لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف؛ كان ممَّن أتاه من الله تعالى رسول، أو لم يأته رسول، عاين من الخلق غيره، أو لم يعاين أحدا سوى نفسه".([3]) انتهى كلامه رحمه الله.
لم يعاين أحدا سوى نفسه؛ يعني لم ير إلا نفسه؛ كمن كان في جزيرة نائية ولم ير أحدا من الناس سوى نفسه.
نقول: فإذا جاءه رسول دخل في أصل الدين الإيمان به وبما جاء به على وجه الإجمال.
إذن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى الآن، وبما جاء به على وجه الإجمال يدخل في أصل الدين؛ لأن أصل الدين هو الشهادتان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أصل الدين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله". ([4]) انتهى كلامه رحمه الله.
• طيِّب ما معنى (الإقرار بالله)؟
يعني: الإيمان بوجوده تعالى، وأنه متصف بصفات الكمال، ومنزه عن النقائص والعيوب، وأنه سبحانه المتفرِّد بالخلق والأمر.
قال الله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]
والأمر منه ما هو كوني؛ أي أنه سبحانه يقول للشـيء كن فيكون، ومن الأمر ما هو شرعي؛ ويتمثل بتفرده سبحانه وتعالى بالتحليل والتحريم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله؛ فإن الله سبحانه في سورة الأنعام والأعراف عاب على المشـركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وأنهم شـرعوا من الدين ما لم يأذن به الله". ([5]) انتهى كلامه رحمه الله.
مرة ثانية: ما هو أصل الدين؟ هو الإقرار بالله، وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشـرك به سبحانه، شرحنا الإقرار بالله.
طيب، ما معنى: عبادته سبحانه وحده، وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه؟
معناه: توحيد الله، ومحبة التوحيد وتحسينه، وموالاة أهله، وتقبيح الشـرك، واجتنابه، ومخاصمة أهله.
قال ابن القيم رحمه الله: "واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشـرك معلوما بالعقل، مستقرا في الفطر، فلا وثوق بشـيء من قضايا العقل؛ فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات، وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر". ([6]) انتهى كلامه رحمه الله.
وموالاة أهله: هذا هو الولاء؛ موالاة المؤمنين ...، ومخاصمة أهله -يعني أهل الشـرك-: هذا هو البراء من المشركين ...
ومن هنا يتبيَّن أن الولاء والبراء يدخل في أصل الدين.
ولكن ههنا مسألة؛
وهي الفرق بين وجود العداوة للكافرين وبين إظهار العداوة، فالأول -وهو وجود العداوة- من أصل الدين، والثاني: وهو إظهار العداوة فمن واجبات الدين لا من أصله.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: "ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة؛ فالأول: يعذر به مع العجز والخوف، لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28]، والثاني: لا بد منه؛ لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب لله ورسوله تلازم كلي، لا ينفك عنه المؤمن". ([7]) انتهى كلامه.
أصل الدين كما قلنا: لا يُعذر بالجهل به أيُّ أحد؛ أي لا يصح إسلام من نقضه ولا يرتفع عنه اسم الكفر.
• لماذا لم يعتبر بجهل الرجل العاقل أو المرأة العاقلة في أصل الدين؟
لأنه مما علم وثبت بالميثاق وضرورة الفطرة والعقل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل الدين هو عبادة الله، الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواه، وهو الفطرة التي فطر عليها الناس". ([8]) انتهى كلامه.
وقال ابن القيم رحمه الله: "وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضـرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه". ([9]) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن هنا نعلم أن أصل الدين لا يشترط فيه إقامة الحجة للحكم بالكفر على من لم يأت به؛ أي نحكم على من لم يأت بأصل الدين بالكفر، سواء أقيمت عليه الحجة أم لم تقم.
ونؤكد على أنه لا عذر لأي أحد بالجهل في هذه المسائل، التي هي من أصل الدين؛ لأنها من العلوم الضرورية المستقرة في جميع الفطر والعقول، وبالتالي فمن انتقض أصل دينه فهو مشـرك، ولكن عذابه في الدنيا والآخرة متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من معرفتها؛ فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل". ([10]) انتهى كلامه رحمه الله.
سؤال: ما الذي يناقض أصل الدين؟
الجواب: الشـرك ...
حيث قلنا في تعريف أصل الدين: أنه الإقرار بالله وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه، إذن: الشرك بـالله يناقض أصل الدين وينافيه.
ومعنى الشـرك شـرعا: هو جعل الشـريك أو الند لله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته.
فمثال شـرك الربوبية: أن يجعل مع الله خالق أو رازق أو مدبر أو حاكم أو مشـرع.
ومثال الشـرك في الألوهية: السجود أوالدعاء أوالنذر أوالذبح لغير الله.
ومثال الشـرك في الأسماء والصفات: تعطيلها مثل نفي العلم والسمع والبصـر عن الله، أو تشبيهه سبحانه وتعالى بخلقه.
وكل هذا الشـرك لم يعذر فيه أحد من المشـركين بجهله؛ لأنه يناقض أصل الدين، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكم بكفر الأتباع والمقلدين، وحكم بكفر الأميين من أهل الكتاب مع جهلهم، وحكم بكفر جهلة مشـركي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "من مات مشـركا فهو في النار، وإن مات قبل البعثة؛ لأن المشـركين كانوا قد غيَّروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشـرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشـركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضـى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشـرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم". انتهى كلامه رحمه الله.
وأما الجهلة من المشـركين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من المنتسبين للإسلام وغيرهم فالأمر فيهم أشد؛ لأن غالب جهلهم جاء من جهة الإعراض عن رسالته صلى الله عليه وسلم، والإعراض بمجرده كفر، فكيف لو كان معه شـرك؟!
قال الشوكاني رحمه الله: "ومن وقع في الشرك جاهلا لم يعذر، لأن الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جهل فقد أتي من قبل نفسه؛ بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة، وإلا ففيهما البيان الواضح؛ كما قال سبحانه في القرآن: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً} [النحل: 89]، وكذلك السنة: قال أبو ذر رضي الله عنه: " توفي محمد صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه بين السماء والأرض إلا ذكر لنا منه علما"، أو كما قال رضي الله عنه؛ فمن جهل فبسبب إعراضه، ولا يعذر أحد بالإعراض". انتهى كلامه رحمه الله.
هذا وأدلة عدم عذر الجاهل في الشـرك والذي يناقض أصل الدين كثيرة.
منها قوله تعالى: {فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأعراف: 30].
قال الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة، إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة، باتخاذهم الشياطين نصـراء من دون الله وظهراء؛ جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق، وأن الصواب ما أتوه وركبوا.
وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فيركبها عنادا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد، وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية". ([11]) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن الأدلة على عدم عذر الجاهل في الشـرك: قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 103، 104].
قال الطبري رحمه الله: "وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته؛ وذلك أن الله -تعالى ذكره- أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه، كانوا مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم: أنهم بالله كفرة، وأن أعمالهم حابطة". ([12]) انتهى كلامه رحمه الله.
طيب: إذا حكمنا على شخص ما بالكفر والشـرك، ما الذي يترتب على ذلك؟
يترتب على حكمنا على أحد بالكفر والشـرك ولو كان جاهلا: قطع الموالاة الإيمانية بيننا وبينه حتى يتوب إلى الله تعالى، وعدم التناكح معه أو أكل ذبيحته، وكذا عدم الاستغفار له إن مات على ذلك، وأنه لا حظ له من الحقوق التي أوجبها الله للمسلمين، وغير ذلك من الأحكام.
وأما تعذيبه في الدنيا والآخرة فهذا متوقف على قيام الحجة الرسالية، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، ودليله قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، وقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
ونؤكد على: أن من وقع في الشـرك من هذه الأمة فهو مشـرك كافر أيضا، وإن كان مدعيا للإسلام ناطقا بالشهادتين.
قال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65].
وقال تعالى بعد ذكره لأنبيائه عليهم السلام: {ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 88].
وهذه الآيات من أقوى الأدلة على أن الإسلام يحبط بالشـرك، وأن من أشرك من هذه الأمة فهو كافر، وإن كان ناطقا بالشهادتين عاملا بشعائر الإسلام الأخرى.
ونختم بمسألتين:
الأولى: لو كان إنسان قائما بأصل الدين يعبد الله ولا يشـرك به شيئا، ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يجهل مصطلح أصل الدين.
بمعنى أنك لو سألته: ما هو أصل الدين تلعثم أو لم يحر جوابا، فلا يضـره ذلك؛ لقيامه بأصل الدين، إذ لا يضـره عدم معرفة ما اصطُلح عليه في هذه المسائل والمعاني.
والدليل على ما ذكرنا: ما جاء في الصحيحين -واللفظ للبخاري-: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معاذ)، قلت: لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: (هل تدري ما حق الله على العباد)، قلت: لا، قال: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشـركوا به شيئا).
فتصـريح معاذ رضي الله عنه بأنه يجهل حق الله على عباده لم يوقعه في الكفر أو الشرك؛ لأنه قائم بهذا الحق وإن لم يعلم الاصطلاح الشرعي الذي يدل على ذلك المعنى.
المسألة الثانية: أن إحدى المسائل التي ذكرنا أنها من أصل الدين قد يخفى على بعض طلبة العلم أنها من أصل الدين، وهي مسألة عداوة المشـركين، وموالاة المؤمنين؛ فيظن أنها من واجبات الدين لا من أصله، أو يتوقف فيها، فهذا لا يعد ناقضا لأصل الدين طالما أنه حقق البراءة من المشـركين، والموالاة للمؤمنين.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: "بحسب المسلم أن يعلم: أن الله افترض عليه عداوة المشـركين وعدم موالاتهم، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، ونفى الإيمان عمن يواد {مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22]، وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها، فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، إنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه، ومن عرف أن ذلك من معناها، أو من لازمها فهو حسن، وزيادة خير، ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته، لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شـر واختلاف، ووقوع فرقة بين المؤمنين، الذين قاموا بواجبات الإيمان، وجاهدوا في الله، وعادوا المشـركين، ووالوا المسلمين". ([13]) انتهى كلامه رحمه الله.
ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يجعلنا هداة مهديين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[1])) مجموع الفتاوى (16/203).
[2])) منهاج السنة النبوية (5/255).
[3])) التبصير في معالم الدين (ص126-132).
[4])) مجموع الفتاوى (1/10).
[5])) مجموع الفتاوى (20/357).
[6])) مدارج السالكين (3/455).
[7])) الدرر السنية (8/359).
[8])) مجموع الفتاوى (15/438).
[9])) مدارج السالكين (1/253).
[10])) طريق الهجرتين (ص414).
[11])) تفسير الطبري (12/388).
[12])) تفسير الطبري (18/128).
[13])) الدرر السنية (8/166).
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 100
الخميس 15 محرم 1439 هـ ...المزيد
السلسلة العلمية المنهجية 2 (أصل الدين) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا ...
السلسلة العلمية المنهجية 2
(أصل الدين)
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
ففي هذه الحلقة سنتناول الحديث عن أصل الدين، وهو موضوع في غاية الأهمية؛ وذلك لأنه لا يصح إيمان أحد إلا إذا أتى به.
• فما هو أصل الدين؟
أصل الدين هو الإقرار بالله، وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه.
أربعة أمور ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإبراهيم وموسى قاما بأصل الدين؛ الذي هو الإقرار بالله، وعبادته وحده لا شـريك له، ومخاصمة من كفر بالله".([1]) انتهى كلامه.
"والبراءة ممن أشرك به سبحانه" هو ما عبَّر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بقوله: "ومخاصمة من كفر بالله"، فكلا العبارتين معناهما واحد: مخاصمة المشـركين والبراءة منهم.
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل الدين أن يكون الحب لله، والبغض لله، والموالاة لله، والمعاداة لله، والعبادة لله". ([2]) انتهى كلامه.
فنقول بناء على ما سبق: لو أن شخصا أتى بثلاثة أمور من أصل الدين ولم يأت بالرابع؛ كترك عبادة ما سوى الله تعالى، أو ترك البراءة ممن أشـرك به سبحانه، هل يصح إسلامه؟، الجواب: لا.
فماذا يسمى؟، يسمى مشـركا كافرا.
وهذا القدر الذي هو أصل الدين لا يعذر من لم يأت به أحد بلغ حد التكليف ولو كان جاهلا، سواء بلغته الحجة الرسالية أو لم تبلغه، أو بلفظ آخر سواء جاءه رسول أو لم يأته.
قال إمام المفسـرين ابن جرير الطبري رحمه الله بعد ذكره لشـيء من أصل الدين، قال: "لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف؛ كان ممَّن أتاه من الله تعالى رسول، أو لم يأته رسول، عاين من الخلق غيره، أو لم يعاين أحدا سوى نفسه".([3]) انتهى كلامه رحمه الله.
لم يعاين أحدا سوى نفسه؛ يعني لم ير إلا نفسه؛ كمن كان في جزيرة نائية ولم ير أحدا من الناس سوى نفسه.
نقول: فإذا جاءه رسول دخل في أصل الدين الإيمان به وبما جاء به على وجه الإجمال.
إذن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى الآن، وبما جاء به على وجه الإجمال يدخل في أصل الدين؛ لأن أصل الدين هو الشهادتان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أصل الدين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله". ([4]) انتهى كلامه رحمه الله.
• طيِّب ما معنى (الإقرار بالله)؟
يعني: الإيمان بوجوده تعالى، وأنه متصف بصفات الكمال، ومنزه عن النقائص والعيوب، وأنه سبحانه المتفرِّد بالخلق والأمر.
قال الله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]
والأمر منه ما هو كوني؛ أي أنه سبحانه يقول للشـيء كن فيكون، ومن الأمر ما هو شرعي؛ ويتمثل بتفرده سبحانه وتعالى بالتحليل والتحريم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله؛ فإن الله سبحانه في سورة الأنعام والأعراف عاب على المشـركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وأنهم شـرعوا من الدين ما لم يأذن به الله". ([5]) انتهى كلامه رحمه الله.
مرة ثانية: ما هو أصل الدين؟ هو الإقرار بالله، وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشـرك به سبحانه، شرحنا الإقرار بالله.
طيب، ما معنى: عبادته سبحانه وحده، وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه؟
معناه: توحيد الله، ومحبة التوحيد وتحسينه، وموالاة أهله، وتقبيح الشـرك، واجتنابه، ومخاصمة أهله.
قال ابن القيم رحمه الله: "واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشـرك معلوما بالعقل، مستقرا في الفطر، فلا وثوق بشـيء من قضايا العقل؛ فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات، وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر". ([6]) انتهى كلامه رحمه الله.
وموالاة أهله: هذا هو الولاء؛ موالاة المؤمنين ...، ومخاصمة أهله -يعني أهل الشـرك-: هذا هو البراء من المشركين ...
ومن هنا يتبيَّن أن الولاء والبراء يدخل في أصل الدين.
ولكن ههنا مسألة؛
وهي الفرق بين وجود العداوة للكافرين وبين إظهار العداوة، فالأول -وهو وجود العداوة- من أصل الدين، والثاني: وهو إظهار العداوة فمن واجبات الدين لا من أصله.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: "ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة؛ فالأول: يعذر به مع العجز والخوف، لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28]، والثاني: لا بد منه؛ لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب لله ورسوله تلازم كلي، لا ينفك عنه المؤمن". ([7]) انتهى كلامه.
أصل الدين كما قلنا: لا يُعذر بالجهل به أيُّ أحد؛ أي لا يصح إسلام من نقضه ولا يرتفع عنه اسم الكفر.
• لماذا لم يعتبر بجهل الرجل العاقل أو المرأة العاقلة في أصل الدين؟
لأنه مما علم وثبت بالميثاق وضرورة الفطرة والعقل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل الدين هو عبادة الله، الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواه، وهو الفطرة التي فطر عليها الناس". ([8]) انتهى كلامه.
وقال ابن القيم رحمه الله: "وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضـرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه". ([9]) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن هنا نعلم أن أصل الدين لا يشترط فيه إقامة الحجة للحكم بالكفر على من لم يأت به؛ أي نحكم على من لم يأت بأصل الدين بالكفر، سواء أقيمت عليه الحجة أم لم تقم.
ونؤكد على أنه لا عذر لأي أحد بالجهل في هذه المسائل، التي هي من أصل الدين؛ لأنها من العلوم الضرورية المستقرة في جميع الفطر والعقول، وبالتالي فمن انتقض أصل دينه فهو مشـرك، ولكن عذابه في الدنيا والآخرة متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من معرفتها؛ فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل". ([10]) انتهى كلامه رحمه الله.
سؤال: ما الذي يناقض أصل الدين؟
الجواب: الشـرك ...
حيث قلنا في تعريف أصل الدين: أنه الإقرار بالله وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه، إذن: الشرك بـالله يناقض أصل الدين وينافيه.
ومعنى الشـرك شـرعا: هو جعل الشـريك أو الند لله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته.
فمثال شـرك الربوبية: أن يجعل مع الله خالق أو رازق أو مدبر أو حاكم أو مشـرع.
ومثال الشـرك في الألوهية: السجود أوالدعاء أوالنذر أوالذبح لغير الله.
ومثال الشـرك في الأسماء والصفات: تعطيلها مثل نفي العلم والسمع والبصـر عن الله، أو تشبيهه سبحانه وتعالى بخلقه.
وكل هذا الشـرك لم يعذر فيه أحد من المشـركين بجهله؛ لأنه يناقض أصل الدين، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكم بكفر الأتباع والمقلدين، وحكم بكفر الأميين من أهل الكتاب مع جهلهم، وحكم بكفر جهلة مشـركي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "من مات مشـركا فهو في النار، وإن مات قبل البعثة؛ لأن المشـركين كانوا قد غيَّروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشـرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشـركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضـى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشـرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم". انتهى كلامه رحمه الله.
وأما الجهلة من المشـركين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من المنتسبين للإسلام وغيرهم فالأمر فيهم أشد؛ لأن غالب جهلهم جاء من جهة الإعراض عن رسالته صلى الله عليه وسلم، والإعراض بمجرده كفر، فكيف لو كان معه شـرك؟!
قال الشوكاني رحمه الله: "ومن وقع في الشرك جاهلا لم يعذر، لأن الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جهل فقد أتي من قبل نفسه؛ بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة، وإلا ففيهما البيان الواضح؛ كما قال سبحانه في القرآن: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً} [النحل: 89]، وكذلك السنة: قال أبو ذر رضي الله عنه: " توفي محمد صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه بين السماء والأرض إلا ذكر لنا منه علما"، أو كما قال رضي الله عنه؛ فمن جهل فبسبب إعراضه، ولا يعذر أحد بالإعراض". انتهى كلامه رحمه الله.
هذا وأدلة عدم عذر الجاهل في الشـرك والذي يناقض أصل الدين كثيرة.
منها قوله تعالى: {فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأعراف: 30].
قال الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة، إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة، باتخاذهم الشياطين نصـراء من دون الله وظهراء؛ جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق، وأن الصواب ما أتوه وركبوا.
وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فيركبها عنادا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد، وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية". ([11]) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن الأدلة على عدم عذر الجاهل في الشـرك: قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 103، 104].
قال الطبري رحمه الله: "وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته؛ وذلك أن الله -تعالى ذكره- أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه، كانوا مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم: أنهم بالله كفرة، وأن أعمالهم حابطة". ([12]) انتهى كلامه رحمه الله.
طيب: إذا حكمنا على شخص ما بالكفر والشـرك، ما الذي يترتب على ذلك؟
يترتب على حكمنا على أحد بالكفر والشـرك ولو كان جاهلا: قطع الموالاة الإيمانية بيننا وبينه حتى يتوب إلى الله تعالى، وعدم التناكح معه أو أكل ذبيحته، وكذا عدم الاستغفار له إن مات على ذلك، وأنه لا حظ له من الحقوق التي أوجبها الله للمسلمين، وغير ذلك من الأحكام.
وأما تعذيبه في الدنيا والآخرة فهذا متوقف على قيام الحجة الرسالية، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، ودليله قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، وقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
ونؤكد على: أن من وقع في الشـرك من هذه الأمة فهو مشـرك كافر أيضا، وإن كان مدعيا للإسلام ناطقا بالشهادتين.
قال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65].
وقال تعالى بعد ذكره لأنبيائه عليهم السلام: {ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 88].
وهذه الآيات من أقوى الأدلة على أن الإسلام يحبط بالشـرك، وأن من أشرك من هذه الأمة فهو كافر، وإن كان ناطقا بالشهادتين عاملا بشعائر الإسلام الأخرى.
ونختم بمسألتين:
الأولى: لو كان إنسان قائما بأصل الدين يعبد الله ولا يشـرك به شيئا، ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يجهل مصطلح أصل الدين.
بمعنى أنك لو سألته: ما هو أصل الدين تلعثم أو لم يحر جوابا، فلا يضـره ذلك؛ لقيامه بأصل الدين، إذ لا يضـره عدم معرفة ما اصطُلح عليه في هذه المسائل والمعاني.
والدليل على ما ذكرنا: ما جاء في الصحيحين -واللفظ للبخاري-: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معاذ)، قلت: لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: (هل تدري ما حق الله على العباد)، قلت: لا، قال: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشـركوا به شيئا).
فتصـريح معاذ رضي الله عنه بأنه يجهل حق الله على عباده لم يوقعه في الكفر أو الشرك؛ لأنه قائم بهذا الحق وإن لم يعلم الاصطلاح الشرعي الذي يدل على ذلك المعنى.
المسألة الثانية: أن إحدى المسائل التي ذكرنا أنها من أصل الدين قد يخفى على بعض طلبة العلم أنها من أصل الدين، وهي مسألة عداوة المشـركين، وموالاة المؤمنين؛ فيظن أنها من واجبات الدين لا من أصله، أو يتوقف فيها، فهذا لا يعد ناقضا لأصل الدين طالما أنه حقق البراءة من المشـركين، والموالاة للمؤمنين.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: "بحسب المسلم أن يعلم: أن الله افترض عليه عداوة المشـركين وعدم موالاتهم، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، ونفى الإيمان عمن يواد {مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22]، وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها، فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، إنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه، ومن عرف أن ذلك من معناها، أو من لازمها فهو حسن، وزيادة خير، ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته، لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شـر واختلاف، ووقوع فرقة بين المؤمنين، الذين قاموا بواجبات الإيمان، وجاهدوا في الله، وعادوا المشـركين، ووالوا المسلمين". ([13]) انتهى كلامه رحمه الله.
ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يجعلنا هداة مهديين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[1])) مجموع الفتاوى (16/203).
[2])) منهاج السنة النبوية (5/255).
[3])) التبصير في معالم الدين (ص126-132).
[4])) مجموع الفتاوى (1/10).
[5])) مجموع الفتاوى (20/357).
[6])) مدارج السالكين (3/455).
[7])) الدرر السنية (8/359).
[8])) مجموع الفتاوى (15/438).
[9])) مدارج السالكين (1/253).
[10])) طريق الهجرتين (ص414).
[11])) تفسير الطبري (12/388).
[12])) تفسير الطبري (18/128).
[13])) الدرر السنية (8/166).
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 100
الخميس 15 محرم 1439 هـ ...المزيد
(أصل الدين)
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، أما بعد:
ففي هذه الحلقة سنتناول الحديث عن أصل الدين، وهو موضوع في غاية الأهمية؛ وذلك لأنه لا يصح إيمان أحد إلا إذا أتى به.
• فما هو أصل الدين؟
أصل الدين هو الإقرار بالله، وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه.
أربعة أمور ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإبراهيم وموسى قاما بأصل الدين؛ الذي هو الإقرار بالله، وعبادته وحده لا شـريك له، ومخاصمة من كفر بالله".([1]) انتهى كلامه.
"والبراءة ممن أشرك به سبحانه" هو ما عبَّر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بقوله: "ومخاصمة من كفر بالله"، فكلا العبارتين معناهما واحد: مخاصمة المشـركين والبراءة منهم.
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل الدين أن يكون الحب لله، والبغض لله، والموالاة لله، والمعاداة لله، والعبادة لله". ([2]) انتهى كلامه.
فنقول بناء على ما سبق: لو أن شخصا أتى بثلاثة أمور من أصل الدين ولم يأت بالرابع؛ كترك عبادة ما سوى الله تعالى، أو ترك البراءة ممن أشـرك به سبحانه، هل يصح إسلامه؟، الجواب: لا.
فماذا يسمى؟، يسمى مشـركا كافرا.
وهذا القدر الذي هو أصل الدين لا يعذر من لم يأت به أحد بلغ حد التكليف ولو كان جاهلا، سواء بلغته الحجة الرسالية أو لم تبلغه، أو بلفظ آخر سواء جاءه رسول أو لم يأته.
قال إمام المفسـرين ابن جرير الطبري رحمه الله بعد ذكره لشـيء من أصل الدين، قال: "لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف؛ كان ممَّن أتاه من الله تعالى رسول، أو لم يأته رسول، عاين من الخلق غيره، أو لم يعاين أحدا سوى نفسه".([3]) انتهى كلامه رحمه الله.
لم يعاين أحدا سوى نفسه؛ يعني لم ير إلا نفسه؛ كمن كان في جزيرة نائية ولم ير أحدا من الناس سوى نفسه.
نقول: فإذا جاءه رسول دخل في أصل الدين الإيمان به وبما جاء به على وجه الإجمال.
إذن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى الآن، وبما جاء به على وجه الإجمال يدخل في أصل الدين؛ لأن أصل الدين هو الشهادتان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أصل الدين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله". ([4]) انتهى كلامه رحمه الله.
• طيِّب ما معنى (الإقرار بالله)؟
يعني: الإيمان بوجوده تعالى، وأنه متصف بصفات الكمال، ومنزه عن النقائص والعيوب، وأنه سبحانه المتفرِّد بالخلق والأمر.
قال الله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]
والأمر منه ما هو كوني؛ أي أنه سبحانه يقول للشـيء كن فيكون، ومن الأمر ما هو شرعي؛ ويتمثل بتفرده سبحانه وتعالى بالتحليل والتحريم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله؛ فإن الله سبحانه في سورة الأنعام والأعراف عاب على المشـركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وأنهم شـرعوا من الدين ما لم يأذن به الله". ([5]) انتهى كلامه رحمه الله.
مرة ثانية: ما هو أصل الدين؟ هو الإقرار بالله، وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشـرك به سبحانه، شرحنا الإقرار بالله.
طيب، ما معنى: عبادته سبحانه وحده، وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه؟
معناه: توحيد الله، ومحبة التوحيد وتحسينه، وموالاة أهله، وتقبيح الشـرك، واجتنابه، ومخاصمة أهله.
قال ابن القيم رحمه الله: "واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشـرك معلوما بالعقل، مستقرا في الفطر، فلا وثوق بشـيء من قضايا العقل؛ فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات، وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر". ([6]) انتهى كلامه رحمه الله.
وموالاة أهله: هذا هو الولاء؛ موالاة المؤمنين ...، ومخاصمة أهله -يعني أهل الشـرك-: هذا هو البراء من المشركين ...
ومن هنا يتبيَّن أن الولاء والبراء يدخل في أصل الدين.
ولكن ههنا مسألة؛
وهي الفرق بين وجود العداوة للكافرين وبين إظهار العداوة، فالأول -وهو وجود العداوة- من أصل الدين، والثاني: وهو إظهار العداوة فمن واجبات الدين لا من أصله.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: "ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة؛ فالأول: يعذر به مع العجز والخوف، لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28]، والثاني: لا بد منه؛ لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب لله ورسوله تلازم كلي، لا ينفك عنه المؤمن". ([7]) انتهى كلامه.
أصل الدين كما قلنا: لا يُعذر بالجهل به أيُّ أحد؛ أي لا يصح إسلام من نقضه ولا يرتفع عنه اسم الكفر.
• لماذا لم يعتبر بجهل الرجل العاقل أو المرأة العاقلة في أصل الدين؟
لأنه مما علم وثبت بالميثاق وضرورة الفطرة والعقل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل الدين هو عبادة الله، الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواه، وهو الفطرة التي فطر عليها الناس". ([8]) انتهى كلامه.
وقال ابن القيم رحمه الله: "وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضـرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه". ([9]) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن هنا نعلم أن أصل الدين لا يشترط فيه إقامة الحجة للحكم بالكفر على من لم يأت به؛ أي نحكم على من لم يأت بأصل الدين بالكفر، سواء أقيمت عليه الحجة أم لم تقم.
ونؤكد على أنه لا عذر لأي أحد بالجهل في هذه المسائل، التي هي من أصل الدين؛ لأنها من العلوم الضرورية المستقرة في جميع الفطر والعقول، وبالتالي فمن انتقض أصل دينه فهو مشـرك، ولكن عذابه في الدنيا والآخرة متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من معرفتها؛ فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل". ([10]) انتهى كلامه رحمه الله.
سؤال: ما الذي يناقض أصل الدين؟
الجواب: الشـرك ...
حيث قلنا في تعريف أصل الدين: أنه الإقرار بالله وعبادته سبحانه وحده وترك عبادة ما سواه، والبراءة ممن أشرك به سبحانه، إذن: الشرك بـالله يناقض أصل الدين وينافيه.
ومعنى الشـرك شـرعا: هو جعل الشـريك أو الند لله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته.
فمثال شـرك الربوبية: أن يجعل مع الله خالق أو رازق أو مدبر أو حاكم أو مشـرع.
ومثال الشـرك في الألوهية: السجود أوالدعاء أوالنذر أوالذبح لغير الله.
ومثال الشـرك في الأسماء والصفات: تعطيلها مثل نفي العلم والسمع والبصـر عن الله، أو تشبيهه سبحانه وتعالى بخلقه.
وكل هذا الشـرك لم يعذر فيه أحد من المشـركين بجهله؛ لأنه يناقض أصل الدين، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكم بكفر الأتباع والمقلدين، وحكم بكفر الأميين من أهل الكتاب مع جهلهم، وحكم بكفر جهلة مشـركي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "من مات مشـركا فهو في النار، وإن مات قبل البعثة؛ لأن المشـركين كانوا قد غيَّروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشـرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشـركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضـى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشـرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم". انتهى كلامه رحمه الله.
وأما الجهلة من المشـركين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من المنتسبين للإسلام وغيرهم فالأمر فيهم أشد؛ لأن غالب جهلهم جاء من جهة الإعراض عن رسالته صلى الله عليه وسلم، والإعراض بمجرده كفر، فكيف لو كان معه شـرك؟!
قال الشوكاني رحمه الله: "ومن وقع في الشرك جاهلا لم يعذر، لأن الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جهل فقد أتي من قبل نفسه؛ بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة، وإلا ففيهما البيان الواضح؛ كما قال سبحانه في القرآن: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً} [النحل: 89]، وكذلك السنة: قال أبو ذر رضي الله عنه: " توفي محمد صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه بين السماء والأرض إلا ذكر لنا منه علما"، أو كما قال رضي الله عنه؛ فمن جهل فبسبب إعراضه، ولا يعذر أحد بالإعراض". انتهى كلامه رحمه الله.
هذا وأدلة عدم عذر الجاهل في الشـرك والذي يناقض أصل الدين كثيرة.
منها قوله تعالى: {فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأعراف: 30].
قال الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة، إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة، باتخاذهم الشياطين نصـراء من دون الله وظهراء؛ جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق، وأن الصواب ما أتوه وركبوا.
وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فيركبها عنادا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد، وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية". ([11]) انتهى كلامه رحمه الله.
ومن الأدلة على عدم عذر الجاهل في الشـرك: قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 103، 104].
قال الطبري رحمه الله: "وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته؛ وذلك أن الله -تعالى ذكره- أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه، كانوا مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم: أنهم بالله كفرة، وأن أعمالهم حابطة". ([12]) انتهى كلامه رحمه الله.
طيب: إذا حكمنا على شخص ما بالكفر والشـرك، ما الذي يترتب على ذلك؟
يترتب على حكمنا على أحد بالكفر والشـرك ولو كان جاهلا: قطع الموالاة الإيمانية بيننا وبينه حتى يتوب إلى الله تعالى، وعدم التناكح معه أو أكل ذبيحته، وكذا عدم الاستغفار له إن مات على ذلك، وأنه لا حظ له من الحقوق التي أوجبها الله للمسلمين، وغير ذلك من الأحكام.
وأما تعذيبه في الدنيا والآخرة فهذا متوقف على قيام الحجة الرسالية، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، ودليله قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، وقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
ونؤكد على: أن من وقع في الشـرك من هذه الأمة فهو مشـرك كافر أيضا، وإن كان مدعيا للإسلام ناطقا بالشهادتين.
قال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65].
وقال تعالى بعد ذكره لأنبيائه عليهم السلام: {ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 88].
وهذه الآيات من أقوى الأدلة على أن الإسلام يحبط بالشـرك، وأن من أشرك من هذه الأمة فهو كافر، وإن كان ناطقا بالشهادتين عاملا بشعائر الإسلام الأخرى.
ونختم بمسألتين:
الأولى: لو كان إنسان قائما بأصل الدين يعبد الله ولا يشـرك به شيئا، ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يجهل مصطلح أصل الدين.
بمعنى أنك لو سألته: ما هو أصل الدين تلعثم أو لم يحر جوابا، فلا يضـره ذلك؛ لقيامه بأصل الدين، إذ لا يضـره عدم معرفة ما اصطُلح عليه في هذه المسائل والمعاني.
والدليل على ما ذكرنا: ما جاء في الصحيحين -واللفظ للبخاري-: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معاذ)، قلت: لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: (هل تدري ما حق الله على العباد)، قلت: لا، قال: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشـركوا به شيئا).
فتصـريح معاذ رضي الله عنه بأنه يجهل حق الله على عباده لم يوقعه في الكفر أو الشرك؛ لأنه قائم بهذا الحق وإن لم يعلم الاصطلاح الشرعي الذي يدل على ذلك المعنى.
المسألة الثانية: أن إحدى المسائل التي ذكرنا أنها من أصل الدين قد يخفى على بعض طلبة العلم أنها من أصل الدين، وهي مسألة عداوة المشـركين، وموالاة المؤمنين؛ فيظن أنها من واجبات الدين لا من أصله، أو يتوقف فيها، فهذا لا يعد ناقضا لأصل الدين طالما أنه حقق البراءة من المشـركين، والموالاة للمؤمنين.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: "بحسب المسلم أن يعلم: أن الله افترض عليه عداوة المشـركين وعدم موالاتهم، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، ونفى الإيمان عمن يواد {مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22]، وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها، فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، إنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه، ومن عرف أن ذلك من معناها، أو من لازمها فهو حسن، وزيادة خير، ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته، لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شـر واختلاف، ووقوع فرقة بين المؤمنين، الذين قاموا بواجبات الإيمان، وجاهدوا في الله، وعادوا المشـركين، ووالوا المسلمين". ([13]) انتهى كلامه رحمه الله.
ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يجعلنا هداة مهديين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[1])) مجموع الفتاوى (16/203).
[2])) منهاج السنة النبوية (5/255).
[3])) التبصير في معالم الدين (ص126-132).
[4])) مجموع الفتاوى (1/10).
[5])) مجموع الفتاوى (20/357).
[6])) مدارج السالكين (3/455).
[7])) الدرر السنية (8/359).
[8])) مجموع الفتاوى (15/438).
[9])) مدارج السالكين (1/253).
[10])) طريق الهجرتين (ص414).
[11])) تفسير الطبري (12/388).
[12])) تفسير الطبري (18/128).
[13])) الدرر السنية (8/166).
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 100
الخميس 15 محرم 1439 هـ ...المزيد
صحيح القصص النبوي
فهذا كتاب جامع لأكثر قصص الحديث النبوي الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ... المزيد
شخصيات قد تهتم بمتابَعتها
-
عائض بن عبد الله القرني
المشاهدات 2,429,810 -
محمد إسماعيل المقدم
المشاهدات 2,236,402 -
سعد بن سعيد الغامدي
المشاهدات 831,325 -
صلاح باعثمان
المشاهدات 11,928